قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :
مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمما معنى الجزاء؟

لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات من تكاليف اجتماعية على أجزائه أن يحترموها فلا همّ للمجتمع إلّا أن يوافق بين أعمال الأفراد ويقرب بعضها من بعض، ويربط جانبًا منها بجانب حتى تأتلف وتجتمع وترفع بآثارها ونتائجها حوائج الأفراد بمقدار ما يستحقه كل واحد بعمله وسعيه.
وهذه التكاليف لما كانت متعلقة بأمور اختيارية يسع الإنسان أخذها وتركها، وهي بعينها لا تتم إلّا مع سلب ما لحرية الإنسان في إرادته وعمله لم يمتنع أن يتخلف عنها أو عن بعضها الإنسان المتمايل بطبعه إلى الاسترسال وإطلاق الحرية.
والتنبّه إلى هذا النقص في التكاليف والفتور في بنى القوانين هو الذي بعث الإنسان الاجتماعي على أن يتمم نقصها ويحكم فتورها بأمر آخر، وهو أن يضم إلى مخالفتها والتخلف عنها أمورًا يكرهها الإنسان المكلف فيدعوه ذلك إلى طاعة التكليف الذي يكلف به حذرًا من أن يحل به ما يكرهه ويتضرر به.
وهذا هو جزاء السيئة، وهو حق للمجتمع أو لولي الأمر على المتخلف العاصي، وله نظير في جانب طاعة التكاليف فمن الممكن أن يوضع للمطيع الممتثل بإزاء عمله بالتكليف أمر يؤثره ويحبه ليكون ذلك داعيًا يدعوه إلى إتيان الواجب أو المطلوب مطلقًا من التكاليف، وهو حق للمكلف المطيع على المجتمع أو لولي الأمر، وهذا هو جزاء الحسنة، وربما يسمى جزاء السيئة عقابًا وجزاء الحسنة ثوابًا.
وعلى هذه الوتيرة يجري حكم الشريعة الإلهية؛ قال تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى) «1» وقال تعالى: (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها) «2» وقال: (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) «3».
وللعقاب والثواب عرض عريض آخذًا من الاستكراه والاستحسان والذم والمدح إلى آخر ما يتعلق به القدرة من الشر والخير، ويرتبطان في ذلك بعوامل مختلفة من خصوصيات الفعل والفاعل وولي التكليف ومقدار الضرر والنفع العائدين إلى المجتمع ولعله يجمع الجميع أن العمل كلما زاد الاهتمام بأمره زاد عقابًا في صورة المعصية وثوابًا في صورة الطاعة.
ويعتبر بين العمل وبين جزائه - كيف كان - نوع من المماثلة والمسانخة ولو تقريبًا، وعلى ذلك يجري كلامه تعالى أيضًا كما هو ظاهر أمثال قوله تعالى: (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى) «4» وأوضح منه قوله تعالى وقد حكاه عن صحف إبراهيم وموسى عليه السّلام: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى * ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى) «5».
وهذا فيما شرعه اللّه في أمر القصاص أظهر، قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) «6» وقال: (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ) «7».
ولازم هذه المماثلة والمسانخة أن يعود العقاب أو الثواب إلى نفس العامل بمثل ما عمل بمعنى أنه إذا عصى حكمًا اجتماعيًّا مثلاً فإنما تمتع لنفسه بما يضرّ المجتمع أي بما يفسد تمتعًا من تمتعات المجتمع فينقص من تمتعاته في نفسه ما يعادل ذلك من نفسه أو بدنه أو ماله أو جاهه أو نحو ذلك مما يعود بوجه إليه.
وهذا هو الذي المعني في البحث عن معنى الاستعباد أن المجتمع أو من يلي أمره يملك من المجرم نفسه أو شأنًا من شؤون نفسه يعادل الجرم الذي اجترمه ونقيصة الضرر الذي أوقعه على المجتمع فيعاقب بذلك أي يتصرف المجتمع أو ولي الأمر استنادًا إلى هذا الملك - وهو الحق - في حياة المجرم أو شأن من شؤون حياته، ويسلب حريته في ذلك.
فلو قتل نفسًا مثلاً بغير نفس أو فساد في الأرض في المجتمع الإسلامي ملك ولي الأمر من المجرم نفسه حيث نقصهم نفسًا محترمة، وحدّه الذي هو القتل تصرف في نفسه عن الملك الذي ملكه، ولو سرق ما يبلغ ربع دينار من حرز فقد أضر بالمجتمع بهتك ستر من أستار الأمن العام الذي أسدلته يد الشريعة وحفظته يد الأمانة، وحدّها الذي هو القطع ليس حقيقته إلّا أن ولي الأمر ملك من السارق بإزاء ما أتى به شأنًا من شؤون حياته وهو الشأن الذي تشتمل عليه اليد فيتصرف فيه بسلب ما له من الحرية ووسيلتها من هذه الجهة، وقس على ذلك أنواع الجزاء في الشرائع والسنن المختلفة.
فيتبين من هنا أن الإجرام والمعصية الاجتماعية يستجلب نوعًا من الرق والعبودية، ولذلك كان العبد أظهر مصاديق المؤاخذة والعقاب قال تعالى: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ) «8».
ولهذا المعنى مظاهر متفرقة في سائر الشرائع والسنن المختلفة قال اللّه تعالى في قصة يوسف عليه السّلام إذ جعل السقاية في رحل أخيه ليأخذه إليه: (قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ * قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ * فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ * قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ * قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ) «9».
وربما كان يؤخذ القاتل أسيرًا مملوكًا، وربما كان يفدي بواحدة من نسائه وحرمه كبنته وأخته إلى غير ذلك، وسنّة الفدية بالتزويج كانت مرسومة إلى هذه الأيام بين القبائل والعشائر في نواحينا لأن الازدواج يعد عندهم نوعًا من الاستقرار والإسارة للنساء.
ومن هنا ما ربما يعد المطيع عبدا للمطاع لأنه بإطاعته يتبع إرادته إرادة المطاع فهو مملوكه المحروم من حرية الإرادة قال تعالى: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي) «10» وقال: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) «11».
وبالعكس من تملك المجتمع أو ولي الأمر المجرم المعاقب يملك المطيع المثاب من المجتمع أو ولي الأمر ما يوازن طاعته من الثواب فإن المجتمع أو الولي نقص من المكلف المطيع بواسطة التكليف شيئًا من حريته الموهوبة فعليه أن يتممه كما نقص.
وهذا هو السر في ما اشتهر: أن الوفاء بالوعد واجب دون الوعيد؛ وذلك أن مضمون الوعد في ظرف المولوية والعبودية هو الثواب على الطاعة كما أن مضمون الوعيد هو العقاب على المعصية، والثواب لما كان من حق المطيع على ولي الأمر وفي ذمته وجب عليه تأديته وتفريغ ذمته منه بخلاف العقاب فإنه من حق ولي الأمر على المكلف المجرم، وليس من الواجب أن يتصرف الإنسان في ملكه ويستفيد من حقه إن كان له ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة يونس: 26.
(2) سورة يونس: 27.
(3) سورة الشورى: 40.
(4) سورة النجم: 31.
(5) سورة النجم: 41.
(6) سورة البقرة: 178.
(7) سورة البقرة: 194.
(8) سورة المائدة: 118.
(9) سورة يوسف: 79.
(10) سورة يس: 61.
(11) سورة الجاثية: 23.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 النظام الاقتصادي في الإسلام (3)
النظام الاقتصادي في الإسلام (3)
الشهيد مرتضى مطهري
-
 مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا
مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)
حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)
الشيخ محمد صنقور
-
 معنى (نعق) في القرآن الكريم
معنى (نعق) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 بحثًا عن أنصار المهدي (عج)
بحثًا عن أنصار المهدي (عج)
السيد عباس نور الدين
-
 شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)
شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
الفيض الكاشاني
-
 في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)
في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)
محمود حيدر
-
 صبغة الخلود
صبغة الخلود
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ
تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ
عدنان الحاجي
الشعراء
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد
علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد
حسين حسن آل جامع
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
آخر المواضيع
-

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)
-
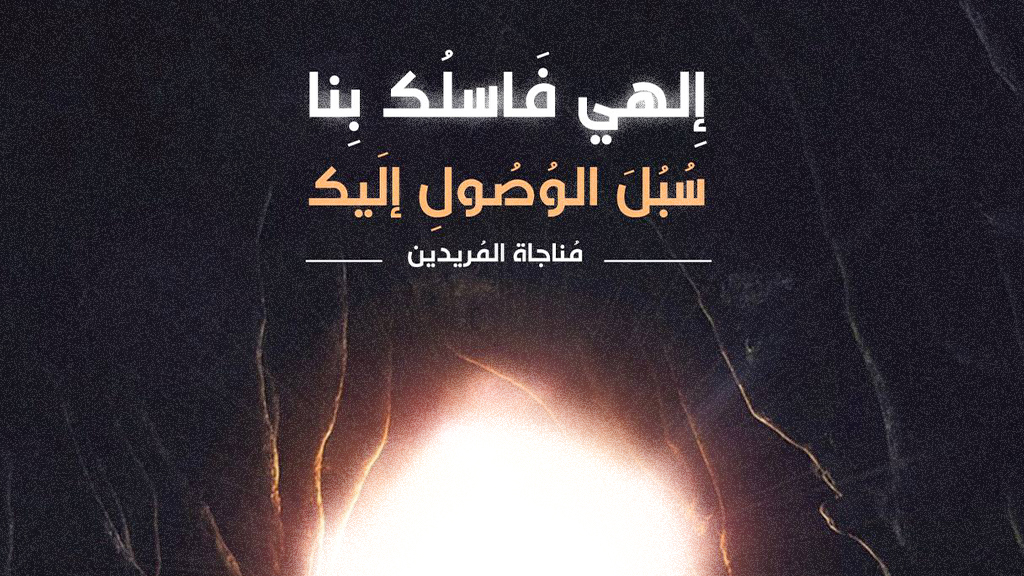
مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا
-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)
-

يا جمعه تظهر سيدي
-
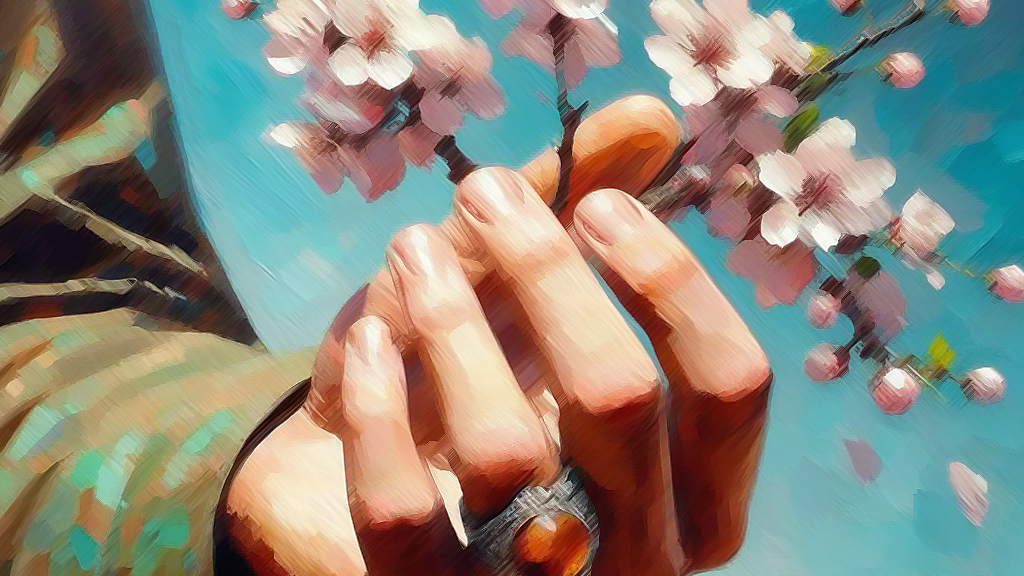
شربة من كوز اليقين
-

جمعيّة سيهات في ضيافة البيت السّعيد
-

(الأنماط الشّخصيّة وأثرها على بيئة العمل) محاضرة لآل عبّاس في جمعيّة أمّ الحمام الخيريّة
-

(شذرات من أدب الرّحلات) محاضرة لنادي قوافي الأدبيّ قدّمها الشّاعر زكي السّالم
-

الإيمان بالمهدي (عج) في زمن التّشكيك
-
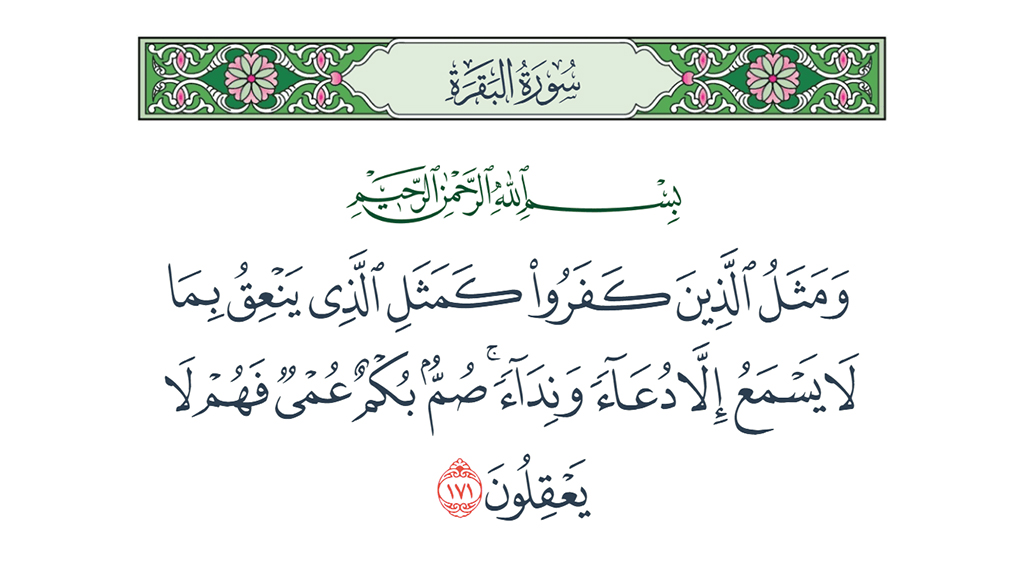
معنى (نعق) في القرآن الكريم










