مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :
خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.وتطمئن قلوبهم (فلسفة الذكر)

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾[1]. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾[2].
أمران هنا يرتبطان ببعض: الإيمان ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾، والاطمئنان القلبي ﴿بِذِكْرِ اللهِ﴾؛ والسبب أن ذكر الله فاعل بذاته لاطمئنان القلوب. هل النص هنا حدثنا عن أحداث الذكر للاطمئنان عند كل قلب مهما كان، وهذا ما يبدو ظاهر الأمر؟ أم أن مجيئه بعد أن أورد أن الذين آمنوا تطمئن قلوبهم؟ في تقدير أولي يمكن القول: إن الذكر مطمئن للقلوب، وأن الإيمان إذا ما تفاعل مع الذكر وبعمق هذا الإيمان حصل الاطمئنان المنشود.
وإلا فلطالما حصل الذكر عند ذاكر ما، وبقي في فراغ المعنى عند منطقة التقوّل أو الاستماع ولم يخرق القلوب. فاللّفظ ما لم يصدر بوجهه المعنائي المقصود، وما لم يتأدّب بالأدب القلبي اللازم لن يُحصِّل تلك المرتبة العظيمة؛ وهي القلوب المطمئنة.
الآية تفيد صورة وصول وتحصّل معنوي كبير هو غاية عند أهل السعي نحو الكمالات (القلب المطمئن). أما ما يقوم به بعض الناس من أنهم عند القلق أو الخوف أو الحزن، أو الاضطرابات العصبية يقرؤون القرآن مثلًا، وفجأة لا يحصلون على نتيجة ويستنكرون! قرأنا القرآن ولم نشعر بشيء. تعاملهم هذا مع الذكر والقرآن تعامل الرقية، وليس تعامل بناء وإشادة القلب الذي بالذكر يحصل الاطمئنان.
إنه الإيمان بما يعنيه من إقرار وقناعة وتسليم، بما يعنيه من جعل القلب مفتوحًا على طلب القرب من الله والعمل عليه، ومن السّبُل الهادية له لمثل هذا التخلّق القلبي؛ الذكر. ومن الذكر قد نتعلّم الكثير، لكن الأصل في الذكر أن نعيش المعنى، أن نتذوقه، أن نحس به. وهذا الحضور في عيش الذكر هو الذي يروِّض ويبني القلب على الطمأنينة، ولو لم يكن في الذكر مثل هذا التأثير لما وصل القلب المؤمن إلى درجة الاطمئنان. فللذكر أثر أكيد على اطمئنان القلوب، لكن أي قلوب؟ هي هذه التي تتأثر بالذكر فترتقي لتصبح قلوبًا مطمئنة.
﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ﴾[3]. الميزة الأولى التي لا بدّ منها هي بناء علاقة ثابتة دائمة بين الذكر والذاكر، بحيث إنهما يتصاحبان على كل حال، وفي شتى الظروف، ولا ننسى هنا أن الذكر هو الحضور في محضر المذكور دومًا.
والحضور عند المحضر إن لم يكن فيه الانصراف إليه والذهول عم سواه يُعدُّ عيبًا. فكلما صار الذكر بابًا لانفساح الحجاب عن وجه المذكور عند الذاكر اشتغل قلب الذاكر بأنوار الألطاف.
والواضح من الآية القرآنية أن هذا غير كافٍ للرفعة، بل لا بدّ مع الذكر من التفكّر؛ لأن الذكر يضع صاحبه أمام الحقائق وجهًا لوجه، يأنس بها ويتروحن، لكنه يكاد أن لا يتميزها فيصيبه نحو من الحيرة يحتاج معها إلى تفكّر يفسّر ما أسفر عنه الذكر من وجوه، ويتابع ذلك في تجلّيات السموات والأرض، وفي أفعال الله ليراها كما لا يراها غيره. وبين الذكر والفكر يولد القلب من جديد، ولادة اطمئنان ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ﴾[4]. وكلما ازداد في الذكر توغلًا خاصة منه الكلام الإلهي زاد ثباتًا، وكلما زاوجه بالتفكر زاد اطمئنانًا.
هل هذا يعني أن لا أثر للذكر والقرآن عند غير من يذهب عميقًا في عيشه وتدبّره؟ هل هذا يعني أن الضعاف من الناس لا تنالهم ثمار الذكر من الطمأنينة؟
أبدًا… ليس هذا ما عنيته، بل ما أود الإشارة إليه أن التعامل مع الذكر، أو مع القرآن الكريم، على طريقة التمائم أو حبة دواء مهدئ للاضطراب هو المقاربة أو الفهم الخاطئ لكيفية الاطمئنان الحاصلة من الذكر والقرآن.
ما يمرّ مع بعض الناس صحيح أنه يعبّر عن نحو من اللجوء إلى الله سبحانه، لكنه لجوء نفعي مبتور سطحي ولا يأخذ بعين الاعتبار أدب العلاقة مع الله. لذا، غالبًا لن يصلوا لما يتوخون، وإلا ما من أحد إلا ولديه كل القابلية لقلب ووعي يضج بمحبة الله وذكره. لديه القابلية السليمة من حيث الأصل ليكون من أهل القلوب، إلا أنه يحتاج لصدق الذكر والتفكر، وعلى المستوى الذي يجده متوفرًا لديه.
فأهل الاطمئنان القلبي لا يُشترط أن يكونوا أهل فلسفة، وعرفان فلسفي، كما لا يشترط أن يكونوا من المتوغلين في معرفة الله. يكفيهم صدق عهدهم مع الله سبحانه، وصدق صبرهم على الحياة في سبيل تحقيق رضاه ليتميزوا عنده، وليلحظهم سبحانه برحماته، وهو الذي يكفل صدقهم. وهو الذي يعلمهم “من عمل بما علم، علمه الله ما لم يعلم”.[5] فيثبتهم ويلقي السكينة في نفوسهم وطمأنينة القلوب. وهذا الأمر يمكن أن نلحظه بشكل واضح في الشدائد وعند الملمّات. نراه مثلًا عند المجاهدين الذين يقعون على الموت ببيع أنفسهم لله سبحانه. كيف يتعاملون بطمأنينة؟ نراه عند أُسر الشهداء حينما يحتسبون ويسلمون برزيتهم تقرّبًا إلى الله سبحانه، كيف تتبدل أحوالهم، ويصبحون من أهل القلوب المفعمة بالصبر والطمأنينة. ثم يتقدم أهل الإيمان بالذكر بعد تحصيلهم الطمأنينة القلبية خطوة فاعلة للأمام؛ إذ يحولون طاقتهم الإيجابية إلى طاقة محرّكة، وإذ يرسمون لفعلهم وسلوكهم سبيل العمل الصالح بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، العمل الصالح وليد أمور ثلاث:
- وليد الهداية الإلهية.
- وليد مقتضيات الأمور الحياتية واليومية وما تستوجبه.
- وهنا الميزة الخاصة، وليد القلب؛ أي إنه عمل نابع وصادر عن محبة وصدق ونقاء نفس، بحيث تتوفر فيه كل عناصر الصلاح.
وبهذا، يحصل تفاعل بين القلب الذي يولّد رغبة العمل، وبين العمل الصالح وما ينعكس على القلب من صلاح، بحيث يصبحون، أهل الإيمان والعمل الصالح، مورد فلاح إلهي ﴿طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾[6].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سورة الرعد، الآية 28.
[2] سورة الرعد، الآية 29.
[3] سورة آل عمران، الآية 191.
[4] سورة آل عمران، الآية 191.
[5] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، الجزء 75، الصفحة 189.
[6] سورة الرعد، الآية 29.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 الفرج سيأتي وإن طال
الفرج سيأتي وإن طال
عبدالعزيز آل زايد
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
الشهيد مرتضى مطهري
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
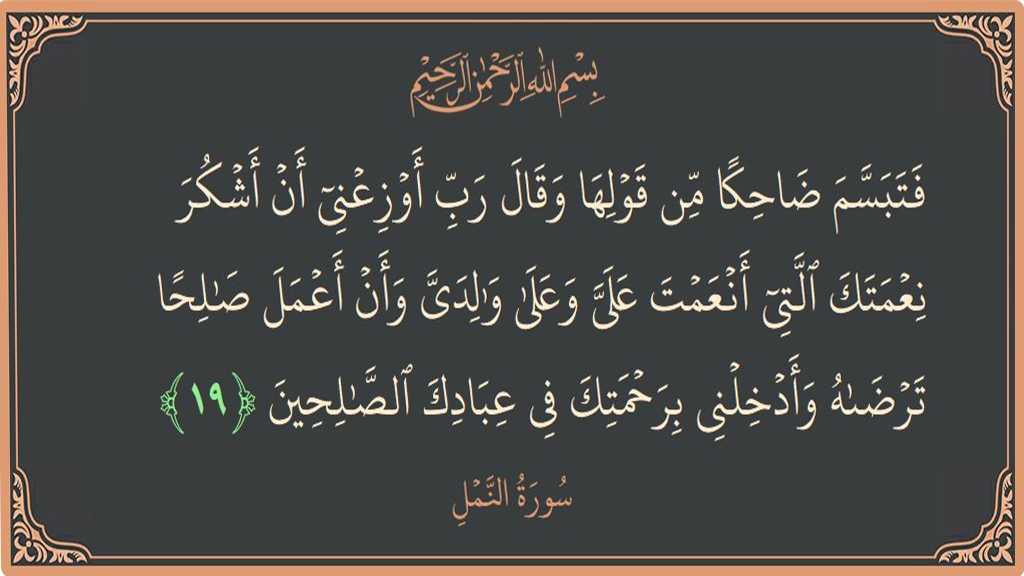
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
-

معنى (فلك) في القرآن الكريم
-
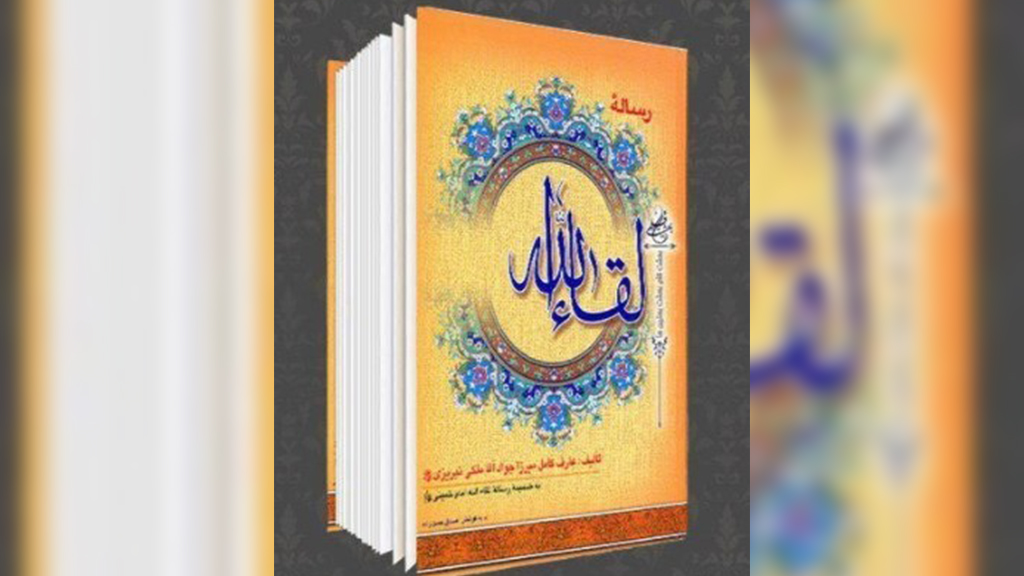
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب
-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا
-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش
-

هذا مهم، وليس كل شيء
-
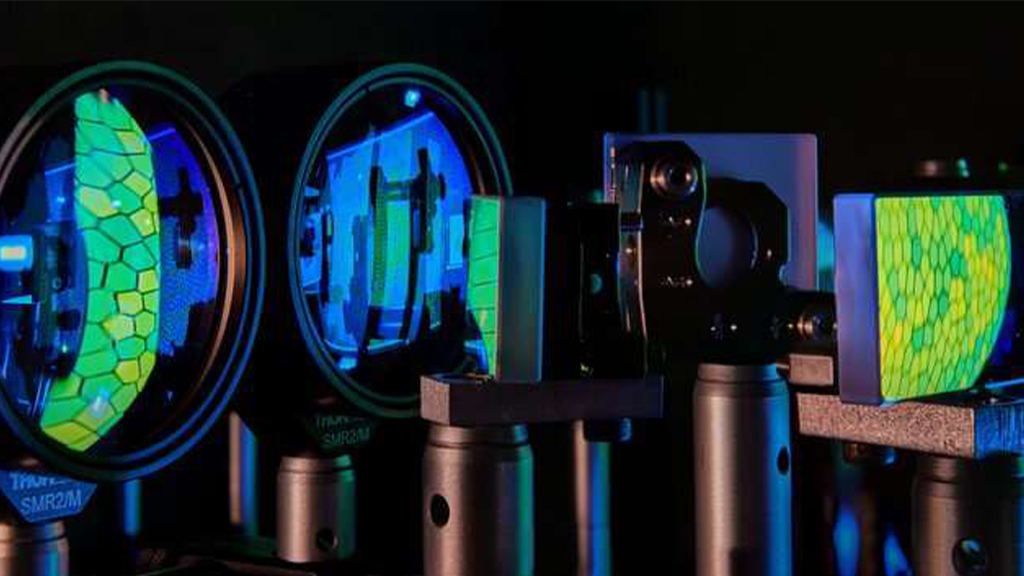
كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟










