قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :
مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيممفهوم «العدالة» في القرآن الكريم
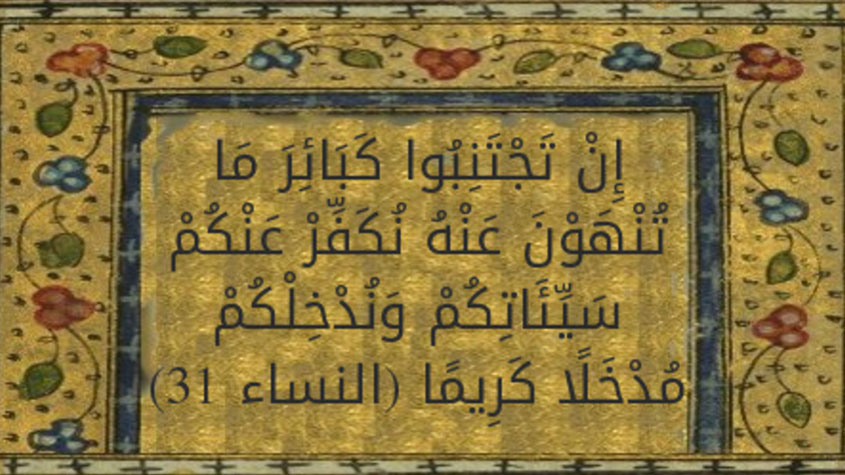
السيد محمّد حسين الطباطبائي
«العدالة» هي الاعتدال والتوسّط بين النمطين: العالي والداني، وبين جانبَي: الإفراط والتفريط، ولها قيمة حقيقية، ووزن عظيم في المجتمعات الإنسانية.
والوسطُ العدل هو الجزء الجوهريّ الذي يركَن إليه التركيب والتأليف الاجتماعيّ، فإنّ الفرد العالي الشريف -الذي يتلبّس بالفضائل العالية الاجتماعية ويمثّل بُغية الاجتماع النهائية- لا يجود منه الزمان إلّا بالّنزر القليل والواحد بعد الواحد. ومن المعلوم أنّه لا يتألّف المجتمع بالفرد النادر، ولا تتمّ به كينونته، وإن كان هو العضوَ الرئيس في جثمانه، حيثما وجد.
والفرد الدنيّ الخسيس -الذي لا يقوم بالحقوق الاجتماعية، ولا يتحقّق فيه القدر المتوسّط من أماني المجتمع، ومَن لا داعيَ له يدعوه إلى رعاية الأصول العامّة الاجتماعية التي بها حياة المجتمع، ولا رادعَ له يردعه عن اقتحام الآثام الاجتماعية التي تُهلك الاجتماع وتبطل التجاذب الواجب بين أجزائه- لا اعتماد على جزئيّته في بنية الاجتماع، ولا وثوق بتأثيره الحسن ونصيحته الصالحة.
وإنّما الحكم لأفراد المجتمع المتوسّطين الذين تقوم بهم بنية المجتمع، وتتحقّق فيهم مقاصده ومآربه، وتظهر بهم آثاره الحسنة التي لم تأتلف أجزاؤه وأعضاؤه إلّا للحصول عليها والتمتّع بها.
«العُدول» حاجة اجتماعية ملحّة
من نافل القول إنّ توفّر الأفراد «العدول» من ضرورات الاجتماع الإنسانيّ، وهذا ممّا لا يرتاب فيه الإنسان الاجتماعي بَدْوَ ما يُجيل نظره في هذا الباب. فمن الضروريّ عنده حاجته الشديدة في حياته الاجتماعية إلى أفراد في المجتمع يُعتمد على سلوكهم الاجتماعي؛ متلبّسين بالاعتدال في الأمور، والاحتراز عن الاسترسال في نقض القوانين ومخالفة السنن والآداب الجارية في أبواب كثيرة: كالحكومة، والقضاء، والشهادات، وغيرها.
وهذا الحكم الضروري، أو القريب من الضروري بحكم الفطرة، هو الذي يعتبره الإسلام في «الشاهد»، قال تعالى: ﴿..وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ..﴾. [الطلاق:2]
وقال تعالى: ﴿..شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ..﴾. [المائدة:106]
والخطاب في الآيتين للمؤمنين، فاشتراط كون الشاهدَين «ذوَي عَدلٍ» منهم، مفاده كونهما ذوي حالة معتدلة متوسّطة بالنسبة إلى مجتمعهم الديني، وأمّا بالقياس إلى المجتمع القومي والقطري؛ فالإسلام لا يعبأ بأمثال هذه الروابط غير الدينية.
ومعنى كونهما على حالة معتدلة بالقياس إلى المجتمع الديني، هو كونهما ممّن يوثق بدينه، غير مقترفَين ما يُعدّ من المعاصي الكبيرة الموبقة في الدين. قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾. [النساء:31]
وعلى هذا المعنى جرى كلامه تعالى في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. [النور:4-5]
ونظير الآية السابقة الشارطة للعدالة، قوله تعالى: ﴿..مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ..﴾. [البقرة:282]، فإنّ الرضى المأخوذ في الآية هو الرضى من المجتمع الديني، ومن المعلوم أنّ المجتمع الديني، بما هو ديني، لا يرتضي أحداً إلّا إذا كان على نوع من السلوك يوثَق به في أمر الدين. وهذا هو الذي نسمّيه في علم الفقه بـ«ملَكة العدالة»، وهي غير «ملَكة العدالة» بحسب اصطلاح علم الأخلاق، فإنّ العدالة الفقهية هي الهيئة النفسانية الرادعة عن ارتكاب الكبائر بحسب النظر العرفيّ، والتي في علم الأخلاق هي الملَكة الراسخة بحسب الحقيقة.
العدالة الفقهية في حديث الإمام الصادق عليه السلام
ما ذكرناه آنفاً من معنى العدالة، هو الذي يُستفاد من مذهب أئمّة أهل البيت عليهم السلام على ما ورد من طُرقهم: ففي (الفقيه) للشيخ الصدوق، بإسناده عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: بمَ تُعرفُ عدالة الرجل بين المسلمين، حتّى تُقبل شهادته لهم وعليهم؟
فقال عليه السلام: «أن تعرفوه بالسّتر، والعفاف، وكفّ البطنِ، والفرْجِ، واليدِ، واللّسان. ويُعرفُ (وتُعرفُ) باجتناب الكبائر التي أوعدَ اللهُ تعالى عليها النارَ؛ من شربِ الخمر، والزّنا، والرّبا، وعقوقِ الوالدين، والفرارِ من الزّحف...
والدلالة على ذلك كلّه، أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرمَ على المسلمين تفتيشُ ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته بين الناس، ويكون منه التعاهدُ للصلوات الخمس إذا واظبَ عليهنّ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعةٍ من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم، إلّا من علّة .
فإذا كان كذلك: لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سُئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يُجيز شهادته وعدالته بين المسلمين. وذلك أنّ الصلاة سترٌ وكفّارة للذّنوب، وليس يُمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضرُ مصلّاه، ولا يتعاهدُ جماعةَ المسلمين .
وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يُعرف مَن يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظُ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع، ولولا ذلك لم يكن لأحدٍ أن يشهد على آخر بصلاح، لأنّ من لا يصلّي لا صلاحَ له بين المسلمين، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، هَمَّ بأن يُحرق قوماً في منازلهم بتركهم الحضورَ لجماعة المسلمين، وقد كان منهم مَن يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، فكيف تُقبل شهادةٌ أو عدالةٌ بين المسلمين ممّن جرى الحكمُ من الله عزّ وجلّ ومن رسوله فيه الحرقَ في جوف بيته بالنار؟
وقد كان يقول صلّى الله عليه وآله وسلّم: لا صلاةَ لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين، إلّا من علّة».
والرواية -كما ترى- تجعل أصل العدالة أمراً معروفاً بين المسلمين، وتبيّن أن الأثر المترتّب عليه، الدالّ على هذه الصفة النفسية، هو تركُ محارمِ الله والكفّ عن الشهوات الممنوعة، ومعرِّفُ ذلك اجتناب الكبائر من المعاصي، ثم تجعل الدليلَ على ذلك كلّه حسنَ الظاهر بين المسلمين، على ما بيّنه عليه السلام تفصيلاً.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 النظام الاقتصادي في الإسلام (3)
النظام الاقتصادي في الإسلام (3)
الشهيد مرتضى مطهري
-
 مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا
مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)
حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)
الشيخ محمد صنقور
-
 معنى (نعق) في القرآن الكريم
معنى (نعق) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 بحثًا عن أنصار المهدي (عج)
بحثًا عن أنصار المهدي (عج)
السيد عباس نور الدين
-
 شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)
شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
الفيض الكاشاني
-
 في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)
في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)
محمود حيدر
-
 صبغة الخلود
صبغة الخلود
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ
تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ
عدنان الحاجي
الشعراء
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد
علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد
حسين حسن آل جامع
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
آخر المواضيع
-

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)
-

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا
-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)
-

يا جمعه تظهر سيدي
-
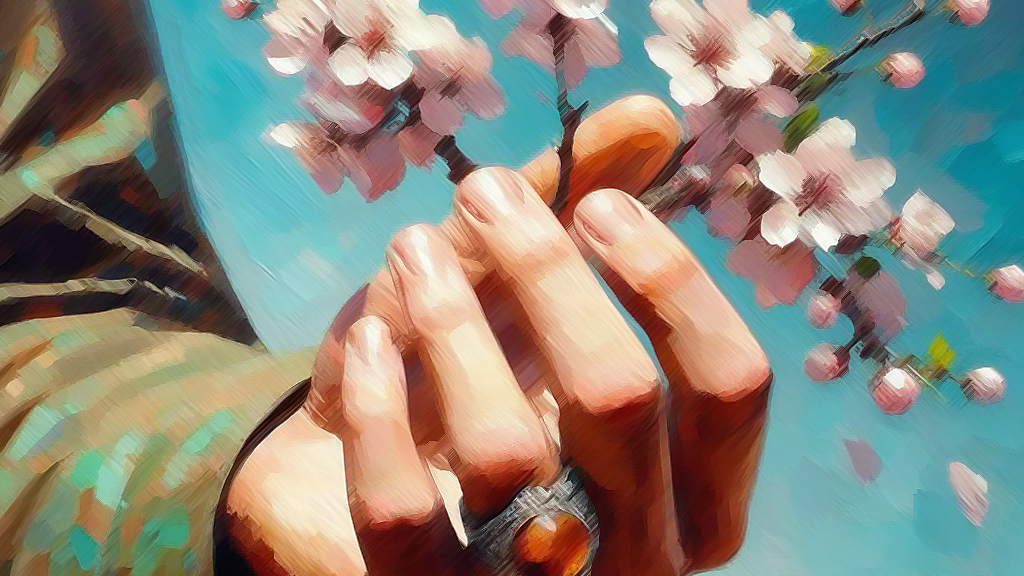
شربة من كوز اليقين
-

جمعيّة سيهات في ضيافة البيت السّعيد
-

(الأنماط الشّخصيّة وأثرها على بيئة العمل) محاضرة لآل عبّاس في جمعيّة أمّ الحمام الخيريّة
-

(شذرات من أدب الرّحلات) محاضرة لنادي قوافي الأدبيّ قدّمها الشّاعر زكي السّالم
-

الإيمان بالمهدي (عج) في زمن التّشكيك
-

معنى (نعق) في القرآن الكريم










