علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".العقل بوصفه اسمًا لفعل (3)

انقلاب العقل على العقل
مبعثُ الضلالة التأسيسيَّة لـ "الأنا الديكارتيَّة" يتأتَّى من افتراضها أنَّها هي سبب نفسها، وأنَّها مكتفيةٌ بذاتها ولا حاجة لمبدأٍ يؤسِّسُها. ويمكن أن نمضي إلى أبعدَ لنقول طبقًا لزعم ٍكهذا إنَّها واجدةُ نفسها. هنا نسأل: كيف لديكارت أن ينجو من عثرة التّناقض حين يزعم أنَّه كرَّس نظريَّته لإثبات وجود الله، وفي الحال عينها يتصرَّف كما لو أنَّ “أناه المفكِّرة” هي خالقة نفسها. واقع الحال أنَّ هذه الفرضيَّة المتسلِّلة إليه من طغيان منطقِهِ الرياضيِّ، لم تلحظ نقطة البَدءِ التي خرجت بسببها الأنا إلى الوجود. فقد تقدَّمت عنده الأنا المسكونة بفقرها ومحدوديَّتها على الوجود الأكمل الحاوي لكلِّ موجود والراعي لكلِّ شيء. حقيقة الأمر أنَّ “الأنا” التي تتوِّج الكوجيتو بدت شديدة الادِّعاء بالاقتدار، إلَّا أنَّها ظهرت مبتورةً عن أصلها الوجوديِّ، حيث لا تمتلك صفة التأسيس للوجود، بل حتى لوجودها هي بالذات.
غير أنَّ الجناية الأشدَّ أثرًا على الفكر الفلسفيِّ الحديث، أنَّ الكوجيتو سيدفع بسيرورةٍ من عدم اليقين أفضت في كثير من الأحوال إلى ضربٍ من الضلال المعرفيّ. وسيكون لهذه السيرورة تداعيات جمَّة ليس على ميتافيزيقا الحداثة وحسب، وإنَّما على مجمل العلوم الإنسانيَّة في العصور الَّلاحقة.
في حقبة ما بعد ديكارت ستظهر مؤثِّرات الكوجيتو على شكل مسارٍ انحداريٍّ سريع باتِّجاه العقلانية الصلبة. وستشهد ساحة الفكر تحوُّلات انعطافيَّة مع الفيلسوف الإنكليزيِّ ديفيد هيوم (1711-1776) الذي لم يُحِط الغموض بفيلسوف من فلاسفة الحداثة كمثل ما أحيط به. جلُّ من عاصروه، أو أولئك الذين جاؤوا من بعده ارتابوا من غموضه؛ وأخذهم الذهول حيال موقفه من العقل. انبرى هيوم إلى ما يتعدَّى الذي وضعه أستاذاه فرانسيس بيكون وجون لوك من قواعد للفلسفة التجريبيَّة. ولأجل أن ينفرد باختباراته الشخصيَّة، فقد خالفهما الرأي ليُعرِض عن كلِّ نزعة إيقانيَّة، وآثر التعامل مع التراث الميتافيزيقيِّ كلِّه بوصفه نقيضًا لأفهام الطبيعة البشريَّة. ربما كانت معضلة هيوم الأصليَّة أنَّه ركب موجة الثورة العلميَّة في القرن الثامن عشر من أجل أن يتربَّع فيلسوفًا أوحد على عرشها. ولكي يتَّفق له ما يريد، مضى بشغفٍ غير مسبوق إلى مناصبة الميتافيزيقا العداء، وحرص على زعزعة أركانها من داخل من دون أن يستغرق عالمها المكتظَّ بالعناء. ولقد فعل هذا إمَّا لقصور في الإحاطة بمفاهيمها، أو لخشيته الامتثال لمهابة أسئلتها العظمى.
ومثلما نالت الميتافيزيقا من هيوم نصيبها من الهدر، سينال العقل حتى في مرتبته الأداتيَّة، حظَّه الأوفى من تهمة التقصير والغموض؛ ولأنَّه عدَّ الغموضَ موجعًا للعقل مثلما هو موجِعٌ للعين، قرَّر أن يجتنب الوجع المحتَّم، وينساق نحو منهجٍ غرائزيٍّ يجعل العقل أقلَّ تحليقًا في الأعالي ممَّا اتَّخذه أيُّ فيلسوف حديث. هو لم يفترض أنَّ لدينا مَلَكَة أخرى أفضل قدرة لتزويدنا بمعرفة طبائع الأشياء؛ بل رأى أنَّ الشكَّ هو الموقف المعقول الوحيد الذي يتعيَّن اتِّباعه.
لقد أدان هيوم الميتافيزيقا واستنزَلَها منازل الأفكار الزائفة، ثمَّ لينتهي إلى ضربٍ من السخرية ممَّا توصَّل إليه من استنتاجات: «أنا خائفٌ ومرتبكٌ من تلك الوحدة البائسة التي وضعت فيها فلسفتي». هكذا قال. لكن مرجع خوفه يعود على أرجح تقدير إلى «لا أدريَّته» حيال سؤال الوجود، وكذلك إلى شكوكيَّته بمنطق العلم ومنطق التجربة في آن. ولو عدنا قليلًا إلى تاريخ الفلسفة منذ إرهاصاتها اليونانيَّة الأولى، لتبيّن لنا أنَّ الرجل لم يأتِ بخطب جلل. مَثَلُه كمثل سائر فلاسفة الحداثة ممَّن ذهبوا مذهب الشكِّ، حتى استوطن بعضهم أرض العدم، وهوى بعضهم الآخر إلى وادي الإلحاد. جلُّ هؤلاء أخذوا عن أسلافهم الإغريق عصارة الانعدام والشكِّ ثمَّ لم يأتوا بجديد يُعوَّل عليه. في الفترة التي تلت عهد سقراط، أي قبل قرون مديدة من ظهور الحداثة في الغرب، أطلَّت الشكوكيَّة برأسها مع رائدها الأوَّل بيرون حين رأى أنَّ: «المعرفة تُعدُّ أمرًا مستحيلًا، والمصير المحتوم للبشريَّة هو الشكُّ والَّلاأدريَّة.
بعد ذلك تمادت الشكوكيَّة، لتتحوَّل إلى مذهبٍ فكريٍّ يفيد أصحابه بأنَّ المعرفة الحقيقيَّة في حقل معيَّنٍ هي عبارة عن معرفة غير محقَّقة وليست ثابتة لدى الإنسان، أي أنَّ الحقيقة خارجة عن نطاق إدراك الذهن البشريِّ، وأنَّ الإنسان لا يمتلك القابليَّة لمعرفة الحقائق الثابتة، باعتبار أنَّ الحسَّ والعقل معرَّضان للخطأ. فضلًا عن ذلك، فقد عُدَتَّ الأصول المنطقيَّة التي وضعها أرسطو لصيانة الذهن من الخطأ غير كافية، وأنَّ السبيل الصحيح في التفكير هو التوقُّف عن إصدار آراء جَزْميَّة، ثمَّ بالغوا في منهجهم هذا لدرجة أنَّهم طبَّقوه على مسائل الرياضيَّات والهندسة معتبرين أنَّها قضايا احتماليَّة وتشكيكيَّة.
لم يكتفِ هيوم بما اقترفه بحقِّ الميتافيزيقا لمَّا حكم عليها بالبطلان، بل راح يبحث عن ذلك الفيلسوف الذي لا يقصد أكثر من أن يكون ترجمان الحسِّ الإنسانيِّ العامّ. ربَّما كان بما له من “ذكاء”، أن يحدِّد المسار العامَّ للفلاسفة والمفكِّرين من بعده. وسنرى من بعد ذلك كيف استولدت مسارات الحداثة سلالة متَّصلة من الفلاسفة الْتَمَّ شملُها على ذمِّ الميتافيزيقا وعبادة العلم المحض. من الشواهد الصارخة أنْ تحقَّق لديفيد هيوم مع إيمانويل كانط ما كان يرنو إليه. ففي عام 1756م قرأ الأخير ترجمة ألمانيَّة لنظيره حول الشكوكيَّة كانت كافية لتهزَّ إيمانه بشرعيَّة المعرفة الميتافيزيقيَّة، وهو ما عبَّر عنه بعد سنوات في مؤلَّفه «مقدِّمات نقديَّة» Prolegomena بجملته العصماء: «لقد أيقظني ديفيد هيوم من سباتي الدوغمائيّ»….
يأس العقل الأدنى من الميتافيزيقا وإنكاره لها
أدَّت فراسة هيوم على كانط إلى الاندفاع على غير هدى نحو اليأس العامِّ من المعرفة الميتافيزيقيَّة؛ ثمَّ كانت معضلته الكبرى عندما شرع في تحويل الميتافيزيقا إلى علم. جاء الأمل الموهوم لكانط من المصدر نفسه الذي جيء به إلى ديكارت؛ أي من الثورة العلميَّة التي أبهرت الجميع بسحرها. ابتهج كانط بالنور الخافت الذي أدركه في فوضى الهندسة المعاصرة، وصار يبصر في نور العلم منبعثًا لبداية إصلاح العلوم. كان ثمَّة تباين بارز بين الضعف الواضح للأنظمة الميتافيزيقيَّة الغربيَّة وحالة الازدهار التي شهدها العلم الوضعيُّ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فقد حافظت الرياضيَّات على حُسن سمعتها القديمة، وبلغت الفيزياء مع نيوتن عزًّا لم يعهده علم الطبيعة من قبل، لكنَّ الفلسفة ظلَّت تواجه معضلة العزلة حتى كادت تذوي تحت وطأة الضربات القاسية للعلم.
ربَّما كان من الضروريِّ في السياق إيَّاه أن نستفهم عن نوع الميتافيزيقا التي استيأس منها إيمانويل كانط (1724-1804) وكان للعقل فيها نصيب وفير. حسب الذين قرأوا نقديَّة العقل المحض وصلوا إلى قرار أنَّ كانط لم يخصِّص مكانًا لعلم الوجود بما هو وجود لا في الميتافيزيقا العامَّة ولا في الميتافيزيقا الخاصَّة. لذلك لم يكن له أيُّ شأن أو علاقة بالعلل النهائيَّة لكلِّ الأشياء الموجودة ومنها الله باعتباره عنده العلَّة الأولى. في الإلهيَّات الطبيعيَّة فقط حاول أن يثبت وجود الله عن طريق برهانين هما البرهان الوجوديُّ والبرهان الكوسمولوجيُّ، لكنَّه لم يبدِ أيَّة محاولة لإثبات سائر التعاليم الدينيَّة إثباتًا عقلانيًّا، وبذلك ترك تأثيرًا مهمًّا في الَّلاهوت البروتستانتيِّ خلال القرن الثامن عشر للميلاد.
حين راقب كانط الجدل المفتوح حول الميتافيزيقا، كان عليه أن يستقرئ ثلاثة اتِّجاهات، ثمَّ يختار الاتِّجاه الذي يناسبه منها: – الأوَّل: ما يذهب أهله إلى اعتبار موضوع الميتافيزيقا هو الوجود على نحو كليّ. – الثاني: من يرى أنَّ الميتافيزيقا هي العلم بالموجودات غير المادّيَّة (المجرَّدات). أمَّا الاتِّجاه الثالث فهو الذي سيأخذ به كانط، أي اتِّجاه الذين قالوا إنَّ الميتافيزيقا هي العلم بالأصول الأولى للمعرفة البشريَّة، والتي تشتقُّ منها أصول كلِّ العلوم الأخرى. لم تعد الميتافيزيقا العلم بالوجود بما هو وجود، بل العلم بأصول المعرفة البشريَّة. ولقد وجد كانط أنَّ الاتِّجاه الثالث للميتافيزيقا، هو الشكل الوحيد الممكن لها..
وعليه، فإنَّه عندما يقول إنَّها غير ممكنة، فقصده في ذلك هو الميتافيزيقا بالمعنى والتفسير الثاني. والحقيقة هي أنَّ التفسير الثاني، كما سيلاحظ القارئ بنفسه، انبثق من قلب الميتافيزيقا الخاصَّة عند فولف. وكما مرَّ بنا فإنَّ الميتافيزيقا الخاصَّة تنتج ثلاثة علوم فلسفيَّة: علم الكون، وعلم النفس، والإلهيَّات الطبيعيَّة (العلم بالله). يعتقد كانط أنَّ موضوع كلِّ هذه الفلسفات الثلاث يقع خارج نطاق المحسوسات، بمعنى أنَّ كلَّ واحدة من هذه الفلسفات تتعامل مع تصوُّر متعالٍ (transcendental idea)، وتعمل على دراسته والتحقيق فيه. ومراده من التصوُّر هنا واضح تمامًا: أي التصوُّر بما هو مفهوم ضروريٌّ للعقل لا يمكن للتجربة الحسّيَّة أن تمنح أيَّ متعلِّق مناظر له.
في المسار الَّلاحق للفكر الغربيِّ، قضى قَدَر كانط بأن تميل كفَّة نقده المعرفيِّ إلى الرجحان مقابل كفَّة تأكيداته الإيجابيَّة حيال الدين والعلم على حدٍّ سواء. فمن ناحية بدا الهامش الذي وفَّره للإيمان الدينيِّ شبيهًا بنوع من الفراغ، لأنَّ هذا الإيمان كان قد افتقد إلى مجمل أشكال الدعم الخارجيِّ، سواء من العالم التجريبيِّ أم من العقل المحض، ناهيك بالافتقار إلى المعقوليَّة والملاءمة الداخليَّتين بالنسبة إلى شخصيَّة الإنسان العلمانيِّ لحديث. ومن الناحية الأخرى بات يقين المعرفة العلميِّ مفتقرًا أيضً إلى الدَّعم من جانب أيِّ ضرورة معرفيَّة داخليَّة بعد قيام فيزياء القرن العشرين بإحداث انقلاب مثير في جملة المقولات النيوتنيَّة والإقليديَّة التي كان كانط قد افترض أنَّها مطلَقة.
من الذين نقدوا بعمق ودراية النظام الفلسفيَّ الكانطيَّ، سيبيِّن أن مجمل مشروعه في نقد العقل المحض كان متناقضًا. إذ كيف لكانط أن يسوِّغ استخدامه للعقل ويعتبره وسيلة للبرهنة على فشل العقل في الوصول إلى المعرفة الفعليَّة بالأشياء كما هي في الواقع؟ ثمَّ كيف له أن يعلن أن المرء لا يستطيع تحصيل المعرفة بالشيء في ذاته، وفي الوقت نفسه يستمرُّ في وصف العقل كشيء في ذاته – أي بنيته المطلَقة؟ و – حسب أصحاب هذا الرأي – أنَّ كلَّ حججه في نقد العقل المحض لا أساس لها ما لم تكن قادرة على وصف العقل كما هو حقيقة، وهذا لا ينطبق عليه فحسب، بل على الحالات المشابهة كلِّها. فإذا كنَّا لا نعرف إلَّا ظواهر الأمور، فكيف يمكننا أن نعرف العقل بذاته؟ وإذا كنا لا نعرف إلَّا الظاهر فقط، فهل ثمَّة معنى، في التحليل النهائيِّ، لقولنا إنَّنا نعرف شيئًا ما؟ أمَّا سبب هذه التناقضات، فيعود وفقًا لبادر، إلى أنَّ الفلسفة النقديَّة استثنت معرفة اللَّه والدين النظريِّ من حقل المعرفة التي يمكن الحصول عليها عن طريق العقل. [Franz von Baader, ipid, p.180 ].
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
محمود حيدر
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
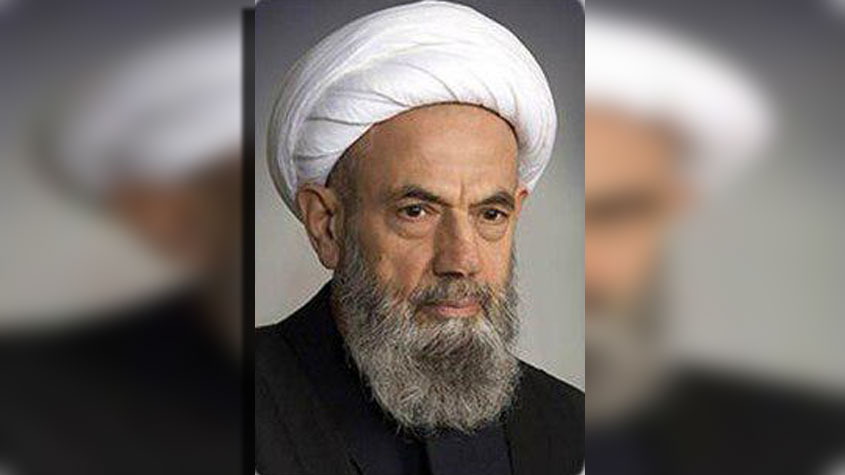 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
الشيخ مرتضى الباشا
-
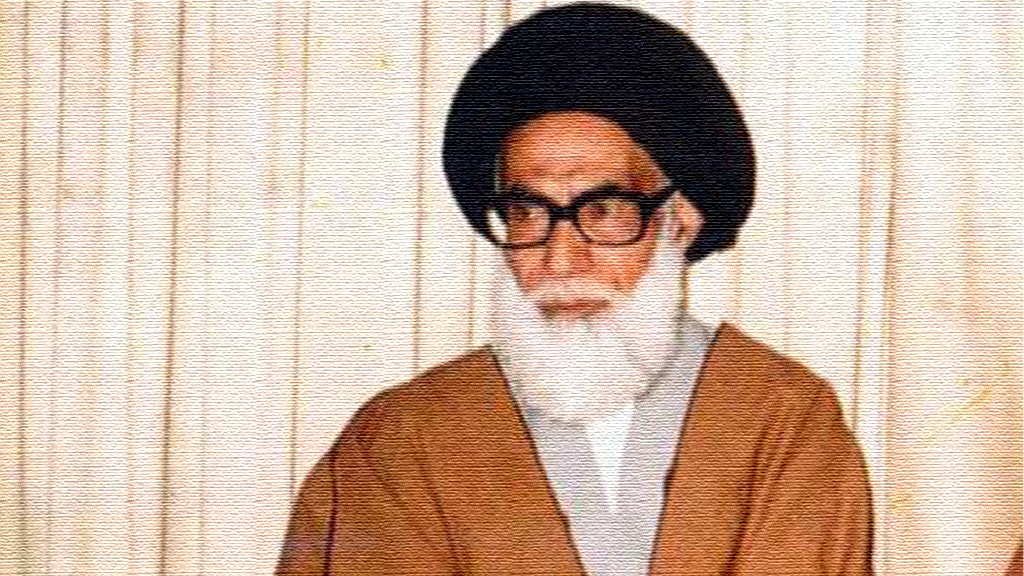 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)
-
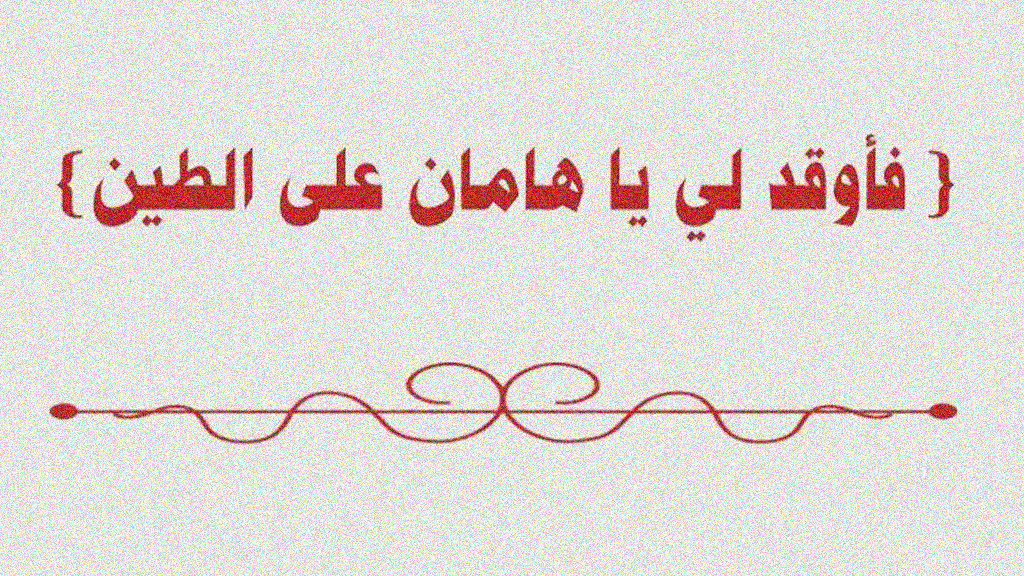
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة
-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
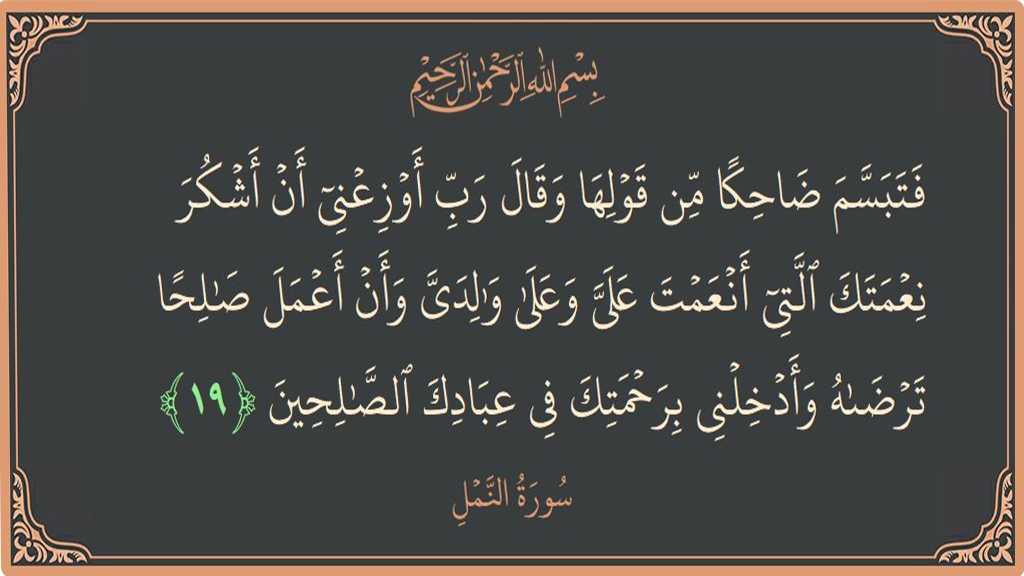
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)









