علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ميتافيزيقا السؤال المؤسِّس (4)

ماهيَّة السؤال المؤسِّس وجوابه
تظهر ماهيَّة السؤال المؤسِّس في التعرُّف على ثلاثة أركان: على السؤال نفسه، وعلى أحوال السائل، وعلى فعاليَّاته في المجالين الأنطولوجيِّ والتاريخيِّ. وما من ريب في أنَّ مهمَّة كهذه تنطوي على عناصر متداخلة لا تتوقَّف أبعادها على الاستفهام عن الشيء وشيئيَّته، أو على فرادة الإنسان بما هو كائن يسأل، ولا كذلك عن سرِّ الوجود المطلق.. وإنَّما أساسًا على السؤال بما هو سؤال. أي على جوهريَّته وحضوره كقيمة أصيلة في الحيوات الإنسانيَّة. ما يعني أنَّنا بإزاء مقولٍ أنطولوجيٍّ يضاعف ممَّا ذهبت إليه الفلسفة الأولى في تعريف الفلسفة “بكونها عبارة عن أسئلة، الأصل فيها دهشة الإنسان بالظواهر التي تحيط به”.
لكنَّ السؤال، والسؤال المؤسِّس على وجه الخصوص، هو الظاهرة الأكثر هولًا وإدهاشًا في اختبارات العقل البشريِّ الواعي. حين يُسأل عن السؤال وأحواله لا يعود ثمَّة مسافة بين السائل وسؤاله، ولا بينه وبين الإجابة المحتملة. في لحظة بَدئه وانبثاقه يصير السائل والسؤال والموضوع المتعرَّف عليه كينونة واحدة. إلَّا أنَّ المؤسِّس بحكم طبيعته المؤسِّسة ينبري إلى الاعتناء بعالم الكثرة ليحدِّد لكلِّ فرد من أفرادها ماهيَّته وهوّيَّته والدور المناط به في الزمان والمكان المحدَّدين. لذا تبقى الكينونة غير محدَّدة وغير منجزة ما دامت لم تتلقَّ بعد جوابًا عمَّا تطلبه لتصبح محدَّدة.
ولكي تحصِّل الكينونة الجواب عمَّا يفصح عنها كماهيَّة وهوّيَّة ودور عليها أن تتطلَّع إلى المقبل، وأن تنتقل إليه وتستوطنه لتعيشه بكثافته ولطائفه. فهناك تتهيَّأ للتلقّي. الجواب سمْتُه الإقبال في الَّلحظة التي يسمع فيها نداء السؤال. لكن ذلك السؤال الذي يسري ضمن حركة جوهريَّة مطابقة لروح الكينونة المتشكِّلة من ثلاثيَّة السائل والسؤال والشيء المسؤول عنه. ذلك بأنَّ الحركة في الجوهر هي حركة دفعيَّة تختزل الزمن وتنقل الكينونة المثلَّثة الأضلاع من حال التبدُّد والزوال إلى مقام الثبات والديمومة. وهي على خلاف الحركة الامتداديَّة الفيزيائيَّة التي تستهلك الزمن ويستهلكها، وتكون النتيجة تبديد السؤال وتبديد جوابه.
لقد اختبر العقل البشريُّ بالسؤال أول تمرين له في رحلة التعرُّف على مثلث الوجود: الله، الكون، الإنسان. وبه فُتِحَ بابُ التعرُّف على ما يستتر عن العين والعقل. فقد أقرَّ له العقلاء منذ الزمن الأول بهذه المزيَّة، حتى صار السؤال عندهم دُربةَ الفكر إلى فهم ما استغلق عليهم من حقائق. وما ذلك إلَّا لكون الاستفهام علامة دالَّة على سَرَيان العقل في الزمان الَّلامحدود، وبالتالي قدرة الإنسان على تقسيمه وترتيبه ونظمه ضمن مواقيت محدَّدة تناسب شرائط عيشه.
مؤدَّى ما نقصده، أن ما لا يؤسِّس لا يعوَّل عليه. وأن مقتضى التأسيس متاخمة منابت الأفهام والأفكار وتمييز صوابها من بطلانها، ثمَّ إعادة تأليفها تبعًا لتحوُّلات الأزمنة ومقتضياتها. ما يعني أنَّ السعي للعثور على مبدأ مؤسِّس هو فعلٌ زمانيٌّ ومكانيٌّ بقدر ما هو فعلٌ يجاوز الزمان والمكان. ومثل هذا الاختبار لا يقدر عليه في عالم الموجودات إلَّا الإنسان الذي جاهر بالسؤال، فيما سائر الموجودات تسأل عن حاجاتها بخفاء. لكن وفقًا لمبدأ التكامل فإنَّ جميع ما في العالم على تراتب موجوداته واختلافها في الاختبار يفعل فيه. الإنسان وما يحيط به من موجودات كلٌّ له نصيبه في التأسيس، وكلٌّ بحسب وضعيَّته الوجوديَّة. ذلك بأنَّ رسم حدود التمايز بين الإنسان والشيء لا يعني تغييب الشيء عن الحضور بوصفه عنصرًا جوهريًّا في تكوين هذا السؤال. فالكائنات كلُّها مطويَّة فيه ومتضمَّنة في غضونه، ولولاها لما كان للسؤال أن يُسأل، ولا كان له أن يكون سؤالًا يستدرج الإجابة.
حتى الاستفهام عن المطلق الذي يفترضه الذهن البشريُّ حين يتأمَّل عالم المعنى، لا ينفصل البتَّة عن عالم الممكنات. فعالم الإمكان ضروريٌّ في تظهير السؤال المؤسِّس والتعرُّف على إمكانيَّاته ووعوده. وما ذاك إلَّا لأنَّ الممكنات التي تمدُّ الحياة الإنسانيَّة بأسباب القدرة والديمومة هي التي تصنع للسؤال مواقيته ومكان حدوثه. لكن السؤال المؤسِّس رغم عنايته بعالم الإمكان يبقى متعلّقًا بمهمَّته الأصليَّة من خلال اعتنائه بالحقيقة المؤسِّسة للوجود. وعليه، لا يُنجز الاستفسار عن الشيء وشيئيَّته، ولا عن الموجود بما هو موجود، بمعزل عن هذه المهمَّة. فقد بذلت الميتافيزيقا مذ أبصرت النور في أرض الإغريق وإلى يومنا الحاضر ما لا حصر له من المكابدات إلَّا أنَّها غالبًا ما انتهت إلى الَّلايقين. لقد اختبرت النومين (الشيء في ذاته) والفينومين (الشيء كما يظهر) وكانت النتيجة أن نشأ حائلٌ حدَّ من جاذبيَّة العقل، وحال دون قدرته على تحرِّي غموض الوجود وغيبته.
السؤال المؤسِّس ومراتبه الوجوديَّة
لا يفارق السؤال المؤسِّس بوصفه سؤالًا أنطولوجيًّا، الأسئلة الفرعيَّة التي تهتمُّ بعالم الموجودات. التأسيس بحسب الفيلسوف الفرنسيِّ جيل دولوز يعني التعيين. ثمَّ يسأل ليجيب: علامَ يقوم التعيين، وعلامَ يُمارَس؟ الأساس هو عمليَّة الُّلوغوس أو السبب الكافي. وبوصفه الأساس، فإنَّه يمتلك ثلاثةَ معانٍ:
الأساس في معناه الأول، هو الـ”عينه” أو المتطابق. يتمتَّع بالهوّيَّة الأسمى، المفترض أنَّها تنتمي إلى الأمثول، العين عينه. ما يكونه وما يمتلكه، يكونه ويمتلكه في الأول. ومَن هو الشجاع باستثناء الشجاعة، والفاضل باستثناء الفضيلة؟ ما يمتلكه الأساسُ للتأسيس، هو إذًا فقط ادّعاء الذين يأتون بَعد الذين يمتلكون.
المعنى الثاني في الأفضل. ما يطالب بأساس، ما يدعو إلى أساس، هو دومًا طموح، أي “صورة”: مثلًا، طموح أناس بأن يكونوا شجعانًا، وبأن يكونوا فاضلين – بإيجاز، بأن يمتلكوا جزءًا، بأن يشاركوا أي أن يمتلكوا في ما بعد. يميَّز إذًا الأساس بما هو ماهيَّة مثلانيَّة، المؤسَّس بما هو الطامح أو الطموح، وما يتناوله الطموح، أي الكيف الذي يمتلكه الأساس أولًا، والطامح إذا كان مؤسَّسًا سوف يمتلك ثانية. تجعل عمليَّةُ التأسيس الطامحَ متشابهًا مع الأساس، تعطيه من الداخل التشابهَ، وبهذا الشرط، تعطيه ما يجعله يشارك الكيفَ، الموضوع الذي يطمح إليه. يُسمَّى الطامحُ المتشابهُ مع عينه، تشابهًا؛ إلَّا أن هذا التشابه ليس تشابهًا خارجيًّا مع الموضوع، هو تشابه داخليٌّ مع الأساس ذاته[1](…) ما يجب تأسيسه، هو طموحٌ بالاستيلاء على الَّلامتناهي، على التأسيس الآن أن يعمل داخل التمثُّل، ليمدَّ حدودَه إلى الَّلامتناهي الصغر، كما إلى الَّلامتناهي الكبر. تعبّر هذه العمليَّةُ عن السبب الكافي. ليس هذا السببُ الكافي الهويَّةَ، ولكن وسيلة الإخضاع للـ “هو هو”، ولمتطلّبات التمثُّل الأخرى ما كان يفلت منها من الاختلاف في المعنى الأول.
تجتمع دلالتا الأساس، مع ذلك، في دلالة ثالثة. التأسيس هو – في الواقع – دومًا الخضوع، الانحناء – ترتيب نظام الفصول، السنوات والأيام. نجد أنَّ موضوع الطموح (الكيف، الاختلاف) وُضِع دائريًّا؛ تتميَّز أقواس الدائرة بقدر ما ينشئ الأساس في الصيرورة الكيفيَّة لركودات الدم ولحظات أشكال قطع تقع بين الحدَّيْن الأقصيَيْن للأكثر والأقل. يتوزَّع الطامحون حول دائرة متحرِّكة، يتلقَّى كلُّ واحد النصيبَ الذي يقابل جدارة حياته: تُشَبَّهُ حياةٌ ما هنا بحاضر دقيق يُبرِز طموحه بجزء من دائرة، “تدغم” هذا الجزء، وتتلقَّى منه خسارة أو ربحًا في نظام الأكثر والأقلّ بحسب تقدُّمه الخاصِّ به أو تراجعه في تراتبيَّة الصور (حاضر آخر، حياة أخرى تدغم جزءًا آخر).
نرى في الأفلاطونيَّة كيف يشكِّل دورانُ الدائرة وتوزيعُ النصائب، الدورةَ والتناسخَ، الاختبارَ أو يانصيبَ الأساس. ولكن أيضًا عند هيغل، تقسم كلُّ البدايات الممكنة، كلُّ الحواضر في دائرة وحيدة غير متوقّفة لمبدأ يوسِّس، يضمُّها في مركزه كما يوزِّعها على محيطه. وعند لايبنتز، التماكن عينه هو دائرة التلاقي حيث تتوزَّع كلُّ وجهات النظر، كلُّ الحواضر التي تؤلِّف العالمَ. والتأسيس في هذا المعنى الثالث، هو تمثُّل الحاضر أي جعله يفاجئ ويمرُّ في التمثُّل (المتناهي أو الَّلامتناهي). يظهر الأساسُ إذًا، كما هي حال ذاكرة سحيقة أو ماضٍ محض ماضٍ، لم يكن قطُّ هو نفسه حاضرًا، ويجعل الحاضرَ يمضي، فتتعايش كلُّ الحواضر بالنسبة إليه في دائرة.
باختصار، السبب الكافي، الأساس هو مكوِّع بغرابة. ينزع من جهة، نحو ما يؤسِّسه، ومن الجهة الأخرى، ينعطف نحو ما فوق الأساس الذي يقاوم كلَّ الأشكال التي تفلت من التمثُّل.
التأسيسُ إذًا، على ما يبيِّن دولوز هو تعيين الَّلامتعيّن. ولكن هذه العمليَّة ليست بسيطة. عندما يمارَس “التعيينُ، فإنَّه لا يكتفي بإعطاء شكل أو بعدم تشكيل موادَّ تحت شرط المقولات. إنَّه شيء من العمق يصعد مجدَّدًا إلى السطح، يصعد إليه من غير أن يتَّخذ شكلًا، ويتسلَّل بالأحرى بين الأشكال، وجود بلا وجه مستقلّ ذاتيًّا، قاعدة مرتكز لاشكليَّة.
وعليه، فإنَّ ثمَّة جدليَّة اتِّصال وانفصال بين هذا السؤال ومراتبه الوجوديَّة. ولمَّا أن كان الوجود واحدًا متَّصلًا ومبنيًّا على التراتب، كذلك يكون الاستفهام عنه. أي أنَّه وجود واحد ذو مراتب. ولإنجاز الاستفهام وفق هذه الجدليَّة، وجدنا النظر إليه ضمن ثلاث مراتب: – سؤال فانٍ، سؤال باقٍ، وسؤال يتردَّد بين الفناء والبقاء. ولكلٍّ من هذه المنازل خصائصه المعرفيَّة ومقتضياته وظروفه الزمانيَّة والمكانيَّة وآثاره النفسيَّة والمعنويَّة. وفي ما يأتي نعرض إلى ماهيَّة وطبيعة كلِّ مرتبة:
أوَّلًا: السؤال الفاني: متعلِّق بماهيَّة وصفات الشيء ونشاطه كظاهرة في زمان ومكان محدَّدين، ولذلك فالسؤال عن الموجود الفاني هو سؤال فانٍ لأنَّه يحيا به ويزول بزواله. والطبيعة الفانية لهذا النوع من السؤال تعود إلى اختصاصه بدنيا الحواسِّ وتعلُّقه بالحاجات المباشرة للموجودات. فإذا سُدَّت لموجود ما حاجتُه كفَّ عن المطالبة. وما يكفُّ عن الطلب ينقضي أمره ويتبدَّد سؤاله. وحتى لو عاد المحتاج إلى السؤال عن حاجته كرَّة أخرى فلن يتعدَّى سؤاله عالم الفناء ما دام طلبُه منحصرًا بالأغراض الفانية.
إذًا، السؤال الذي يتعلَّق بالفاني ويجيء قبل أوانه لا أثر له، وهو غير قابل لأن يصير حدثًا أو فكرة. وما ذاك إلَّا لأنَّه بحكم ارتباطه بعوارض الممكنات آيلٌ إلى الفناء؛ وبالتالي فالاستفهام عنه غير موفور في الَّلحظة العجولة التي أعلن فيها. لذا، هو سؤال خارج الزمن الواقعيِّ ولا دوام له. وما لا دوام له في عالم الواقع معدوم الإجابة. أمَّا السؤال الذي يأتي بعد أوانه فسينتهي إلى النتيجة إيَّاها. فهو بحكم فوات وقته وانقضاء موضوعه يغدو عرضه للفناء، إمَّا لأنَّه يعيد تكرار الاستفهام عمَّا قد تحصَّل جوابُه من بعد أن تحوَّل إلى حدث، أو لأنَّه أُهمل وهُجر فلم تُدرك ماهيَّته أو يُعرف سرُّ ولادته المتأخِّرة.
لأجل ذلك كان من أبرز سمات السؤال الفاني وقوع صاحبه في الحَيْرة. وحيرته هنا ذات طبيعة سالبة وهي حَيْرة الكثرة من الناس. معها يكون الحائر متطيِّرًا ممَّا يكِّدره من أمور دنياه، فيتشابه عليه خيرُها وشرُّها، عاليها وسافلُها، ولا يجد لأمره حيالها من سبيل. وهذا الصنف من الحَيْرة ينتسب إلى ما نسمّيه بـ “الفراغ العجيب”. والممتَحنُ بهذا النوع من الفراغ محاطٌ بالقلق من كلِّ جانب. فهو أشبه بحاوية ضخمة من الظنون. سمتُه الَّلايقين وفقدان الثقة بالذات وبالغير. لا يواجه الحائر في السؤال الفاني أمرًا إلَّا أخَذَه العَجَب، فالفراغ العجيب علم ناقص، ولأنَّه كذلك فلن يسفر إلَّا عن حيرة مشوبة بالجهل. فإذا كان من أفعال العقل أنَّه يجمع ما تفرَّق في عالم الممكنات والمحسوسات، فالحائر في الفراغ يفرِّق ما كان شملُه مجموعًا. لهذا أمكن لنا القول أنَّ الحائر هاهنا يدور حول نفسه، ولا يملك أن يغادر دوَّامته قطّ. فإنَّ من طبائع الحيرة النازلة جمعها بين نقيضين: يقين ناقص وشكٍّ ناقص، والعائش فيها لا يقدر أن يجاوز نقصانه ويمضي إلى انشراح الصدر.
ثانيًا: السؤال المتردِّد بين الفناء والبقاء: صاحب هذا السؤال يسأل عن الأبديَّة ولا يعيشها. ولأنه يعرض عنها بالنظر والعمل داهَمَه النسيان. لذلك قد نجده يميل في أسئلته الى الشيء الفاني والفكرة الفانية بحكم انئخاذه بسحر الموجودات وتعلّقه بجاذبية الحس. وبسبب من منزلته التوسطية بين الفاني واللاّفاني ينحكم صاحب هذا السؤال بالتقلُّب والحَيْرة. وغالباً ما يشعر بأن يومَهُ كأمسِهِ وأمسَهُ كَغَدِه. وهكذا تتساوى أيامه في التكرار والتواتر ولا يقدر على أن يأتي بما يساعده على الانتقال الى ضفة الاستقرار وسداد الرأي.
مع ذلك فإن حيرة الحائر بين الفناء والبقاء هي ذات طبيعة مختلفة عمن سبقه. ويترتب على هذا الاختلاف تمايزاً عن سواه في استقراء الوجود. فالحيرة الوسطى على الرغم من تطلعها الى الباقي والمطلق تبقى تدفع بصاحبها الى الفاني والنسبي. مع ذلك يستطيع الحائر فيها أن يجد له منفسحاً للتفكير بالسؤال المؤسِّس بما لديه من ذكاء وفطنة وسَعَةِ حيلة. في هذا المطرح يرنو الحائر الى مجاوزة نقصه شوقاً الى الانسجام والكمال. إلا أن عيشه في المنطقة الوسطى بين الفراغ والامتلاء يبقيه حائراً فلا يفلح بالصعود درجة الا إثر مكابدة…
ثالثاً: السؤال الباقي: هو سؤال يغتذي من الوصل الخلاَّق بين الله والكون والإنسان. ولو كان لنا أن نجعل له مقاماً لأقمناه في مقام “فوق ميتافيزيقي”. ولعل هذا المقام هو الأكثر قابلية لاستيلاد السؤال المؤسس ذلك بأنه مقام الجميع بين الأضواء، والوصل بين الوحدة والكثرة. ناهيك عن رعايته للتكامل والانسجام بين الغيب والواقع المشهود. في هذا المقام يكون السؤال حيَّاً، إلا أنه سؤال من ذلك النوع الذي لا ينتظر الاجابة على نحو ما يبديه الانسان من استفهامات في عالم الحس.
فالإجابة ها هنا استجابة وإقبال ذلك بأنها متضمنة فيه ولو لم تظهر نتائجها في اللحظة التي تلي السؤال. فالإمكان تبيُّن ماهية السؤال الباقي في ما ذهب إليه التأويل العرفاني للزمن. فقد وصف عرفاء الصوفية أنفسهم بـ “أبناء الوقت”. وكلمة الأبناء تدل على جمع العارف بين أضلاع ثلاثة: الزمان والمكان وحضور الإنسان فيهما. فمتى جاز المرء على الجمع بين الأضلاع ومعهم كان على شاكلتهم. وقتُه وقتهُم سمتُه سمتُهم، ومطرحُه مطرحُهم، ومآلُه مآلُهم. عندئذٍ يصير الزمن مقاماً للكائن لا يُعرَفُ الا فيه ولا يعرِفُ الوجود إلا من محرابه. والذي لم يبلغه بعد لا يقدر على المعرفة التي تمكنه من الكشف والمشاهدة. فلو لم يكن ابناً للوقت بهذا المعنى الخاص والمتعالي، يغدو مستحيلاً بالنسبة اليه لأنه غريب عن التماس ولا يملك عين البصيرة.
السؤال في المقام “فوق الميتافيزيقي” منفتح على اللامتناهي ومقيَّدٌ فيه في الآن عينه. فالسؤال عن الأزل، وبالتالي عن الله لا يسري في عالم المفاهيم الذي نشأ ونما في محراب الماهيات الفانية. أما السؤال عن الباقي والأزلي دائم فهو ما لا يمكن أن يُحمل على قول. لأن القول المحمول على شيء ما، هو قول محدد ومحدود بماهية ذاك الشيء. ولو شاء السائل أن يجيب على ماهية الأزلي بالوصف فلن يسعفه اللفظ. فالأزلي يتأبّى على كل لفظ. ولو تُلفَظ عنه فليس اللفظ بصائب حتى لو كان صادقاً في اللحظة التي يصدر فيها على لسان اللاَّفظ.
لذلك سنرى أن السؤال عن الله هو من النوع الذي لا يُجهر به. لأنه ليس بعارض، وهو غير منحكم إلى زمان ولا إلى مكان. ثم إن السؤال عن الله لا يصح أن يندرج ضمن الاستفهام الفينومينولوجي عن الأشياء. ذلك استفهام عن اللاَّمتناهي والمحيط بكل شيء، لا بالسائل المحدد والمحدود والمحاط به. ولذا فالسؤال عن الله هو سؤال الذي لا تحاط ذاته بالفهم لأنه مطلق. والمطلق بحسب تعريف علماء اللغة هو ذكر الشيء باسمه حيث لا يُقرن به صفة ولا شرط ولا زمان ولا عدد ولا شيء يشبه ذلك!”.
ولأنه مطلق ومحيط بالموجودات في زمانها ومكانها فلا مناص للموجودات من أن تأخذ من محيطها أصل موجوديتها. فالمحيط بالأشياء عطاء أزلي يمد كل شيء بما يحتاج إليه، والعطاء الأزلي لا ينتظر سؤال الشيء حتى يجيبه، بل من طبيعته الجود على الموجود ليكون موجوداً، سواء كان هذا الموجود صامتاً متلقياً كالموجودات الفيزيائية، أو ناطقاً ذا إرادة واختيار كالإنسان. الأزل إذاً، الفيض على الموجودات بمواقيت تناسب خصائصها الوجودية. ولذا فهو يجيب على الأسئلة التي تحتويها الأشياء سواء منها المضمرة في نفس الشيء أو تلك الظاهرة على شكل مناجاة واعية. والوجود الفياض هو الوحيد الذي يعلم سر أسئلتها ومتى واين وكيف تكون الإجابة. إجابة الأزلي على سؤال الشيء والإنسان لا تتأخر ولا تتقدم، وانما صدور للسؤال والجواب في عين اللحظة. فالأشياء تحت عينه وعنايته، وفيضُه عليها لا ينقطع حتى لو تبدلت صورها المادية. أما علاقة الأزل بأزمنة الإنسان فهي علاقة مفارقة، فالإنسان شيء لا كالأشياء، ولذا فإن سؤاله ليس صامتاً وإنما ضوضاء تشغل الكينونة بنداءات لا تنقطع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – جيل دولوز – الاختلاف والتكرار – ترجمة: وفاء شعبان – المنظَّمة العربيَّة للترجمة – بيروت – 2009 – ص 500.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
الشيخ مرتضى الباشا
-
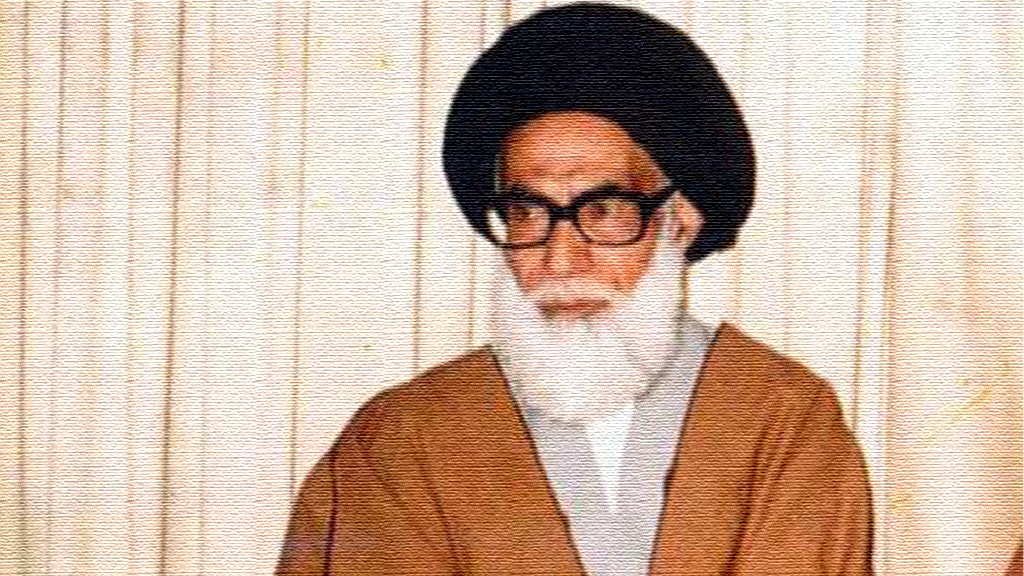 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
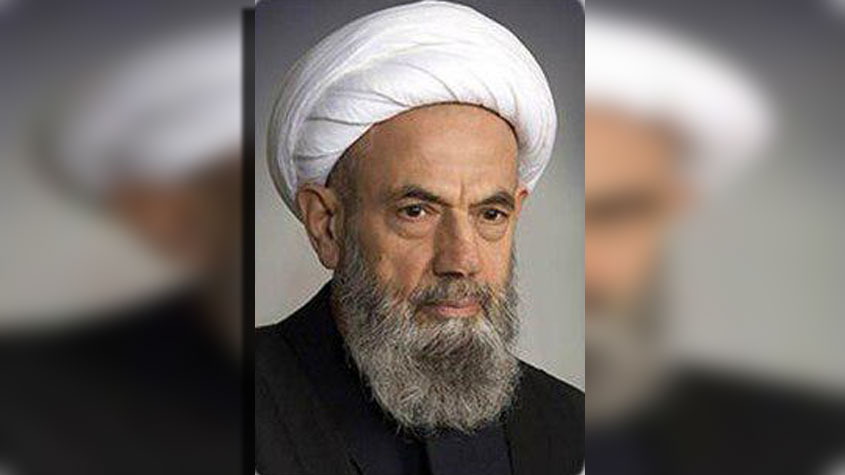 (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 الفرج سيأتي وإن طال
الفرج سيأتي وإن طال
عبدالعزيز آل زايد
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
الشهيد مرتضى مطهري
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
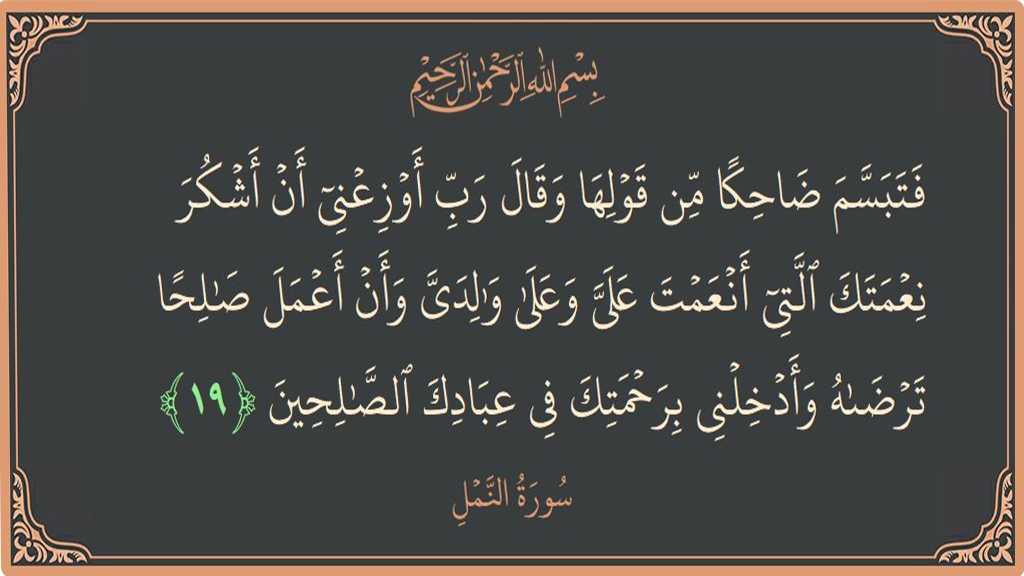
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
-
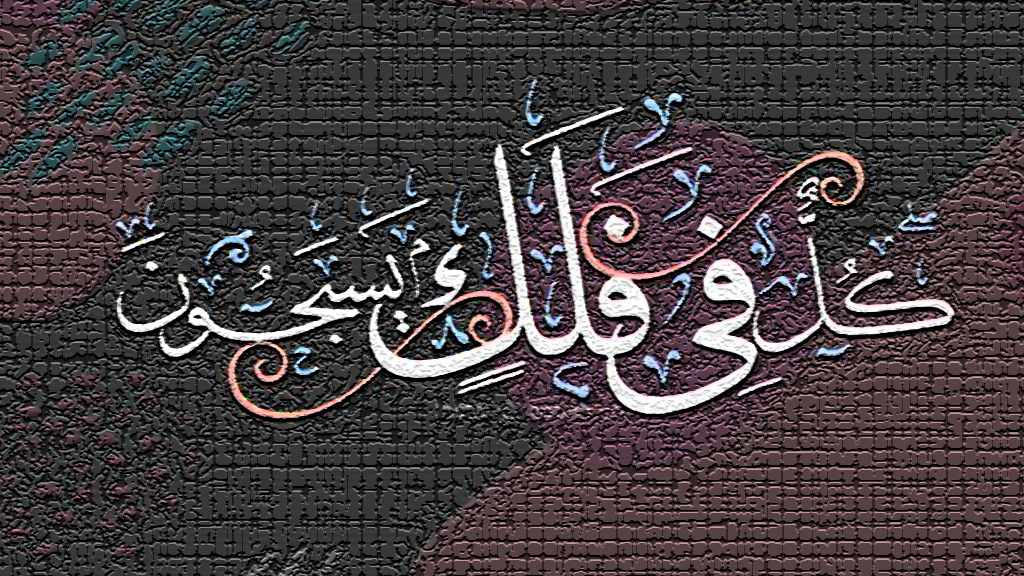
معنى (فلك) في القرآن الكريم
-
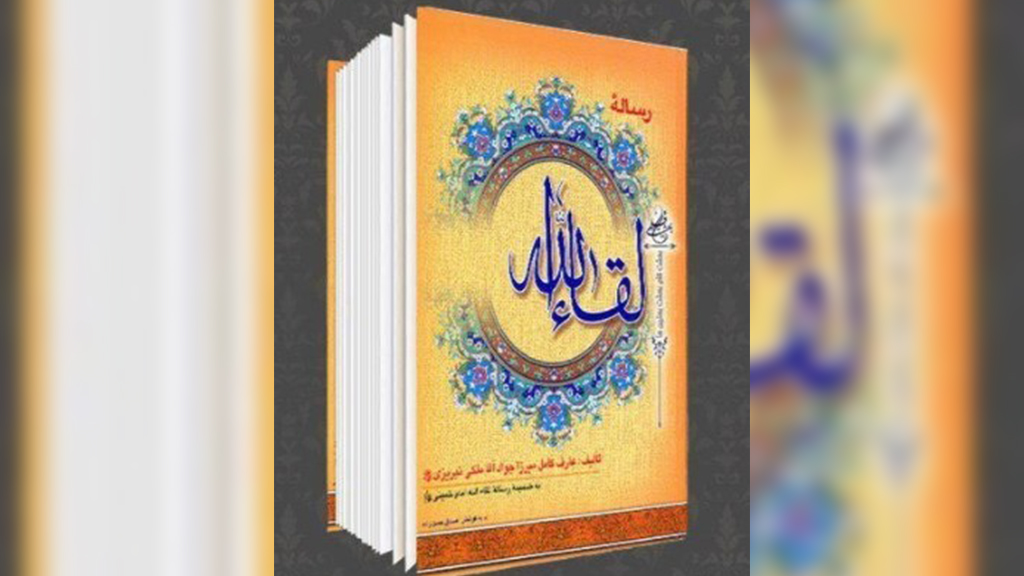
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب
-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا
-
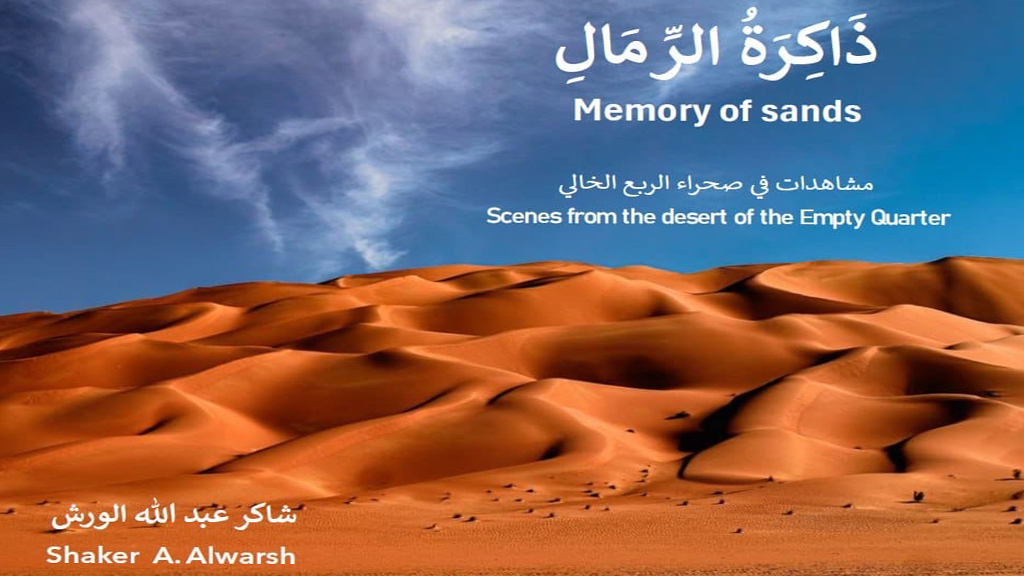
(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش
-

هذا مهم، وليس كل شيء
-
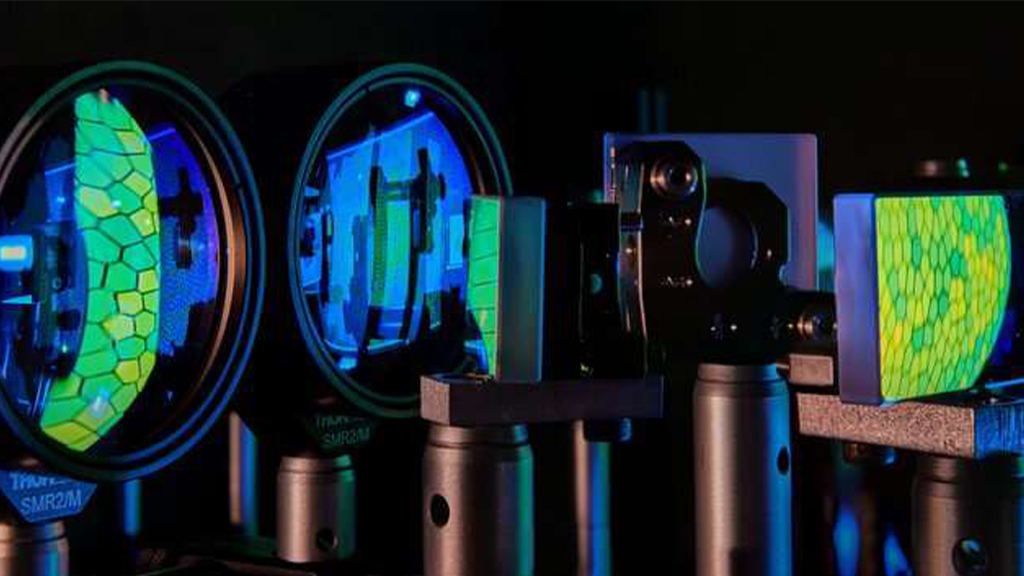
كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟










