علمٌ وفكر
الفيزياء والعقل: إشكالية العلاقة بين المجرَّد والمشخَّص (1)
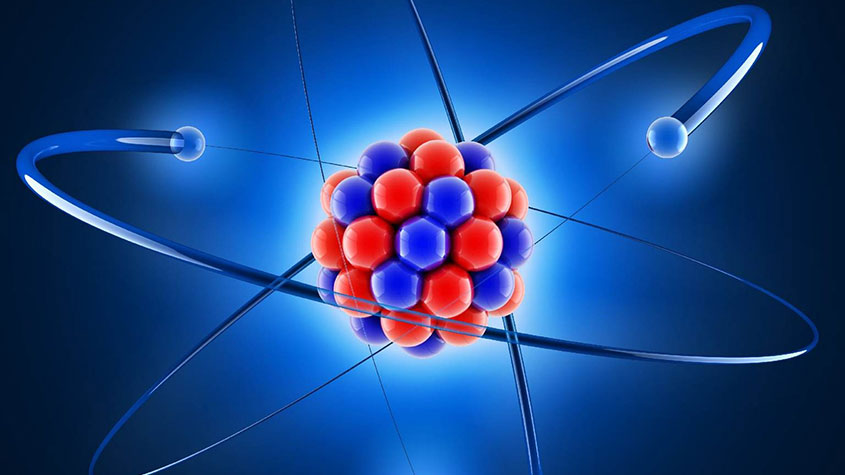
د. جاسم العلوي
تعملُ الفلسفة على إيقاظ الفكر الإنساني، وإدهاشه، عبر طرح الأسئلة الصادمة للبداهة والوضوح، والتي اعتادَ الإنسان أن يُسلِّم بإجابات جاهزة، سهلة، قدَّمتها له البيئة أو سلطات معرفية مهيمنة داخل مجتمعه، دون أن يفحصها، ومن ثمَّ يُخرجها من دائرة المفكر فيه. إذ هي -أي الفلسفة- في أغلب الأحيان مُحاولة للتفكير في اللامفكر به. إنَّها تخوض معركتها ضد عدوِّها الأساس: الخمول الفكري، المتمترس خلف جبهة عريضة من المسلَّمات في كافة الميادين. فغاية الفلسفة تحطيم هذا الجدار العالي من المسلَّمات، الذي يقبع خلفه عقلٌ أريد له -أو أراد لنفسه- أن يبقى دائمًا أسيرًا وراء هذا الجدار، وأن لا يتجاوزه. وما الفلسفة إلا محاولة لتخليص العقل من هذا الأسر وجعله حرًّا طليقا يُحلِّق في فضاء المعرفة دون قيود، يحقُّ له في هذا الفضاء أن يتساءل وأن يتأمل؛ حيث لا توجد سلطة معرفية تكبح تساؤلاته وتأملاته، وتحجر عليه كيف يفكر؟!
وعندما يتحرَّر هذا العقل، فإنَّ روح الفيلسوف تتجلَّى فيه؛ حيث يتحلى باليقظة الدائمة والدهشة، كتلك التي يتحلى بها الأطفال عندما يُبدون دهشتهم بهذا الكون، ويتساءلون عن كيف كانت البداية؟ وكيف ستكون النهاية؟ ومن أوجد هذا الكون؟ وكيف يمكن لقاؤه؟.. وأسئلة أخرى تتعلق بمعنى الحياة والموت، وأسرار هذا الكون، وهي أسئلة في ظاهرها غاية في البساطة والوضوح، لكنها عميقة، تتطلَّب أبحاثًا في الفلسفة والعلوم. يبدأ الخمول الفكري عندما يُصاب الإنسان بالرتابة، وتخبو فيه هذه الروح اليقظة المندهشة بالوجود، وبجماله، وأسراره، وذلك بفعل التكرار، وهذا من أكبر العقبات التي ينتج عنها تباطؤ الفعل المعرفي، إنها العقبة المعلوماتية كما يُسمِّيها فيلسوف العلم غاستون باشلار. وعندما يُبتلى العلماء بهذه الرتابة، وتذوي فيهم روح التساؤل والشك، ويطمئنون حدَّ اليقين لنظريات عصرهم، فإنهم يتحولون إلى عقبة تقف سدا أمام المعرفة.. يقول غاستون باشلار في كتابه “تكوين العقل العلمي”: “يُمكن لعادات فكرية كانط مجدية أن تصبح معيقة للبحث… إن الرجال العظماء مفيدون للعلم في النصف الأول من حياتهم، مضرون في النصف الثاني… ثم يأتي حين يكون فيه العقل مُحبًّا لما يؤكد معرفته أكثر مما يناقضها، ومحبًّا للأجوبة أكثر من الأسئلة. عندئذ تسود الغريزة المحافظة، ويتوقف التطور الروحاني” (1، ص:14).
وهذا يعني أنَّ العادات الفكرية تُشكِّل خطورة على المعرفة، وعلى روح العالم الذي مُهمته الوصول للحقائق. والاستسلام للعادات الفكرية، وتوظيف الأفكار توظيفًا استعماليًّا على حدِّ وصف برغسون “لعقلنا نزعة قوية لاعتبار الفكرة الأوضح هي الفكرة الأكثر استعمالا” (1، ص:14)، له آثاره المدمرة لحركة المجتمع ونهضته؛ فالمجتمع الذي تضعف فيه روح التساؤل والنقد، يضعُف فيه العقل، وتسود فيه الأفكار التي رسختها سلطات معرفية من داخله، فإن هذا المجتمع محكوم عليه بالموت والتخلف، ويقبع في أسفل سُلم الثقافة، وتعصف به العصبيات، ويعيش خارج إطار الحركة الحضارية. وبالعكس، المجتمع الذي ينشط فيه العقل المتحرِّر من أسر التقليد والبلادة الفكرية، تنشط فيه الفاعلية الروحية-التأملية، ويرفض الخضوع لسلطات معرفية تحجر عليه التفكير خارج الحدود التي وضعتها لهو، كما يشهد التاريخ مجتمعًا حيًّا ومتقدمًا ومستنيرًا.
ومما هو مُثير حقًّا، ومدهش، هذا السؤال الذي تضعنا الفلسفة أمامه، والذي تبدو قضيته في واقع الإنسان بديهيًّا وواضحًا، وغير مُفكر به، وهو: لماذا هذا الكون يقبل الإدراك العقلي؟
هذا التساؤل قد تبدو قضيته واضحة وبديهية للكثيرين من الناس، لكنه في الواقع لغزٌ كبير ومحير. إذ إنَّ هذا التساؤل يضعنا أمام مشكلة معرفية عميقة هي في إطارها العام تتمثل في العلاقة بين ما هو مجرد وبين ما هو مُشخَّص؛ فالعقل ومعقوله يُمثِّلان البعد المجرد في هذه الإشكالية، والمشخص هو هذا الواقع المادي. والسؤال في جوهره: لماذا يكون هناك تطابق بين العقل وأحكامه، وبين هذا العالم الخارجي؟ ولماذا هذه المطابقة تُثمر معرفة حقيقية ومنسجمة؟
أحد أبرز تجليات هذه الإشكالية في ميدان العلوم هو أن هذا الإدراك العقلي للكون له طبيعة رياضية، فهذه الطبيعة مكتوبة بلغة الرياضيات كما يقول جاليلو. هذه العبارة هي وصف دقيق لهذه الإشكالية التي نتحدث عنها. لأنها تتحدد بطرفين ينتميان إلى واقعيتين مختلفتين، فطرف يمثله الرياضيات الذي هو في حقيقته نشاط ذهني عالي التجريد، والطرف الآخر هذا الواقع الفيزيائي، والإشكالية هي أن الرياضيات وسيلة فعالة ومثمرة في الكشف عن الواقع الفيزيائي واستخلاص قوانينه. فلماذا تتطابق الرياضيات مع الواقع الطبيعي؟ ولماذا تذعن الطبيعة لقوانين العقل؟ إنه لأمرٌ مُدهش، ولغزٌ أبديٌّ كما يصفه آينشتاين. هناك بُعد إيماني خفي أو يتم إخفاؤه؛ وذلك عندما يتم تجاوز هذه الإشكالية أو السكوت عنها، وهذا الإيمان حقيقي وعميق عند العلماء، ويتمثل في الثقة المطلقة التي يضعونها في الرياضيات، وقدرتها على اكتشاف الواقع؛ إذ تقوم النجاحات التي تحقِّقها العلوم بهذا الإيمان الخفي أو المخفي، وهو هذا التطابق بين الرياضيات بوصفها فعالية ذهنية والواقع الطبيعي-التجريبي. فكيف ينسجم ما هو عقلي مجرد مع ما هو طبيعي مادي؟! يشير العالم الحائز على جائزة نوبل للفيزياء يوجين ويغنر، إلى هذا اللغز وجنباته الإيمانية، فيقول: “إن الفائدة العظيمة للرياضيات في العلوم الطبيعية شيء غامض ولا يوجد تفسير عقلي لها… هي مقولة الإيمان” (2، ص:61). ويعبر عالم الرياضيات الكبير روجر بينروز عن عميق العلاقة التي تربط الرياضيات بالفيزياء فيقول: “إنه من الصعب عليَّ أن أعتقد…أن النظريات الكبيرة نتجت عن انتخاب عشوائي طبيعي للأفكار، تاركة الجيدة منها. وهذه الجيدة هي ببساطة على درجة عالية من الجودة؛ بحيث لا يمكن أن تكون قد نتجت بطريقة عشوائية؛ لذلك لابد أن يكون هناك سبب عميق لهذا الاتفاق بين الرياضيات والفيزياء” (المصدر السابق، ص:61) ويقول عالم آخر، جون بولنغنور: “العلوم لا تفسر الإدراك الرياضي للعالم الفيزيائي، إنه جزء من الإيمان المؤسس للعلوم” (2، ص:61). هذه نصوص ذات أهمية خاصة، إنها تؤسس العلوم على قاعدة الإيمان، إن هذا الإيمان العميق المؤسس للعلوم يصطدم ويتناقض مع العقلانية العلمية التي تسعى لتأسيس رؤية مادية للعالم. هذه الإشكالية من ذات الطبيعة التي تُحيرنا عن معنى الحياة بأسرها، فليست العقلانية العلمية قادرة بمنهجيتها على تفكيك هذا اللغز، وتقديم معنى للحياة. النظرية العلمية بذاتها غير قادرة على الكشف على الحقيقة الطبيعية المطلقة؛ فكيف بها أن تكشف عن سر يتعالى على هذه الحقيقة، تعود بنا مثل هذه المعاني الغامضة إلى مقولة الإيمان، التي نرفع بها قلق هذه التساؤلات. جون لينكس عالم الرياضيات، يُقدِّم جوابه عن قابلية الكون للإدراك العقلي، بوصل العقل الإنساني بالعقل الإلهي غير المحدود، قابلية العقل للتطابق مع الوقع العيني إنما يمكن أن نعزوها إلى العقل الإلهي الذي خلق العالم وخلق العقل الإنساني.
نحن إذن إزاء إشكالية العلاقة بين العقل والواقع تعرف عليها علماء الفيزياء والرياضيات، بعد أن قدموا للعالم نظرياتهم الكبيرة من خلال هذا التوافق الكبير بين الرياضيات والفيزياء؛ بحيث تشكل لديهم إيمان قهري بحقيقة هذا التوافق، ولكن دون أن يقدموا تفسيرا له. لكن هذه الإشكالية تذهب بعيدا في الفكر الإنساني وقد ناقشها الفلاسفة، لكنْ لتطور العلوم الحديثة دور كبير في تأكيدها. فالنظريات الفيزيائية الحديثة هي نتاج شبكة من العلاقات الرياضية المعقدة والمتسقة مع نفسها، هي تحقيق مشخص لهذا البناء الرياضي الذي تحكم نسقه الاستدلالي روابط منطقية. يتميَّز البرهان الرياضي الحديث بأنه يقوم على مجموعة من الفروض -المبادئ الأولية- بصرف النظر عن صدقها أو كذبها في الخارج، ثم يتم تشييد نسق رياضي متماسك ومنسجم بروابط منطقية، مشدودة أطرافه بعضًا إلى بعض بصورة غاية في الاتساق، وهذا ما يعرف بالبناء الأكسيوماتيك (Axiomatique)، هذا البناء الأكسيومي تعتمده الفيزياء الحديثة في تشييد نظرياتها؛ وذلك بالانطلاق من فروض ومبادئ لم يعرف ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة، وعلى ضوئها يتم بناء نسق رياضي مُحكم، ومنه يستخلص عدد من النتائج التي يتم التأكد منها عمليًّا في مرحلة لاحقة. يقول العالم الفيزيائي بول ديفيدس: “معظم الرياضيات الناجحة والقابلة للتطبيق اشتغل عليها رياضيون بصورة تجريدية قبل فترة من مرحلة تطبيقها في الواقع” (2، ص:62). في البناء الأكسيومي المرحلة التجريدية تسبق المرحلة التطبيقية، ولا توجد علاقه بينهما قبل مرحلة التطبيق. فنظرية التناظر الأعلى supersymmetry في الفيزياء تم تأسيسها على مجموعة من المبادئ التي اختيرت بعناية من أجل تجاوز العجز في النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات. وهذه المبادئ صِيغت في فضاء رياضي يحكمه منطقه الخاص والمستقل تماما عن المعنى المشخص. صحيح أن ما يُراد من هذا النسق الاستدلالي أن نتلمَّس واقعنا الفيزيائي، لكن ذلك في مرحلة لاحقة، وبعد أن نستكمل بناءه. أما في مرحلة البناء، فنقصر النظر على مفرداته، ونعمل على وصل بعضها البعض، وفق ذلك المنطق الخاص الذي ارتضيناه واكتشفناه من عجز أصاب نظريات سابقة. وبعد استكمال البناء، نعمل على التحقق من نتائجه من خلال التجربة باعتبارها المحدد العلمي في قبول النظرية أو رفضها. ينظُر بعض الفيزيائيين لجمالية النسق الرياضي كدليل على صدق النظرية. يقول بعضهم عن نظرية التناظر الأعلى، إنها جميلة، لابد أن تكون صحيحة. ويكشف الدكتور عماد فوزي الشعيبي عن سر الترابط الوثيق بين الرياضيات والفيزياء من خلال المعنى الجمالي المتعالي لهذه الأنساق الرياضية.. فيقول: “أدخلت الفيزياء عمومًا، ومن ثم ميكانيكا الكم، طريقة جديدة في المعرفة العلمية؛ كشفت أن أغلب العلم الذي نتناوله يسترشد بالإحساس الجمالي. فالجمال هنا تعبير عن اتساق المعادلة مع المطلوب، أو الشكل البنيوي للمادة مع ما هو متناظر وجميل، والواقع أن تصور العالم الفيزيقي بوصفه جميلًا هو ما يجعل الترابط وثيقًا بين الفيزياء والرياضيات؛ إذ إن أول خاصية للرياضيات هي جمالها، وهو جمال مطمور في تناغم وانسجام القضايا، وتبعا لهنري بوانكاريه، فهي لا تمتلك الصدق فقط، وإنما تتمتع بجمال أسمى ولا يمكن حصره بكلمات. ويشكل الجمال مع التساوق والخصوبة ثلاثية تنسجم مع ما يسمى بقوانين الواقع الفيزيائي” (3، ص:355). وفي الواقع، ليس هناك من دلالة على أن جمالية النسق النسبية في مرحلة التجريد تتطابق بالضرورة مع الواقع الموضوعي.. لكن هناك شيء من الحقيقة في هذا الأمر.
تشتدُّ هذه الإشكالية وضوحًا وسطوعًا، بعد أن أكدت الفتوحات العلمية في الفيزياء الحديثة حقيقة هذا التطابق (بالطبع المقصود بالتطابق هنا النسبي وليس المطلق، لكنه حتى بنسبويته يدعو للتأمل) المذهل بين الجانب الأكسيومي التجريدي الصوري وبين الجانب التجريبي، أو ما نسميه بالواقع المشخص. لكن هذا التطابق بين الرياضيات والفيزياء هو أحد مصاديق هذه الإشكالية التي بحثت في إطارها الأوسع من قبل الفلاسفة؛ بحيث تبرز فيه هذه الإشكالية على النحو الذي عبر عنه هيجل: “كل ما هو عقلي واقعي، وكل ما هو واقعي عقلي”؛ إذ ليس هناك شيء لا يقبل التفسير العقلي، وإن كل ما يقبل التفسير العقلي فهو موجود بالضرورة (4، ص:22).
أمَّا ديكارت، فنظر إلى هذه الإشكالية بالعودة لمقولة الإيمان أيضًا، كما فعل جون لينكس. فَصَل ديكارت بين العقل والطبيعة بإرجاعهما لطبيعتين مختلفتين؛ هما: الفكر، والامتداد. وقال بوجود الأفكار الفطرية في العقل، والطبيعة عنده تخضع لقوانين صارمة، لكنها مساوقة ومتطابقة لقوانين العقل. يعُود يقين ديكارت بهذه الأفكار الفطرية بإرجاعها إلى الله الخالق الذي لا يُمكن أن يضلل الإنسان ويخدعه. وكذلك فهو يرجع هذه المساوقة بين العقل وقوانينه والطبيعة وقوانينها إلى الله؛ باعتباره خالقَ العقل والطبيعة معًا. إنَّها مقولة الإيمان التي تُعطي معنًى لهذه الإشكالية العميقة، وإلا عصف بنا الشك وعدم اليقين. إذن، هو الإيمان الذي يؤسِّس للحقيقة الطبيعية وغير الطبيعية.
تخلَّص كانط من الإشكالية ذاتها، بعد أن قرَّر استحالة هذا التطابق بين العقل وقوانينه، وبين الواقع المادي. إنَّ كانط يُقرِّر استحالة معرفة الواقع الخارجي كما هو لذاته. فكانط يميز بين الشيء لذاته كما هو موجود في الواقع الخارجي وهذا غير قابل للمعرفة، والشيء لذاتنا وهو مزيج بين الشيء لذاته والصور الفطرية التي تتَّحد معه في الذهن؛ لذلك تظل معرفتنا بالواقع نسبية؛ لأن إدراكنا لها يعكس حقائق الأشياء لذواتنا، وليست حقائق الأشياء لذاتها (5،ص:129). في الواقع أن كانط أخذ بهذه الإشكالية منحى مختلفًا تمامًا عمن سبقوه عندما اعتبر أنَّ العلوم الرياضية لا يوجد بها هذه الإثنينة، الشيء لذاته والشيء لذاتنا؛ فهذه العلوم مخلوقة للنفس؛ وبالتالي تصبح الحقائق الرياضية حقائق يقينية مطلقة. يقرِّر كانط في تحليله النهائي للمعرفة أن ليس ثمة تطابق بين العقل والواقع؛ فهذا مستحيل إنما هو تطابق العقل مع العقل نفسه. إن كانط يفكك هذه الإشكالية بالقول باستحالتها، ويحصر التطابق بين العقل والعقل نفسه، لكن ذلك ينتهي بكانط إلى المثالية حتمًا “إن كانط يعتبر القوانين المتأصلة في العقل البشري قوانين للفكر، وليست انعكاسات علمية للقوانين الموضوعية التي تتحكَّم في العالم وتسيطر عليه بصورة عامة، بل لا تعدو أن تكون مجرد روابط موجودة في العقل بالفطرة يُنظم بها إدراكاته الحسية… والانسياق مع المذهب النقدي هذا يؤدي للمثالية حتمًا؛ لأنَّ الإدراكات الأولية في العقل إذا كانت عبارة عن روابط مُعلقة تنتظر موضوعًا لتظهر فيه، فكيف يُتاح لنا أن نخرج من التصورية إلى الموضوعية؟! وكيف نستطيع أن نُثبت الواقع الموضوعي لأحاسيسنا المختلفة -أي الظواهر الطبيعية التي يعترف بموضوعيتها (كانط)؟!” (5، ص:132). منشأ هذه المثالية، كما يوضح هذا النص، هو أن إدراكاتنا الفطرية والعلوم الرياضية هي النفس؛ فمعرفتنا اليقينية ينتجها العقل نفسه. لكنَّ مثالية كانط تزول إذا ما عزونا هذه الإدراكات الفطرية والمبادئ الرياضية في العقل إلى انعكاسات لواقع موضوعي مستقل، وليست مجرد روابط تنظم إدراكاتنا الحسية.
وعلى ضَوْء ما يُقرِّره كانط من أنَّ المعرفة مطابقة العقل لنفسه، لكن لا كما يقول كانط من أن هذا التطابق مخلوق للنفس، ويشكله العقل في قوالبه الخاصة، بل باعتبار أن المعرفة نتاجَ تطبيق إدراكات فطرية ضرورية ذات واقعية موضوعية مستقلة على الواقع، وكنا قد أوضحنا فسادَ هذه الرؤية الكانطية للمعرفة بشكل مقتضب؛ لأنها كما بيَّنا عاجزة عن التدليل على الواقع الموضوعي لأحاسيسنا، فإن هذه الاشكالية تتخذ شكلًا آخر يتعلق بنحو من الوجود يختلف عن الوجود الخارجي، إنه الوجود الذهني. ومن هنا، نحن بإزاء إشكالية متفرعة من الأولى تتعلق بهذه الوجودات الذهنية. وهذه الإشكالية الفرعية تعني أن هناك وجودات ليست في عالم الواقع، وهي ذات حضور قوي للنفس تُشبه تمامًا الوجودات المادية في العالم الخارجي”. إنَّ المعاني الرياضية، وهي المقطوعة الصلة تماما عن التجربة، تفرض نفسها على الفكر كـ”كانئات” ذات “وجود” لا يقل صلابة وقوة عن وجود الجب أن ننسبها للأشياء المادية نفسها، وأن مقاوتها للفكر لا تقل عن مقاومة الأشياء المادية للجسد. هناك إذن مشكلة أخرى تطرحها مسألة العلاقة بين الرياضيات والتجربة، يُمكن التعبير عنها كما يلي: ما هو نوع “الوجود” الذي يجب أن ننسبه إلى الكائنات الرياضية؟ “(6، ص:120).
ونحن سنقف عند هذا التساؤل الأخير كما ورد في هذا النص، وهو تساؤل مُهم للغاية، نروم من خلال بحثه فهم حقيقة الكائنات الرياضية كوجودات ذهنية مستقلة عن الواقع.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (كوى) في القرآن الكريم
معنى (كوى) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 حارب الاكتئاب في حياتك
حارب الاكتئاب في حياتك
عبدالعزيز آل زايد
-
 الأقربون أوّلاً
الأقربون أوّلاً
الشيخ مرتضى الباشا
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)
محمود حيدر
-
 تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)
تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)
هادي رسول
-
 السّبّ المذموم وعواقبه
السّبّ المذموم وعواقبه
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-
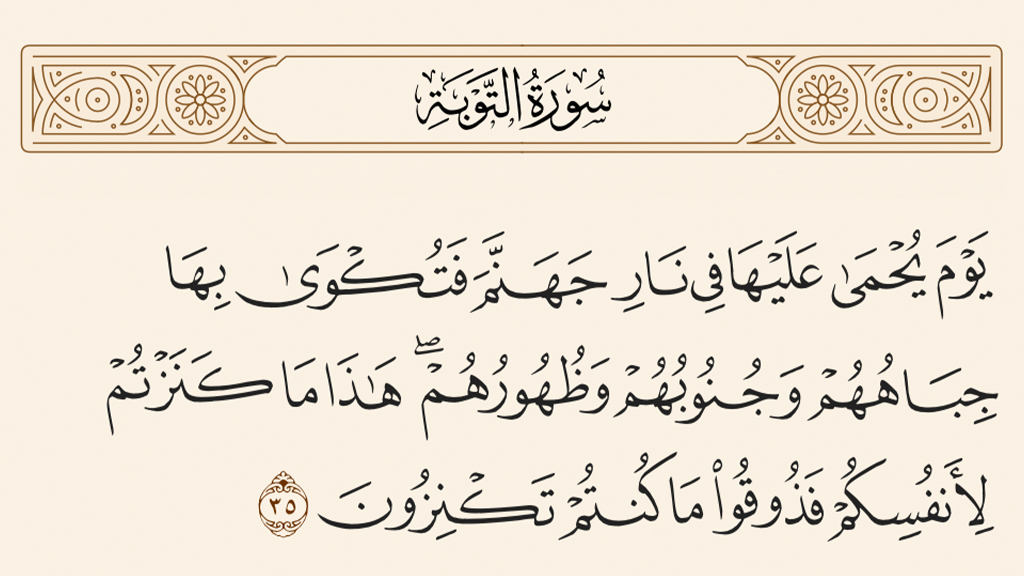
معنى (كوى) في القرآن الكريم
-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
-

حارب الاكتئاب في حياتك
-

الأقربون أوّلاً
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)
-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (بجودك أحيا) بنسختها العاشرة
-

(إيقاع القصّة) احتفاء بيوم القصّة القصيرة، وإعلان عن الفائزين بجائزة (شمس علي)
-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)
-
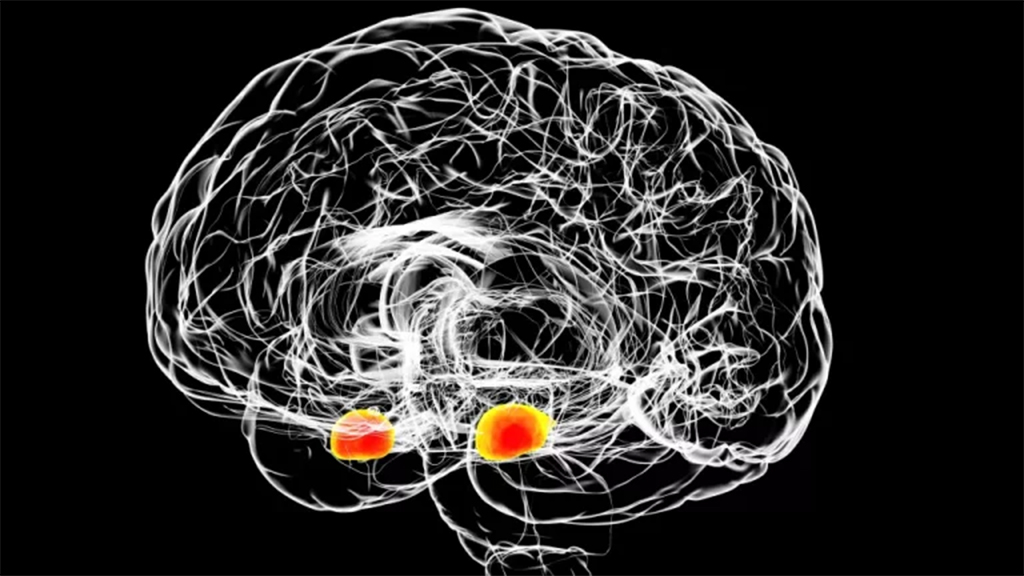
النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)









