مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ محمد مهدي شمس الدينعن الكاتب :
الشيخ محمد مهدي شمس الدين، (1936م-2001م) عالم دين ومفكر إسلامي ومحدّث، كان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. بدأ نشاطه العلمي والسياسي في مدينة النجف الأشرف ودرس عند السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي. عاد عام 1969م إلى لبنان وتولّى رئاسة الاتحاد الخيري الثقافي الذي أسس عام 1966م و باشر بنشاطات ثقافية وفكرية وتبليغية. من مؤلفاته: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مطارحات في الفكر المادّي والفكر الديني، ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، بين الجاهلية والإسلام وغير ذلك.فاجعة كربلاء في ضمير كلّ إنسان

إنّ فاجعة كربلاء قد دخلت في الضمير الإسلامي آنذاك، وانفعل بها المجتمع الإسلامي بصفة عامّة انفعالاً عميقاً. ولقد كان هذا كفيلاً بأن يبثّ في النفس ما يدفعها إلى الدفاع عن كرامتها، وأن يبعث في الروح النضالية الهامدة جذوة جديدة، وأن يرسل في الضمير الشلو هزّة تحييه...
وبالحديث عن نتائج ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) وعطائها الإنساني، هل غيّرت هذه الثورة شيئاً من مواقع المجتمع الذي انفجرت فيه؟ وهل حققت نصراً لصانعيها؟ وهل حطّمت أعداءها؟
هذه أسئلة تثور على شفتي كلّ مَنْ يقرأ أو يسمع عن ثورة من الثورات، ويتوقّف الحكم على الثورة بالنجاح أو الفشل على ما تقدّمه الوثائق من أجوبة على هذا الأسئلة، فهل كانت ثورة الحسين (عليه السّلام) ناجحة؟ أو أنّها كانت ثورة فاشلة ككثير من الثورات التي تشتعل ثمّ تنطفئ ولا تخلف وراءها إلاّ ذكريات حزينة تراود بين الحين والحين أحبّاء صرعاها؟
قد يُقال: إنّها ثورة فاشلة تماماً؛ فهي لم تحقق نصراً سياسياً آنيّاً يُطوّر الواقع الإسلامي إلى حال أحسن من الحال التي كان عليها قبل هذه الثورة.
لقد بقي المسلمون بعد الثورة كما كانوا قبلها، قطيعاً يُساق بالقوّة إلى حيث يُراد له، لا إلى حيث يُريد، ويُساس بالتجويع والإرهاب.
ولقد ازداد أعداء هذه الثورة قوّة على قوّتهم، فلم تنل منهم شيئاً، وأمّا صانعوها فقد أكلتهم نارها وشملت أعقابهم مئات من السنين؛ فحملت إليهم الموت والذلّ والتشريد والحرمان، فهي فاشلة على الصعيد الاجتماعي، وهي فاشلة على الصعيد الفردي.
ولكنّ الحقّ غير ذلك في عين الباحث البصير، فإنّ علينا لكي نفهم ثورة الحسين (عليه السّلام) أن نبحث عن أهدافها ونتائجها في غير النصر الآني الحاسم، وفي غير الاستيلاء على مقاليد الحكم والسلطان، فإنّ ما بين أيدينا من النصوص دالّ على أنّ الحسين (عليه السّلام) كان عالماً بالمصير الذي ينتظره وينتظر مَنْ معه.
قال لابن الزبير حين طلب منه إعلان الثورة في مكة: وأيم الله لو كنت في جُحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتّى يقضوا بي حاجتهم. والله ليعتدنّ عليّ كما اعتدت اليهود في السبت.
وكان يقول: والله لا يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلّط الله عليهم مَنْ يذلّهم حتّى يكونوا أذلّ من فرام المرأة.
وأجمع نصحاؤه ـ حين شاع نبأ عزمه على المسير إلى العراق ـ على أنّه فاشل حتماً في الوصول إلى نتيجة سريعة من ثورته، فقد كانت قوى المال والسلاح مُتّحدة ضدّه فكيف ينتصر؟ وفزعوا إليه ينصحونه بالمكوث في مكة أو الخروج عنها إلى غير العراق من بلاد الله؛ من هؤلاء عمر بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفيّة وعبد الله بن جعفر.
ولكنّه أبى عليهم ما أشاروا به، فقال لعبد الرحمن بن الحرث: جزاك الله خيراً يا ابن عمّ، فقد والله علمت أنّك مشيت بنصح وتكلّمت بعقل ،ومهما يقضِ الله من أمر يكن أخذتُ برأيك أو تركته، فأنت عندي أحمد مُشير وأنصح ناصح. وقال لعبد الله بن عباس: يا ابن عمّ، إنّي والله لأعلم أنّك ناصح مُشفق، ولكنّي قد أزمعت وأجمعت على المسير. وقال في موقف آخر: لأن اُقتل بمكان كذا أو كذا، أحبّ إليّ من أن تُستحلّ حرمتها بي ـ يعني الحرم ـ وقال لعبد الله بن عمر وقد نصحه بالصلح والمهادنة مع يزيد: يا أبا عبد الرحمن أما علمت أنّ من هوان الدنيا على الله أنّ رأس يحيى بن زكريّا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ اتّق الله يا أبا عبد الرحمن ولا تدعَن نصرتي.
وأجاب الفرزدق حين قال له: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أميّة: صدقت، لله الأمر والله يفعل ما يشاء وكلّ يوم ربّنا في شأن. إن نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد مَنْ كان الحقّ نيّته والتقوى سريرته.
وورد إليه كتاب عمر بن سعيد بن العاص عامل المدينة يُمنّيه في الأمان والصلة والبرّ وحسن الجوار، وأرسله إليه مع أخيه يحيى بن سعيد وعبد الله بن جعفر، فجهدا أن يرجع فلم يفعل، ومضى وهو يقول: قد غسلت يدي من الحياة، وعزمت على تنفيذ أمر الله.
وهكذا ما نزل منزلاً إلاّ ولقي مَنْ ينصحه بعدم الخروج إلى العراق، ويذكر له من أنباء أهله ما يكشف عن خذلانهم له وانكفائهم عليه، حتّى أتاه خبر قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وهو بالثعلبية، فأهاب به بعض أصحابه بالرجوع فأبى، فلمّا كان بزُبالة أتاه خبر قتل أخيه من الرضاعة عبد الله بن يقطر، فخرج حينذاك إلى مَنْ صحبه من الناس وقال: أمّا بعد فإنّه قد أتاني خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خذلنا شيعتنا، فمَنْ أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج ليس عليه منّا ذمام.
فتفرّق عنه الناس تفرّقاً، فأخذوا يميناً وشمالاً، حتّى بقي في أصحابه الذي جاؤوا معه من المدينة، وإنّما فعل ذلك لأنّه ظنّ إنّما اتّبعه الأعراب لأنّهم ظنّوا أنّه يأتي بلداً قد استقامت طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلاّ وهم يعلمون علامَ يقدمون. وقد علم أنّهم إذا بيّن لهم لم يصحبه إلاّ مَنْ يريد مواساته والموت معه.
وأجاب مَنْ نصحه بالرجوع إلى مأمنه من منزله ذاك بعد أن تبيّن له الأمر فقال له: يا عبد الله إنّه ليس يخفى عليّ أنّ الرأي ما رأيت ولكنّ الله لا يُغلب على أمره.
هذه النُذر كلّها تشير إلى أنّه كان عالماً بالمصير الذي ينتظره. وإذاً فليس لنا أن نبحث عن أهداف ثورة الحسين (عليه السّلام) ونتائجها في الاستيلاء على مقاليد الحكم والسلطان؛ لأنّه لم يستهدف من ثورته نصراً آنيّاً، ولأنّه كان مُدركاً لاستحالة الحصول على نصر آني.
وقد يبدو لنا هذا غريباً جدّاً، فكيف يسير إنسان إلى الموت مع طائفة من أخلص أصحابه طائعاً مختاراً؟ وكيف يُحارب في سبيل قضية يعلم أنّها خاسرة؟ وكيف يمكّن لعدوّه من نفسه هذا التمكين؟ هذه علامات استفهام كثيرة نبحث عن أجوبتها. والذي أعتقده هو أنّ وضع المجتمع الإسلامي إذ ذاك كان يتطلّب القيام بعمل فاجع يلهب الروح النضالية في هذا المجتمع، ويتضمّن أسمى مراتب التضحية ونكران الذات في سبيل المبدأ؛ لكي يكون مناراً لجميع الثائرين حين تلوح لهم وعورة الطريق وتضمحلّ عندهم احتمالات الفوز، وتُرجّح عندهم إمارات الفشل والخذلان.
لقد كان قادة المجتمع وعامّة أفراده إذ ذاك يقعدون عن أي عمل إيجابي لتطوير واقعهم السيِّئ بمجرد أن يلوح لهم ما قد يُعانون في سبيل ذلك من عذاب، وما قد يضطّرون إلى بذله من تضحيات. وكانوا يقعدون عن القيام بأي عمل إيجابي بمجرد أن تُحقّق لهم السلطة الحاكمة بعض المنافع القريبة.
ولم يكن هذا خُلق السادة وحدهم، بل كان خُلق عامّة الناس أيضاً؛ لذا رأينا تخاذل مجتمع بأسره عن نصر قضيته حين أوقع ابن زياد بمسلم بن عقيل، وكيف أخذت المرأة تخذّل ابنها وزوجها وأخاها، وكيف أخذ الرجل يخذّل ابنه وأخاه وأباه. لقد كان أولئك الذين قالوا للحسين (عليه السّلام): قلوبهم معك وسيوفهم عليك، صادقين في تصوير ذلك المجتمع؛ فإنّ قلوب الناس كانت معه، لأنّهم يحبّون أن يصيروا إلى حال أحسن من حالهم، ولكنّهم حين علموا أنّ ذلك موقوف على بذل تضحيات قد تصل إلى بذل الحياة، انكمشوا وسلّموا سيوفهم في خدمة الذين يدفعون لهم أجر قتالهم لهذا الذي جاء بدعوة منهم ليحرّرهم.
فحين استيقن ابن زياد أنّ الحسين (عليه السّلام) ماضٍ فيما اعتزمه، جمع الناس في مسجد الكوفة وخطبهم ومدح يزيد وأباه وذكر حسن سيرتهما وجميل أثرهما ووعد الناس بتوفير العطاء لهم وزادهم في أعطياتهم مئة مئة، وأمرهم بالاستعداد والخروج لحرب الحسين (عليه السّلام). هذا هو موقف الشعب من الحركات العامّة التي يتوقّف نجاحها على التضحيات وأمّا موقف الزعماء فقد عرفته.
وهذه صورة أخرى منها قدّمها لنا عمر بن سعد أمير الجيش الأموي؛ فلقد دار أمره بين أن يُحارب الحسين (عليه السّلام) وبين أن يفقد إمرة الرّي فاختار الأولى على الثانية.
ولقد حاوره الحسين (عليه السّلام) في كربلاء فقال له: ويلك يا ابن سعد! أما تتّقي الله الذي إليه معادك؟ أتقاتلني وأنا ابن عمّك؟ ذر هؤلاء القوم وكن معي؛ فإنّه أقرب لك إلى الله. فقال ابن سعد: أخاف أن تُهدم داري. فقال الحسين (عليه السّلام): أنا أبنيها لك. فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي. فقال الحسين (عليه السّلام): أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز. فقال: لي عيال وأخاف عليهم.
وهنا اتّضح للحسين (عليه السّلام) أنّه رجل ميّت القلب ميّت الضمير؛ فإنسان يقيس مصير مجتمعه بهذا اللون من القياس ليس إنساناً سوي التكوين النفسي فقال له الحسين (عليه السّلام): ما لك! ذبحك الله على فراشك عاجلاً، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إنّي لأرجو ألاّ تأكل من بُرّ العراق إلاّ يسيراً. فقال مستهزئاً: في الشعير كفاية.
هذا هو المجتمع الإسلامي في أيام الحسين (عليه السّلام). مجتمع مريض يُشترى ويُباع بقليل من المال وكثير من العذاب والإرهاب، وما كان من الممكن أن تُردّ إلى هذا المجتمع إنسانيته وكرامته، وما كان من الممكن أن يُنبّه إلى زيف وحقارة وجوده، وما كان من الممكن أن تُوقظ فيه روحه النضالية الهامدة، إلاّ بعمل فاجع يتضمّن أسمى آيات التضحية والكرامة والدفاع عن المبدأ والموت في سبيله وهكذا كان.
إنّ الحسين (عليه السّلام) لم يكن ذا مال ليُنافس الأمويِّين وبيدهم خزائن الأموال، ولم يكن ليتجافى عن روح الإسلام وتعاليمه فيجلب الناس إليه بالعنف والإرهاب؛ ولذا فليس من المعقول أن يطلب نصراً سياسياً آنيّاً في مجتمع لا يُحارب إلاّ في سبيل المال وبالمال أو بالقسر والإرهاب، ولكن كان في وسعه أن يقوم بعمله الذي قام به ليهزّ أعماق هذا المجتمع وليُقدّم له مثلاً أعلى طُبع في ضمائر أفراده بدم ونار.
وإذا نحن تقصّينا أسماء مَنْ قُتل مع الحسين (عليه السّلام) في كربلاء، وجدنا أصحابه ينتمون إلى معظم القبائل العربيّة، فقلّ أن توجد قبيلة عربية لم يُقتل مع الحسين (عليه السّلام) منها واحد أو اثنان.
ومن هنا يمكن القول بأنّ فاجعة كربلاء دخلت في الضمير الإسلامي آنذاك، وانفعل بها المجتمع الإسلامي بصفة عامّة انفعالاً عميقاً. ولقد كان هذا كفيلاً بأن يبعث في الروح النضالية الهامدة جذوة جديدة وأن يبعث في الضمير الشّلو هزّة تُحييه وأن يبعث في النفس ما يبعثها إلى الدّفاع عن كرامتها.
وهذه الملاحظات تجعل من المعيّن علينا ألاّ نبحث عن نتائج ثورة الحسين (عليه السّلام) فيما تعوّدناه في سائر الثورات وإنّما نلتمس نتائجها في الميادين التالية:
1 ـ تحطيم الإطار الديني الـمُزيّف الذي كان الأمويّون وأعوانهم يُحيطون به سلطانهم، وفضح الرّوح الجاهليّة التي كانت تُوجّه الحكم الأموي.
2 ـ بثّ الشعور بالإثم في نفس كلّ فرد، وهذا الشعور الذي يتحوّل إلى نقد ذاتي من الشخص لنفسه، يقوم على ضوئه موقفه من الحياة والمجتمع.
3 ـ خلق مناقبية جديدة للإنسان العربي المسلم، وفتح عيني هذا الإنسان على عوالم مضيئة باهرة.
4 ـ بعث الرّوح النضالية في الإنسان المسلم من أجل إرساء المجتمع على قواعد جديدة، ومن أجل ردّ اعتباره الإنساني إليه.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 الفرج سيأتي وإن طال
الفرج سيأتي وإن طال
عبدالعزيز آل زايد
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
الشهيد مرتضى مطهري
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
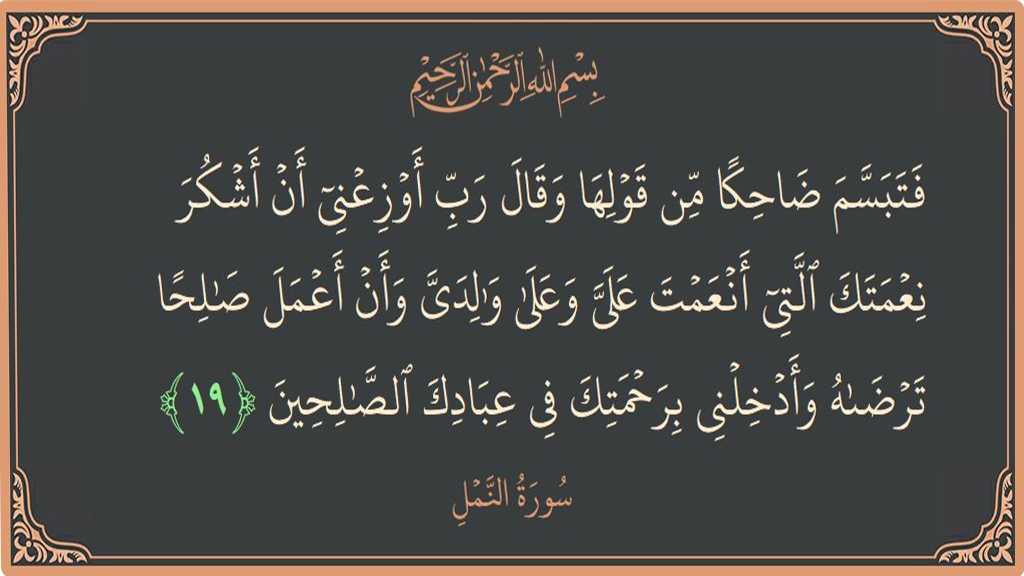
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
-

معنى (فلك) في القرآن الكريم
-
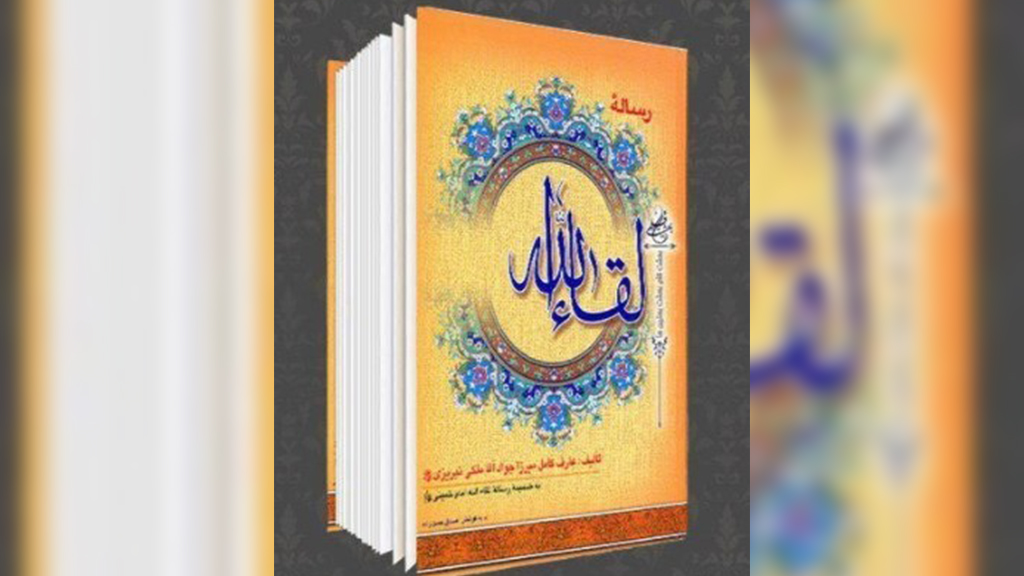
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب
-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا
-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش
-

هذا مهم، وليس كل شيء
-
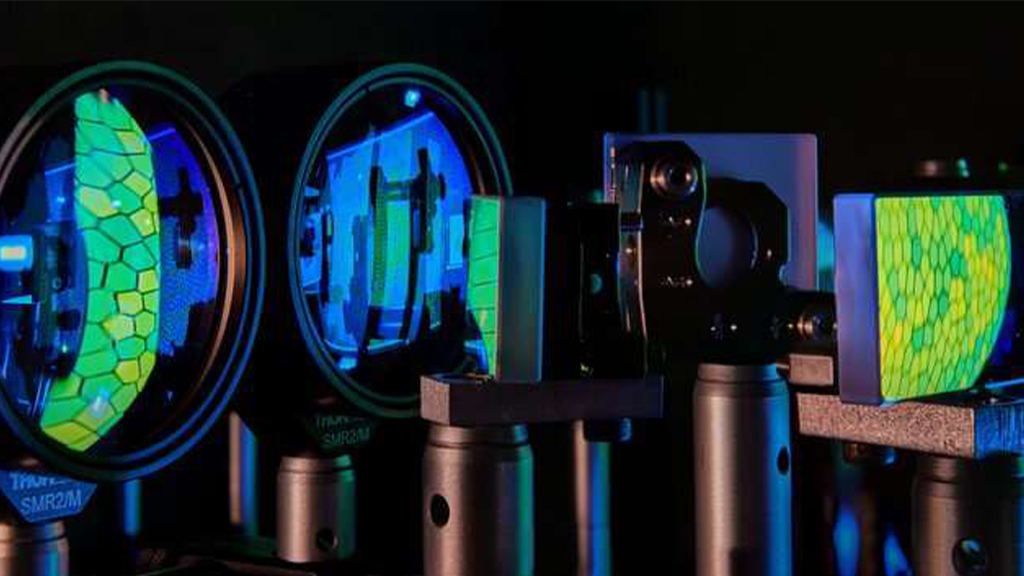
كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟










