مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.نحن والغرب، بحثًا عن روح التقدم والتفوق

كتب الكثيرون وتكلموا حول الفرق بين الشرق والغرب، ثمّ نهض الشرق الأقصى وصار في مصاف الغرب، فتركز الكلام حول الشرق الأوسط الذي يتميّز بهويته الإسلامية المتشابهة. وصار الشرق هنا عبارة عن المسلمين. أمّا الغرب فقد اتّسع ليشمل كل من يحذو حذوه في الفكر ونمط العيش. فنحن في هذه المنطقة نعاني من أسوأ أنواع التخلّف والظروف التي تجعل حياتنا شبه جحيم حيث يتم تصنيفنا على أنّنا أمم ودول فاشلة لا تأثير لها على بقية العالم، خصوصًا فيما يتعلق بالإنسانيات التي ترتبط بالكرامة والعزة والارتقاء.
إنجازات عديدة حققها بعض المسلمين المتحررين هنا وهناك، لكنّ هيمنة الغرب وتسلّطه وممارسته لأبشع أنواع التنكيل المعنوي ما زال حاضرًا في وجدان المجتمعات التي شهدت هذه الإنجازات. والكثير من هؤلاء الذين ربما يعتزون بهذه الإنجازات، لا يقدرون على تفسير هذا الفارق النوعي لمن حولهم، حيث الجاذبية والتفوق الحضاري لمصلحة الغرب بشكل بارز.
وقد بحثت وتأملت مليًّا في أسباب هذا الفارق النوعي، وغصت في دراسة تاريخ الغرب وأدبياته، شعرًا ونثرًا وفلسفةً وعلم اجتماع، فوجدت هذه الأسباب كلها مجتمعةً في نقطة واحدة ميزت الغرب عنّا قبل أن تميزه في القدرة والعلم والعمران. هذه النقطة التي أضحت سبب كل ذلك، تمثلت في الدافعية الكبرى للشعوب الأوروبية،، والتي برزت في مرحلةٍ ما قبل نهضاتها وثوراتها الصناعية والسياسية والاجتماعية والفكرية والعلمية.
لقد تميز الغرب في القرون الأخيرة بظاهرة الاندفاع المحموم للسيطرة على العالم وامتلاكه وتسخيره. وكانت كل رحلات الاكتشاف والاستيطان والاستعمار ـ التي نجم عنها نهب ثروات شعوب وقارات ـ مدينة بشكل أساسي لهذه الدوافع. وبفضلها تراكمت ثروات لا تخطر على بال، أضحت أساسًا لمشاريع كبرى في الصناعة والبحث العلمي والتكنولوجيا، وشكلت أرضية لتغييرات اجتماعية وسياسية ملفتة، وإلهامًا لتفكير ذي صبغة عالمية مستعلية.
ولهذا الاندفاع قصة بدأت حين سادت في أوروبا عقيدةٌ مزجت بين الدنيا والدين عقب الحركة البروتستانتية، التي اعتبرت أنّ من فضائل الإنسان المسيحي أن يسخر الدنيا كلها؛ وأنّ الدنيا هي ثواب الرجل الصالح، ويقع على عاتقه تطهير العالم من غير المسيحيين اللائقين بالاستفادة من خيراته. وبفعل هذه الحقيقة حصل زواجٌ مصلحي بين طلاب الدنيا وخدام الدين المسيحي، فكانت البعثات التبشيرية تسير جنبًا إلى جنب قوات الملك للسيطرة على أي أرض يمكن أن تطأها أقدام الأوروبيين. وفي ظل مباركة الكنيسة كان الجنود المخلصين يقومون بأوسع حملات الإبادة التي شهدها العالم، للسيطرة على الأراضي والكنوز والمناجم.
لم يتغير الغرب كثيرًا في هذا المجال، إلا أنّه كان يطور هذه الروح الرسالية لتتماشى مع التحولات الثقافية؛ فيومًا كان الخلاص المسيحي، ويومًا أصبح نشر الحرية، ويومًا يصبح جلب الديمقراطية للشعوب المضطهدة. وبقيت الرسالية عنصرًا جوهريًّا في حشد الطاقات وتعبئتها وتوجيهها.
إنّ تفوُّق الغرب على صعيد الدنيا هو نتاج اندفاعٍ عارم قام على تصوّرٍ عالمي حول الدور الذي يجب أن يضطلع به الإنسان الأوروبي. وقد تعزز هذا الشعور أكثر مع اكتشاف أراضٍ ومساحات شاسعة غنية بثرواتها واعدة بإمكاناتها الهائلة، وخصوصًا في العالم الجديد (أمريكا اليوم). وكأنّ الرب قد منح المبشرين والمستعمرين جائزةً سماوية تقديرًا لمساعيهم وتضحياتهم.
الفتوحات الكبيرة لمعظم مناطق العالم هي التي أدت إلى تراكم ثروات هائلة في الغرب. وسرعان ما تمركزت هذه الثروات بأيدي حفنة من العائلات المحدودة، التي لم تجد ما يمكن أن يحد من طموحاتها في السيطرة على العالم والتحكم به، خصوصًا مع توصل البشر إلى قدرات نوعية في العلم والتكنولوجيا.
لو أنّ دولة مسلمة قررت أن تبني حاملة طائرات كبيرة قادرة على أن تجوب البحار والمحيطات، فهل يمكنكم أن تتصوروا كم سيتطلب هذا المشروع من إمكانات؟
لقد عجزت روسيا بأوج اقتدارها السوفياتي عن أن تبني أكثر من حاملة واحدة. وتحتاج الصين اليوم مع تضخم ثرواتها إلى سنوات لتبني حاملتها الثانية. أمّا الولايات المتحدة الأمريكية فهي تمتلك خمس عشرة حاملة طائرات تجوب كل بحار العالم بأساطيلها وقواعدها المنتشرة في مختلف بقاعه. هذه الدولة التي استطاعت أن تنهب كل ما نهبه المستعمرون السابقون مجتمعين تقريبًا.
فما أنفقه الغرب للحفاظ على تفوقه النوعي أمرٌ يفوق الخيال؛ لكنّه حصل بفعل نهبٍ للعالم يفوق الخيال أيضًا.
لقد اندفع الغرب للنهب والسلب والاستعمار بروحٍ مفعمة بالنظر إلى المستقبل والتطلع إلى تسخير كل شيء وتغيير كل شيء؛ وكانت هذه الروحية تتشكل وتتطور على مدى الأجيال، لكنها حافظت على جوهرها ولبّها.
وفي المقابل كانت مجتمعاتنا المسلمة تغط في سُباتٍ عميق، وهي فاقدة لأي نوع من معاني الحياة الاجتماعية والروح المشتركة والتفاعل مع عناصر ثقافتها التي يمكن أن ينبثق منها روح رسالية عالمية تدفع الناس باتّجاه آفاقٍ واسعة؛ هذا، بالرغم من أنّ الثقافة الإسلامية وحتى التاريخ الإسلامي الأول كان يتضمن كل العناصر المطلوبة. وبسبب هذا الخفاء والانزواء وجدنا جمهور مفكري الحداثة العرب يفتشون عن مقومات النهوض من خارج الثقافة الإسلامية.
إن رسوخ الثقافة المسيحية لدى الأوروبيين، بفعل قوة التبشير الكنسي، كان قد شكل أرضية مناسبة لانبعاث خطاب الاستعمار والسيطرة والتفوق والهيمنة. في الوقت الذي كان العمل جاريًا على حصر الثقافة الإسلامية بالولاء للسلطان.
يذكر القرآن الكريم جماعتين أساسيتين في هذا العالم: الأولى، تندفع نحو الدنيا؛ وبحسب السنن الإلهية، فسوف تنال هذه الجماعة أو الأمّة من الدنيا شيئًا. والثانية، إذا اندفعت نحو الآخرة، فسوف يؤتيها الله هذه الآخرة. فقال عز من قائل: {مَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصيب}.[1] لكن القرآن نفسه يشير إلى جماعة ثالثة، وهي التي تعيش التذبذب: {مُذَبْذَبينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلاً}،[2] وهذا التذبذب هو الذي يفقد أي جماعة بشرية تلك الروح التي تحتاج إليها للاندفاع واجتماع الطاقات والسير باتّجاه مقصدٍ واحد، مهما كان هذا المقصد.
التخلف ينشأ من فقدان الهدف والسير نحوه؛ وإنّما حصل ذلك لأنّ المسلمين لم يتبنوا رسالة الآخرة التي يُفترض أن تتطابق مع عقائدهم وهويتهم وتنبع من الأصول التي آمنوا بها؛ وفي الوقت نفسه لم يحسموا توجههم إلى الدنيا، فصاروا مذبذبين بينهما. وأحد أسباب ذلك أنّ الفكر الإسلامي بشكلٍ عام، والذي يُفترض أن يعمل على استخراج قيم الثقافة وعناصرها ونشرها وترسيخها بين الناس، لم يكتشف العلاقة الدقيقة بين الدنيا والآخرة، فبات هو الآخر مرددًا بينهما على مدى القرون السالفة.
وفي عصرنا الحالي، بدأت الأعمال الفكرية تبشر بنقلة نوعية ترتبط بتوضيح مفهوم "الدنيا مزرعة الآخرة"، في بعديها الاجتماعي والسياسي، الأمر الذي يُعدّ منطلق النهوض المنتظر. فالدنيا بحسب هذا التفسير لم تعد عبارة عن تلك الأمور المذمومة التي يفترض بالمسلم أن يجتنبها، ولم تعد تلك الأمور الحلال التي ينبغي الاكتفاء فيها بحد الضرورة. لقد توسعت دائرة الدنيا في هذه القراءة لتشمل العالم بأرضه وسمائه، وبات المفكر المسلم قادرًا على التمييز بين الدنيا المذمومة والأرض التي يُفترض أن يصلحها ويبدلها، الدنيا التي لا ينبغي أن تكون هدفًا ولا قيمة، والأرض التي هي مهد عروجنا.
فإذا استطعنا أن نرسخ هذه المفهوم وسط الشعوب المسلمة، وذلك بربطه بأصوله العقائدية وشؤونه العبادية، فالمتوقع، انبعاث روح رسالية عالمية لم يشهد لها التاريخ من مثيل. وهذا هو أساس بناء الحضارات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]. سورة الشورى، الآية 20.
[2].سورة النساء، الآية 143.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
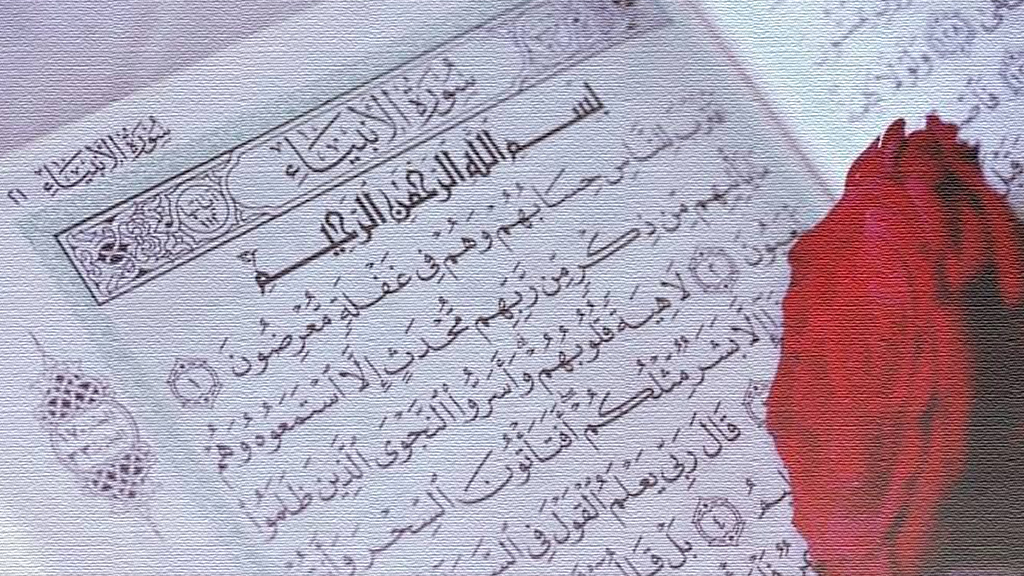
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










