علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

في خريف 1924، ألقى الفيلسوف واللاَّهوتي الألماني رودولف أوتو محاضرة في الولايات المتحدة، عنوانها: “باطنية الشرق وباطنية الغرب”[1]، وفيها كشف عن نظائر مدهشة بين سانكارا (800 قبل الميلاد)، وهو المعلم الهندي لعقيدة انعدام الثنائية، وبين ايكهارت (260-1327م) المعلم الريناني للوحدة البسيطة.
لم يشأ أوتو من مثل هذا التناظر بين معلِّمَيْن صوفيِّين ينتمي كل منهما إلى حضارة مختلفة عن الأخرى، إلا بيان الوحدة الواصلة بين التجارب الروحية في الحضارات الإنسانية. أما مغزى الأفكار التي قدمها أوتو في هذا الصدد، فهي في الكشف عن وجود بنى مماثلة في ظاهرة التصوف، بمعزل عن المواضع المكانية والفترات التاريخية. ولئن كان بعض التجارب ينزع إلى اتخاذ أشكال متقاربة في التعبير اللغوي وأشكال متقاربة في التعبير الرمزي، إلا أن هذا التماثل لا يلغي التمايز أو الاختلاف. على العكس من ذلك، فإن جوهر التصوف – كما يبين أوتو – لا يمكن أن ينبثق الا من مجموع التمايزات الممكنة”. صحيح أن التعابير المختلفة للظاهرة الصوفية تتحدد بالظروف التي تفترضها السياقات الدينية أو الثقافية المختلفة، إلا أنها تتجاوزها في الوقت نفسه.
الدارس المقارن لهذا الاختلاف والتمايز في الاختبارات الروحية، يسعى – لا سيما حين يتعلق الأمر بالتعبير الصوفي- إلى إقامة فواصل حاذقة بين النقل (الواعي) والالتقاء (العفوي). وفي الواقع، فلدى التعرض إلى النص الصوفي المتعدد، فإننا غالباً ما نخرج من طريقة المقابلة والمقارنة بنتائج مدهشة. وهو ما يمكن أن نلاحظه مثلاً، حين ننتقل من السياق الإسلامي إلى سياق آخر ينتسب إلى حضارة عميقة الغور في روحانيتها كحضارة الشرق الأقصى. نجدنا في مثل هذه الحال كما لو أننا بإزاء حوار داخلي حميم بين فضاءين مختلفين متباينين، إلا أنهما يلتقيان على جوهر واحد. وهو ما يفضي إليه التصوف كإعراب عن وحدة التجربة الروحية. أما نقطة الالتقاء في فضاء التصوف فهي تتمثل في الفضاء العربي الإسلامي بما ذهب إليه ابن عربي في “الفتوحات المكية” من أن الخلاف حقٌ حيث كان.. فقد عنى بهذا مقصوده بوحدة الوجود والشهود. فالله المتجلِّي في عوالم خلقه وحدة واختلاف، وظاهر وباطن، وأول وآخر.. وما عرِفَ الحق إلا بجمعه الأضداد.
ومن قبل أن نقوم بتمثيل مقارن يترجم وحدة التجربة الصوفية من المفيد الوقوف على مفهوم التجلِّي بوصف كونه ركناً أساسياً من أركان التصوف العملي، وأحد أبرز الأبنية المعرفية للتصوف النظري.
التجلِّي كإعراب عن جوهر التصوف
لدى السؤال عن ماهية التصوف ومعناه، تتعدد الأجوبة وتتنوع بتعدد وتنوع البنى الحضارية للجماعات الإنسانية. سوى أن الإجابات على الجملة، دأبت على الوصل بين مفهومي التصوف والتجلي بوصفهما متحداً دلالياً يفضي كل منهما إلى غاية واحدة. ولئن كانت لغة العرفاء انطوت على تباينات لا حصر لها في كيفية الإعراب عن هذا المتحد الدلالي، فقد بدت مآلات الفهم على نفس النشأة. وإذا كان لنا من تمييز في المرتبة فسنجد أن التمايز بين التصوف والتجلي كتمايز العام عن الخاص، والكلي عن الجزئي.
ولما كان التصوف بناءً واحداً ومترابطاً بين مجمل وحداته النظرية والسلوكية، جاز القول إن كل وحدة في منظومته القولية والعملية موصولة بنظيرتها ومتممة لها، كالإيمان، والإيقان، والزهد، والحب، والعشق، والود، والشهود والكشف والخفاء والتجلِّي الخ… وحين أسس أئمة الصوفية لمراتب علومهم ربطوا المراتب كلها بعروة وثقى. كل مرتبة منها تتدلَّى من نظيرتها وصولاً إلى تكامل الجميع ضمن وعاء التصوف. وحين حكم العرفاء على عالم الدنيا بأنه كون ساقط فقد أرادوا أن يفصحوا عن أن مهمة الإنسان كخليفة تجلَّت فيه إرادة الله تكمن في الصعود نحو النقطه العليا، والتطلع إلى المتسامي الإلهي للخروج من غربته واستلابه.
والحقيقة أن مقولة الكون الساقط التي أوجبت القول بالاغتراب، بسبب من عدم تجانس الروح والمادة، هي أساس الأسس في فهم الصوفية، حتى أن من العرفاء من رأى إلى تعريف التصوف بأنه “النظر إلى الكون بعين النقص”.[2] ولكن النقص الرابض في صميم الكون كبير إلى حد مريع، بل هو من الضخامة والتوغل في الأشياء بحيث حتم أن تكون مساحات الخواء شديدة الاندياح، ولولا ذلك لما كان لصوفية أن تعرف طريقها إلى الوجود. فالصوفية بهذا المعنى دفاع ضد الخواء، ومحاولة جُلّى لإيلاج الملأ في صميم العالم[3].
ومن المشتغلين بفلسفة التصوف من رأى بأن الصوفية إنما تنبثق من افتتان الإنسان بالمتعالي، أو من وَلَعِهِ بالمفارق واللاَّنهائي، وربما تفصلنا عنه مسافة سرمدية. فمن قلق الاغتراب ينبجس النداء إلى العالي، ومن زيف المعطيات أو المرئيات جاء غرام الإنسان بحقيقة تعلو فوق كل ما هو برسم الحواس. كما أن مقولة الكون الساقط كان من شأنها أن دفعت الإنسان الصوفي إلى رفض العالم، وكذلك إلى رفض القوى التاريخية والمادية التي تسود هذا العالم. فلا مبالغة في القول بأن الصوفي هو الكائن الوحيد الذي يقف حراً أمام الله وحده، ومصدر حريته أنه يرفض الكون ويطلب الحق دون سواه، حتى لكأن العالم ككون نازل في المنظور الصوفي الباطل دون أدنى لبس[4].
فإذا كان التصوف هو حركة تعرّف على موجد الوجود، فالتجلي هو مقام الوصول إلى المعرفة بظهور الألوهية في قلب العارف وشهود العارف على تجلِّي الله في العالم. أما التجلي الأعظم، وهو فناء الموجود في الواجد فقد ذهب جلّ الصوفية إلى النظر إليه كدليل على الأحدية وأصالة الوجود المحض، فيما الماهيات سوى مظاهر وأظلَّةٍ للوجود الأصيل. والكون كله حادثٌ مخلوق، وكل ما فيه من المخلوقات له بداية ونهاية، والله تعالى هو الممسك له، والحافظ عليه وجوده.
عند الصوفي الكبير محمد بن عبد الجبار النفري (ت 366هـ)، الله هو الموجود المطلق المتَّصف بالوجود الحقيقي. هو الواجب الوجود، واحدٌ في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، وأنه لا أجزاء، ولا أبعاض، وأنه غير مركب، ولا يقبل التركيب، لا كل ولا بعض، ولا صغير، ومنزهٌ عن جميع صفات الحادثات(…) وحسب النفري أن كل موجود سوى الله تعالى، إنما يوجد في زمان معين، ومكان معين، وما دام كذلك، فكل موجود سواه له أول واحد، وكل ماله وحد فإنه مخالف للقديم سبحانه، الذي لا أول له ولا آخر. ثم أن كل شيء حادث أما الله فليس حادثاً، وكل شيء متغير والله ليس متغيراً، أضف إلى ذلك، أن كل حادث مصيره الى نهاية[5]. وهكذا تكون أول علامة لشهود الأحدية عند النفري، هي خروج الصوفي عن الكائنات، ورد جميع الموجودات إلى الله تعالى، لما يستولى عليه من حقائق التوحيد، بحيث لا يشهد حركة ظاهرة أو باطنة ولا أثر، ولا يسمع خبراً، ولا يلاحظ حساً ولا زماناً ولا مكاناً. فالحق يفنيه عن الأكوان وعن نفسه، فيضمحل جمعه ومتفرقاته، وتتلاشى أحواله وأوقاته، فلا أثر ولا خبر ولا حركة ولا وارد، ليس في الوجود إلا المالك الواحد.[6]
لا تنأى المقاربات التي أجرتها أدبيات التصوف الإسلامي للتصوف ومفاهيمه عما ذهبت إليه أبحاث التصوف وعلم الاجتماع الديني المقارن في الغرب الحديث. وقد درست الباحثة الأميركية أفلين أندرهل Evelyn Undrhill التجارب الروحية في الإسلام والمسيحية والبوذية، ولاحظت أن “ما يسمّيه العالم “تصوّفاً” هو علم المطلقات… أي علم الحق الواضح بذاته، والذي لا يمكن “التفكير فيه بالعقل”…” الصوفي – حسب رؤيتها – هو من يتوق إلى معرفة ما هو مطلق، لكنه يدرك أن المطلق تتعذر معرفته من خلال استخدام العقل فقط. فالمتصوّفة لا يرون في التفكير العقلي، كقاعدة عامة، دليلاً كافياً إلى الروح، ولذلك يستعملون أنواعاً أخرى من النشاط العقلي ليقاربوا المطلق المحيّر. ولما كان لكل ثقافة نصيبها من التصوّف، ورغم اختلاف الأسماء التي أطلقت على المطلق والطرق التي يُسلك إليه من خلالها، يبقى جوهر كل ثقافة متوافقاً مع ما سبق ذكره. هكذا سنرى أن الباحث في التصوف المسيحي فيدنت يوغيس يبحث عما يسميه إدراك اتحاد الأتمان بالبراهمان من خلال ممارسات تأملية وزهدية.
إن بوذية الزن تتغيَّأ الوصول إلى الوعي الكوني من خلال تأمل صارم تزول من خلاله ثنائية التفكير كلياً وإرادياً من ذهن السالك؛ تماماً كما يسعى الصوفيون إلى اختبار “انتقال الروح” (تجربة مباشرة للمقدّس) من خلال العيش بعزلة، ومن خلال الفقر والتقوى، التي يقصد منها (تحرّر) القلب من كل ما هو غير الله” (James, 455)؛ وأما القديسون الكاثوليك فإنهم يتوجهون نحو اتحاد الروح بالله من خلال الصلاة والصوم والتأمل[7].
ماهية التصوف إذاً، تكمن في “القدرة على فهم الحقيقة المتعالية”؛ وهي قدرة كامنة في صميم النفس البشرية. تقول أندرهل: “قلّة من الناس يمرّون في الحياة من دون معرفة معنى التأثر بالشعور الصوفي” (Underhill, 73). قد يكون مشهد الشمس من قمم جبال بعيدة، أو صوت سمفونية أو معانقة حبيب مفقود من فترة طويلة، أو مشهد فقير متألم، سبباً لهذا “الشعور المتعالي الذي يتدفّق من جزء آخر من النفس ويهمس للفهم والحواس بأنهم غافلون عن شيء ما”. هذا الشعور مألوف لكثيرين، لكن ما يميّز الصوفية عن سواهم هو الانسجام الاستثنائي معه. أما بالنسبة للشخص العادي فيمكن لهذا الشعور أن يكون تثقيفياً لفترة قصيرة، ويبقى في أحسن الأحوال تتمّة لحياة سارية في ثنايا العالم الطبيعي. من جهة أخرى، وبالنسبة للصوفي، تبدو تجربة هذا الشعور مكثفة جداً، بحيث إنه عندما يحصل يبدأ بإعادة تنظيم كاملة لرؤيته العالمية وإعادة توجيه لأولوياته حول الحقيقة المتعالية التي تكشفها له التجربة. وليس من ريب أن هذه التجربة التبصّرية تتعدد مسميَّاتها في الثقافة الصوفية والعرفانية. منهم من يذهب الى تسميتها بـ “الصحوة”، ومنهم تعريفها بـ إلى “الكشف والتجلِّي”، وآخرون انبروا إلى وصفها بـ لحظة الانتقال من العدم المحض إلى الجلاء والاستنارة.
إلى هذه التوصيفات التي مرّت، ثمة من جاء بمصطلح الصحوة لكي يقارب الحد الأعلى من التعبير عن الاختبار الصوفي.
تشتمل الصحوة كمبدأ عام في فضاء التصوف على إدراك مفاجئ متبصّر لحقيقة العالم العظيمة والبديعة – أو أحياناً لوجهها الآخر، الأسى الإلهي في قلب الأشياء – التي لم تفهم من قبل. وبالتالي لا يوجد كلمات يمكن أن تصف هذا الإدراك. أما عالم المدركات الماضية في واقعه فلا يمكن أن يكون إلا ضبابياً في أحسن الأحوال[8]. إن مثل هذا التوصيف لمصطلح الصحوة يلقي الضوء على ثلاثة أوجه أساسية للاختبار الروحي: أولاً، إنها مفاجئة وقوية؛ ثانياً، تؤدي إلى ترك العلائق الدنيوية؛ وثالثاً، تثير قوة دفع شديدة نحو معرفة إضافية بما تم كشفه في التجربة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – خوسيه آنذل بالنثه – حول لغة المتصوفة وظاهرتي الالتقاء والنقل – فصلية “المعارج” – ملف خاص حول التصوف – العددان (48-49)- ربيع 2004.
[2] – أبو العلا عفيفي – التصوف – الثورة الروحية في الإسلام – دار الشعب – بيروت – بلا تاريخ – ص 49.
[3] – يوسف سامي اليوسف – مقدمة للنفري – دار الينابيع – دمشق 1997 – ص 9- 10.
[4] – المصدر نفسه – ص 14.
[5] – جمال أحمد سعيد المرزوقي- فلسفة التصوف عند محمد بن عبد الجبار النفري – دار التنوير – بيروت – 2007 – ص 194.
[6] – المصدر نفسه – ص 198- نقلاً عن كتاب النفري “المواقف والمخاطبات”.
[7] – ديفيد تشاي – هايدغر والتاوية – فصلية الاستغراب – العدد الخامس – بيروت – خريف 2016.
[8] – ديفيد تشاي – مصدر سابق.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
محمود حيدر
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)
-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة
-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
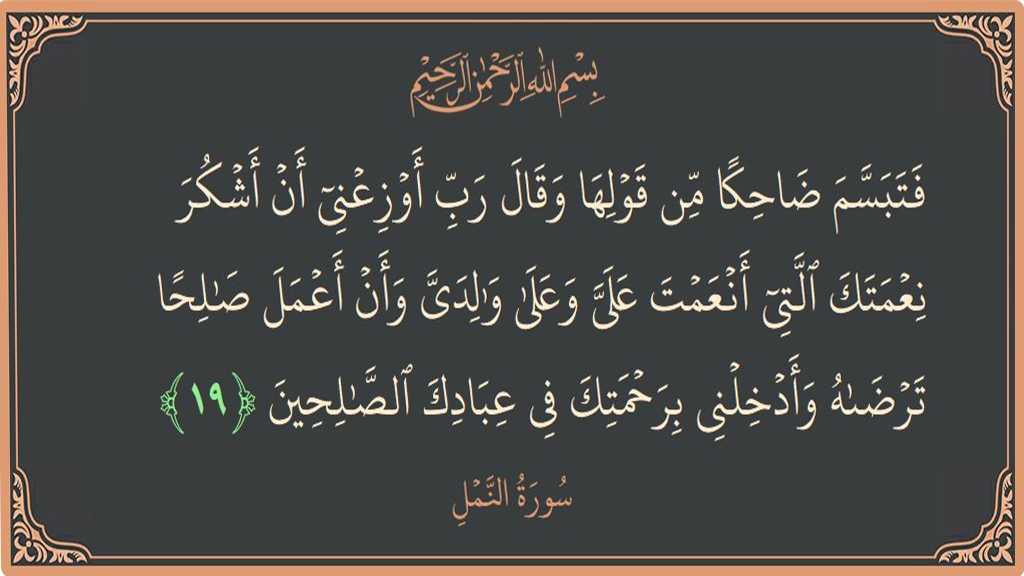
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)









