علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
حيدر حب اللهعن الكاتب :
ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...السيد محمد باقر الصدر مكوّنات المشروع الفكري الإسلامي

الشيخ حيدر حب الله ..
موقع الاجتهاد: سعى السيد محمد باقر الصدر(1400هـ) للعمل على أكثر من جبهة من جبهات الفكر الإسلاميّ:
1ـ فعلى صعيد البناءات العقلية سعى الصدر لإعادة تكوين العقل الفلسفي والمنطقي، فعمل على الكشف عن قصور المنطق الأرسطي عن تفسير الظاهرة المعرفيّة وتصويبها لوحده، وإنْ اعترف بدوره الكبير في المعرفة الإنسانيّة، لكنّه رأى فيه ـ على المستوى العمليّ ـ بنيةً عقليّة قاصرة عن إمكانيّة التوظيف لخدمة القضايا المختلفة. وقام الصدر وفقاً لذلك بتقديم مشروعه في المذهب الذاتي للمعرفة، وهو مشروع يعتمد نظريّة الاحتمال وقواعده، فيلتقي مع علم الرياضيّات، ويحاول أن يفسِّر الذهن البشريّ ونشاطاته الفكريّة على أساس مرحلتين:
إحداهما: التي تسمّى بمرحلة التوالد الموضوعي، والتي يسير الفكر فيها من المفردات والجزئيّات، فيتصاعد في القوّة الاحتمالية التي يملكها وفقاً لأصول موضوعيّة تلعب القواعد الرياضيّة دورها فيها.
وثانيهما: مرحلة التوالد الذاتي، التي يحاول فيها السيد الشهيد محمد باقر الصدر أن يصنع اليقين العلميّ بالأمور، ويعطي للاستقراء دوره المعرفيّ في مقابل التيّارات الشكّيّة والترجيحيّة. فهذه المرحلة عنده يأخذ فيها الذهن نشاطاً مستقلاًّ عن القواعد الرياضيّة الصارمة، والمعايير الموضوعية الحاسمة، لكي يقفز ـ وفقاً لبنيته الذاتيّة ـ من مرحلة إلى مرحلة.
لقد حاول الصدر أن يخوض في مشروعه هذا غمار تحليل جهاز الإدراك البشريّ، فكانت مسيرته تنطلق من نقطة الصفر، غير محمَّلة بحمولات فلسفة بعينها، ونمط تفكير مدرسة فكريّة خاصّة. وهو إذا لم يقدّم الكثير من الإضافة في المشهد العالميّ لهذا الموضوع فقد قدّم إضافات غير عاديّة عندما نقرأ تجربته في السياق الشرقيّ والإسلاميّ.
لقد ترك مشروع الصدر في المذهب الذاتيّ للمعرفة أثراً على تقارب العلم والدين، وذلّل من العقبات المنهجية والتباعد السياقي والمناخي بين هذين المجالين.
لقد كنّا نأمل أن يحظى مشروع السيّد الصدر المعرفيّ بحضوره اللائق به في المناخ الفكريّ الإسلاميّ، ولو بالنقد والتفنيد، وأن لا يظلّ بعيداً عن الدرس المنطقيّ في المؤسّسة الدينيّة، لكنّ الأقدار تقضي بما لا نريد ولا نشتهي. ونأمل من القيّمين على المناهج التعليميّة في الحوزات والمعاهد الدينيّة، ومن المشتغلين والمختصّين بالدرس العقليّ عامّة، أن يأخذوا موضوع هذا الكتاب بجدّيّة للتعرُّف على هذه التجربة المنطقيّة والفلسفيّة الفريدة في مناخنا الدينيّ؛ بهدف تطويرها أكثر فأكثر، وأن لا يبقوا أسرى مدارس فلسفيّة بعينها بوصفها في الوعي الطلابيّ العامّ حقائق لا تقبل النقد، أو إلهامات إشراقيّة لا يمكن كشف الستار عن أيّة نقطة ضعفٍ فيها؛ فإنّ هذا بعينه منطقٌ معاكسٌ للمنطق الذي يفترض أن تقوم عليه الدراسات الفلسفيّة والمنطقيّة والمعرفيّة الجادّة.
ولم يقف مشروع الصدر عند هذا القدر من الإيجابيّات، بل تعدّاه ليفتح كوّةً في جدار العقل الجزمي، عبر منح المعرفة فرصة الخطأ الواقعي، في الوقت الذي لا يُعمل بهذا الخطأ ولا يهتمّ به من الناحية العملية بحيث لا يوجب تذبذباً أو شكّاً معيقاً عن إمكانية تقدّم المعرفة البشريّة، وقد كان ذلك عبر تعديل الصدر مفهوم اليقين من البرهانيّة إلى الموضوعيّة.
ولم يقف الصدر عند مستوى تكوين النظرية ـ المشروع، بل استمرّ في ممارسة تطبيقات متعدِّدة لرؤيته المعرفيّة هذه مع علومٍ، كالفلسفة والكلام والرجال والفقه والأصول وغير ذلك.
وإلى جانب النشاط المنطقي المعرفي والفلسفي الذي اشتغل عليه الصدر كان نشاطه الكلامي في العمل على إعادة بَنْيَنَة علم الكلام الإسلاميّ، مستخدماً فيه المنهج الاستقرائي الذي يراه محمد إقبال المنهج القرآنيّ الحسّيّ في معرفة الطبيعة والوجود. وقد كان إقبال انتقد ـ قبل الصدر ـ بشدّة توجُّه المسلمين نحو العقل اليوناني، الذي حمّله مسؤوليّة تراجعهم على مستوى التطوّر العلميّ. وعبر هذا السبيل تمكّن الصدر من الاقتراب من الذهن المعاصِر في تساؤلاته الكلاميّة.
واصل الصدر مسيرته البحثيّة عبر ملاحقة المفردات الكلاميّة الإشكاليّة، ليضع لها حلولاً تفصيليّةً تتبُّعيّةً، منسجمةً مع ذهنيّته الاستقرائيّة. وهو ما جاء في بحثه حول التناقضات المتوهَّمة في سيرة أهل البيت، وموضوعة التعارض بين النصوص الحديثيّة.
وقد كان منهج الصدر في الحوار الكلامي يعتمد الهدوء والموضوعيّة في عرض الآخر ومناقشته، ممّا جعله يخرج البحث الكلامي من الدفاعيّة السجاليّة إلى الحوار العلميّ الهادف والبنّاء.
ولم يفُتْ الصدر أن يأخذ البُعد الاجتماعيّ في أصول الدين، كما في مقدّمة (فلسفتنا) وموجز أصول الدين. وهو ما أراد منه إخراج علم الكلام من التجريديّة للدخول في العملانيّة والواقعيّة.
2ـ ولو تركنا المجالات العقلية، من المنطق والفلسفة والكلام، وعطفنا نظرنا ناحية الملفّات الاجتهاديّة في العلوم الشرعيّة لرأينا كيف أنّ الصدر اهتمّ في (اقتصادنا) بفقه النظريّة.
إنّ فلسفة وجود فقه النظريّة تكمن أولاً: في الحاجة الدفاعيّة، فإنّ العقل المسلم صار بحاجة ـ لكي يبقى ـ إلى نسج رؤى متكاملة عن الحياة، استجابةً لتحدّيات مرحلة الخمسينيات والستينيات؛ لمواجهة خصوم الإسلام السياسي والاجتماعي. وهو ما صرّح به الصدر في (المدرسة القرآنيّة). فالآخر (الشيوعي) قدّم رؤى متكاملة في نظم الحياة؛ ولهذا كان (اقتصادنا).
كما تكمن ثانياً: في الحاجة البنائيّة، وهي حاجة المشروع الإسلاميّ لأساسيّات فقه النظريّة؛ لعدم كفاية الفقه الفردي والرسائل العمليّة، فأين فقه الاجتماع، وفقه الاقتصاد، وفقه السياسة، و…؟! بل إنّ الدستور الذي يُراد بناء النظام عليه هو الآخر بحاجة لفقه نظريّة ونظم. وهذا ما يحرّك عجلة الفقه من الفرديّة إلى الفقه العامّ أو يبلغ بنا التوحيد بين الفردي والعامّ.
أمّا هويّة فقه النظريّة فهي هويّة اجتهاديّة، بمعنى أنّها حقل اجتهاديّ في النصّ. لهذا هو فقه، وليس خارج الفقه أو وراء النصّ. وقد أخطأ مَنْ اعتبره اجتهاداً في مقابل النصّ. وهي أيضاً هويّة معرفيّة تبلغ مستوى التنظير. فالفكر يبدأ من الفهم، إلى النقد، إلى الإبداعات الجزئيّة، إلى تكوين نظريّات، إلى بناء مشاريع فكريّة كبرى.
أمّا الموقع العلميّ لفقه النظريّة فهو التخطّي من فقه المسائل (الأحكام)، والعبور من فقه القواعد أيضاً، ليصل إلى تكوين النظام (فقه النظريّة)، لكنّه لا يعبر الفقه المقصدي بمعناه المتداول اليوم. فالصدر ليس مقاصديّاً بالمعنى المصطلح الخاصّ، لكنّه يساعد على مقاصديّة شيعيّة.
إنّ فقه النظريّة يقوم على مبدأ الترابط، وأنّ تأثيرَ الشيء رهينُ ارتباطه بالأشياء الأُخَر. فالبنك الإسلاميّ يدرس تارةً في سياق إسلاميّ؛ وأخرى في مناخ ربويّ. وهناك ترابط خاصّ (ترابط مسائل = فقه نظرية)، وترابط عامّ (ترابط نظريّات = فقه الهيكل العام / اقتصاد + سياسة + عقيدة). وما يحتاجه فقه النظريّة هو فهمٌ اجتماعيّ للنصوص، ورفضٌ تامّ لكلّ أشكال البتر السياقي لها.
ولفقه النظريّة مراحل ومسارات يتحرّك فيها. فمبدأ الانطلاق والسير يحوي غموضاً وصعوبة في عرض النظريّة، ولا سيّما نتيجة تأثيرات الفقه الفردي، وهيمنة منطق الظنّ في المدرسة الأصوليّة. وهذا معناه أنّنا بحاجة إلى رصد القوانين لاكتشاف المذهب.
وأمّا حركة السير فتكوينها من الأسفل إلى الأعلى، أي من فقه الأحكام والمسائل؛ لتجميعها، وصولاً إلى فقه النظريّة. فنحن في البداية نكتشف التفاصيل والجزئيّات الفقهيّة ذات الصلة، وهي مرحلة معقَّدة، ثم نعمد إلى مرحلة التركيب، أو التحويل من الجزئيّ إلى الكلّي، وهي عملية تجميعٍ منظَّم للمفردات؛ لتكوين رسم فسيفسائي متكامل، لننتهي إلى مرحلة التَبْيِئَة، أو التحويل من الكلّي إلى الجزئيّ، بوضع الناتج (الكلّي) ضمن المفاصل الفكريّة العامّة (عقيدة + مفاهيم + أخلاق…)، معتبرينه جزئيّاً من ضمن كلٍّ أوسع.
ولكنّ فقه النظرية يواجه مشاكل؛ فهو من جهة يناقض منطق الاجتهاد الذي يشظّي النتائج عبر نظام التنجيز والتعذير؛ ومن جهة أخرى يعتمد ـ من وجهة نظر النقّاد ـ على الظنون والتخمينات والأقيسة والاستحسانات.
ولحلّ هاتين المشكلتين يمكن طرح (الحلّ الخارج ـ اجتهادي)، عبر ما ذكره الصدر نفسه من فتح يد الفقيه لاختيار البدائل الاجتهاديّة عبر صلاحيات وليّ الأمر، أو تقليد الميّت، وغير الأعلم.
ويمكن أيضاً طرح (الحلّ الداخل ـ اجتهادي)؛ إمّا باعتماد نظرية الشيخ شمس الدين، وهي نظرية أدلّة التشريع العليا، وقدرتها على حذف التفاصيل المعيقة لتعبيد الطريق، أو باستخدام المنحى الاستقرائي الذي أشار إلى بعضه الصدر في (المعالم الجديد للأصول)، بحيث يتأمّن لنا الخروج من الجزئيّات بقانون له قدرة الحذف لكلّ مفردةٍ تعاكِس رسم الصورة الكلّية.
3ـ وبالتحوّل من الفقه إلى الاجتماع نجد قضيّة العلاقة بين المثقَّف والفقيه ماثلةً. فالمثقَّف وعيُه تجريبيٌّ، والفقيه وعيُه نصّيّ. والمثقَّف متحرِّرٌ، والفقيه ملتزمٌ. والمثقَّف ناقدٌ، والفقيه مدافعٌ. الأمر الذي يخلق مشكلةً في العلاقة، وهي علاقة مأزومة تاريخيّاً، تتجلّى في التجربة المعتزليّة تارةً؛ وتجربة الفلاسفة أخرى. وقد ازدادت اليوم تعقيداً بعد تنامي العلوم الإنسانيّة، وانتقال المثقَّف في تموضعه من الخارج ـ ديني (ماركسي و…) إلى الداخل ـ ديني. وقد اهتمّ الصدر أكثر بالمثقَّف الخارج ـ ديني.
والخلاف بين المثقَّف والفقيه يرجع إلى إشكاليّة المنهج (حقيّة نصّيّة أم واقعيّة تجربيّة/ المرجعيّة الماضويّة وسلطان العقل)، وإشكاليّة السلطة، وإشكاليّة الاعتراف المتبادَل. وقد حاول الصدر فكّ هذا الاشتباك، عبر تثقيف الفقيه وتفقيه المثقَّف تارةً؛ وتحرير العلم والثقافة من الوضعيّة بتوحيد المنهج عبر (الأسس المنطقيّة للاستقراء)، مع تحرير الدين من الفقه من خلال انفتاح الصدر على العقليّات والقرآنيّات والسيرة تارةً أخرى، ومبدأ المشاركة من قبل الفريقين في الإدارة الاجتماعيّة عبر تجربة الحركة الإسلاميّة التي تولاّها الصدر في العراق ثالثةً.
4ـ ويبقى ملفّ إصلاح الحوزة والمرجعيّة الدينيّة. فقد رأى السيد الصدر ـ على صعيد المشكلة الخارجيّة ـ غياباً سياسيّاً واجتماعيّاً (فقدان التواصل) في الحوزة العلميّة، وغياباً للوعي الواقعيّ عبر التعاطي مع الأمور بالذهنيّة الأصوليّة الهندسيّة.
كما رأى ـ على الصعيد الداخلي ـ أزمة برامج التعليم، والأزمة الماليّة، وأزمة الحاشية، و…
أمّا على صعيد المشكلة الأولى فقد حاول الصدر حلّها عبر الحضور السياسيّ والاجتماعيّ، من خلال المساهمة في تأسيس الحركة الإسلاميّة، ومواكبة حركة الإمام الخمينيّ، إلى جانب الحضور في مواجهة الماركسيّة، وتنشيط موضوع الوكلاء، واختيار الشباب الحاضر منهم.
وأمّا على صعيد المشكلة الثانية فقد عمل على وضع برامج تعليميّة، بعد نقد القديم، ككتابه (دروس في علم الأصول)، معلِناً مشروع المرجعيّة الرشيدة القائمة على: المجالس الاستشاريّة، ومجالس الخبراء، والتنظيم الماليّ الدقيق، وكفّ يد العلماء عن الأخذ من الناس، وتأمين حياتهم من جانب المرجعيّة.
وهكذا أراد السيد الصدر تحقيق ارتباط المرجعيّة المباشر بالمشروع السياسيّ الإسلاميّ؛ ليأخذ شرعيّته منها.
وقد كان وضع آماله ببعض المراجع الكبار ليعدل بعد ذلك فيطرح مرجعيّة نفسه.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 (التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
عدنان الحاجي
-
 معنى (ملأ) في القرآن الكريم
معنى (ملأ) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 سيّدة الكساء
سيّدة الكساء
الشيخ شفيق جرادي
-
 المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (1)
المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (1)
إيمان شمس الدين
-
 الموعظة بالتاريخ
الموعظة بالتاريخ
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
 كلام عن إصابة العين (1)
كلام عن إصابة العين (1)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
محمود حيدر
-
 مجلس أخلاق
مجلس أخلاق
الشيخ حسين مظاهري
-
 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 الزهراء: مناجاة على بساط الشّوق
الزهراء: مناجاة على بساط الشّوق
حسين حسن آل جامع
-
 الصّاعدون كثيرًا
الصّاعدون كثيرًا
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
-

معنى (ملأ) في القرآن الكريم
-

برونزيّة للحبارة في مهرجان (فري كارتونز ويب) في الصّين
-
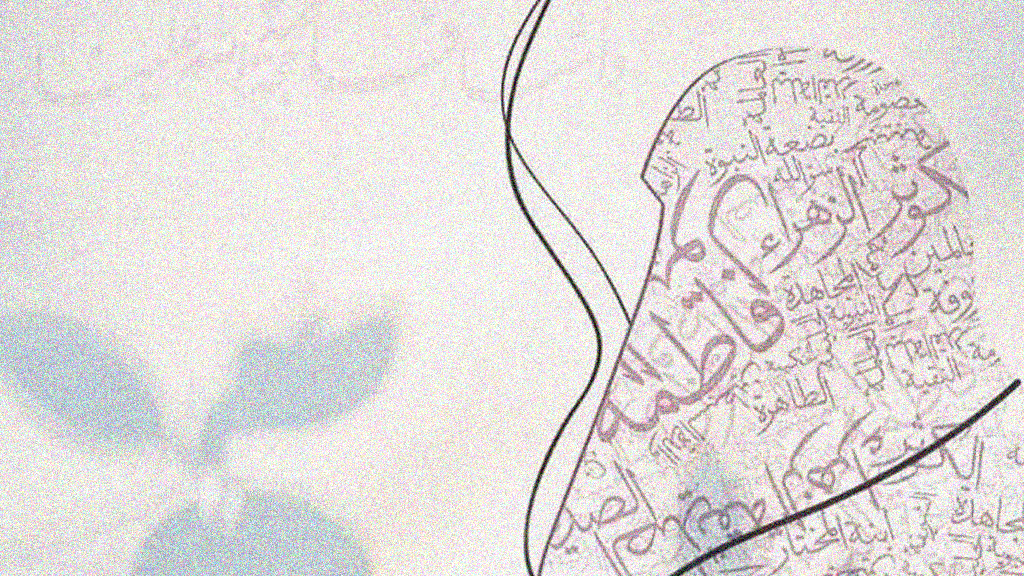
الزهراء: مناجاة على بساط الشّوق
-

سيّدة الكساء
-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (1)
-

شعراء خيمة المتنبّي في الأحساء في ضيافة صالون قبس في القاهرة
-

(الثّقافة للشّباب) جديد الكاتب مهدي جعفر صليل
-

العدد الأربعون من مجلّة الاستغراب
-
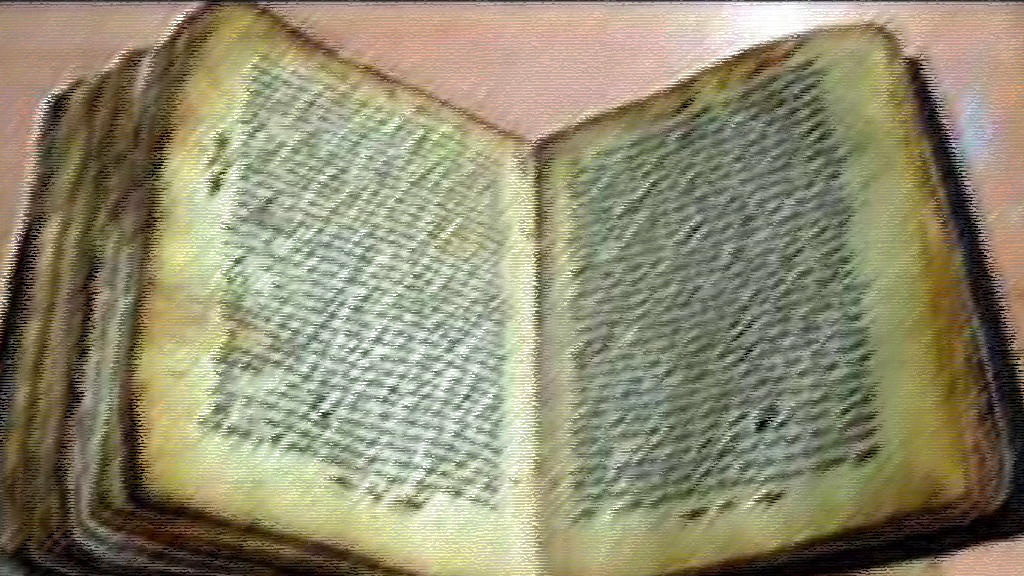
الموعظة بالتاريخ










