علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
حيدر حب اللهعن الكاتب :
ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...الدين في عصر الفردانيّة واللامنطقيّة (1)

حيدر حب الله
الغوص في الذات والأنا، أسبابٌ ومبرّرات
يشعر الكثيرون اليوم باندفاع الإنسان نحو ميوله الباطنيّة وذاتيّاته ورغباته، وينظر الإيمان الديني إلى هذه الظاهرة الآخذة في الاتساع بالكثير من القلق؛ لأنّه يعتبر أنّ الذاتيّة الدنيويّة تقف على النقيض من الإيمان بالمتعالي.
والسؤال الأوّل الذي يواجهنا ونحن ندرس هذه الظاهرة: لماذا اتّجه الإنسان أكثر فأكثر نحو ذاته الداخليّة، مبتعداً عن المعايير الخارجيّة، بما فيها معيار أعلى يسمّى بـ (الله)؟ ولماذا بات يلجأ إلى خلق كلّ شيء من ذاته الفرديّة، وجعلها محور كلّ شيء، ورفض أن تصبح هذه الذات تابعةً لأحد، أو لمعايير خارجة عنها، مهما كانت، سواء كانت هي الأسرة أم المجتمع أم الدين أم غير ذلك؟
ثمّة أسبابٌ عديدة لذلك، يمكننا أن نطلّ على بعضها:
1ـ إحساس الإنسان عبر التجربة التاريخيّة أنّه تعرَّض لظلمٍ باسم المعايير الخارجيّة الموضوعيّة. فالظلم باسم الله أو الأيديولوجيا أو القضايا الشريفة المطلقة كان أكبر ممّا يمكن للفرد الإنساني أن يتحمّله عبر تاريخ القرون الماضيّة، لهذا بدأ الشعور بالرغبة في الانتماء إلى محورٍ آخر، يمكنه أن يحرِّر الإنسان ويخلِّصه من هذا الظلم، فلم يجِدْ سوى ذاته ملجأً يثق به، ويطمئنّ إليه. وبهذا نفسِّر هروبه من الخارج إلى الداخل.
2ـ انهيار عناصر الاتصال بين الذات الداخليّة الفرديّة والموضوع أو المحيط الخارجي. هذا الانهيار له قصّةٌ طويلة في تاريخ الفلسفة والعلوم. فمنذ عصر النهضة بدأت العلاقة بين الذات والخارج (الموضوع ـ المحيط) تتدهور، وازداد الشكّ بإمكانيّة بناء علاقة موثوقة من هذا النوع. لقد كانت المفاجآت في مجال المعرفة والعلوم كبيرة، دفعت الإنسان للشكّ في أن يكون لديه طريقٌ لمعرفة الواقع الخارجي، وبناء علاقة معه. فكلّ تاريخ هذه المعرفة تعرّض هذه المرّة لهزّةٍ عنيفة.
لقد حاول الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت(1650م) أن يرمِّم الانهيار النفسي الذي حصل نتيحة تلاشي ما كان يُعتبر حقائق عن العالم الخارجي مع طبيعيّات أرسطو وفلكيّات بطلميوس. لكنّ معاول ديفيد هيوم(1776م)، ثمّ عمانوئيل كانط(1804م)، وصولاً إلى ما بعد الحداثة، أفقدت الإنسان الثقة بأنّ لديه سبيلاً يمكنه أن يربطه بالخارج المحيط، فلم يعُدْ يملك علاقةً وطيدة سوى بذاته. وهذه المرّة تعني الذات تلك الذات الفرديّة الخالصة فحَسْب، فالإنسان الكلّي الذي كان يتحدَّث عنه هيجل(1831م) بدأ بالتلاشي لصالح الإنسان الفرد؛ فالأنظمة الفلسفيّة الكلِّية تغيِّب الأفراد. وبقوّة نفوذ المدرسة الوجوديّة (Existentialism) في الغرب زاد الاعتقاد بأنّ الإنسان الفرد هو مَنْ يمكنه أن يصنع وجوده وهويّته باختياره.. هذه الرغبة الوجوديّة بالاختيار هي رغبةٌ مقابل القوانين الصارمة للاجتماع والسياسة والدين والأيديولوجيا، والتي تعيد تشكيل الإنسان بواسطة مقاييس خارجة عنه، بوصفه فرداً يتلقّاها صيغاً ناجزة، وأنّ عليه أن يتماهى معها. فالدين يتحدّث عن الإنسان الكامل الذي علينا أن نقترب من تمثُّله في الحياة، بينما الوجوديّة والليبراليّة هذه المرّة تلغي التنميط، وترفض الأنماط، وتبطل الصور الأنموذجيّة، وتدعو لاحترام تغاير الأفراد، وإنهاء عصر استنساخ النوع في الأفراد، كما يقول المفكِّر الليبرالي أشعيا برلين(1997م).
وبظهور الفلسفة النفعيّة الذرائعيّة الأداتيّة البراغماتيّة في بدايات القرن العشرين، حصل تحوُّل مهمّ، فهذه الفلسفة التي طرحها وليام جيمس(1910م) وجون ديوي(1952م) صارت ترى أنّ الفكر منذ عصر اليونان قد أضاع وقته بتتبُّع حقائق الأشياء، فيما الفلسفة الحقيقيّة هي التي تجعل الإنسان يتّخذ معرفته وسيلةً لتحقيق غايات يصل إليها عمليّاً. فالمعرفة أداة ووسيلة، وليست غاية، إنّما غايتها العمل والتجربة. فالفلسفة الذرائعيّة فلسفةٌ عمليّة تهدف إلى توظيف الدرس الفلسفي والعلمي في الحياة العمليّة، وإخراجهما من أُفق التنظير المتعالي. وهي بهذا تجعل كلّ المعلومات والأفكار والنظريات مجرَّد خطط عمل للوصول إلى نتائج ملموسة في الحياة. ولهذا السبب لا يهتمّ الذرائعيون البراغماتيّون لمدى كشف المعلومات أو الفكر عن الواقع، بل يهتمّون لقدرة الأفكار على خدمة الإنسان عمليّاً، سواء كانت مصيبة للواقع أم لا.
وبهذا صار العلم الذي فقدنا الثقة بقدرته على كشف الواقع مجرَّد وسيلة لخدمة الذات؛ فإذا خدمها فهو صحيحٌ؛ وإلاّ فلا قيمة له؛ لأنّه لا يمكنه أن يعرِّفنا الواقعَ بشكلٍ موثوق.
وحتّى أولئك الوجوديّين الإيمانيّين، وعلى رأسهم سورين كيركجارد (1855م)، أطلقوا الإيمان القائم على المخاطرة النفسيّة. لقد برهن كيركجارد على ضرورة بداية رحلة الإيمان من الذات، لتنتهي بالذات، عبر نقضه في براهينه الثلاثة المعروفة جدوائيّة الاعتماد على العلوم في إثبات الحقيقة المطلقة، ولا سيَّما التاريخ، الذي يملك مكانةً رفيعة في الأديان الإبراهيميّة. وهذه الحقيقة المطلقة هي الله أو النبوّة أو الصليب والفداء. ولهذا فضَّل أن يجعل الإيمان ساحةً أعلى من الأخلاق والقانون والقِيَم والحسّانية المؤمنة باللذّة، إنّها ساحة قفزة معنويّة روحية يتَّخذها الإنسان في أعماقه بقرارٍ شخصيّ منه، لا بضغط المنطق الذي تقدِّمه له الفلسفة والعلوم؛ فهذه العلوم قد أفقدت كيركجارد إمكان إثبات الأديان التاريخيّة.
إذن نحن هنا أمام فقدان ثقة بالعلم والمعرفة والفلسفة والميتافيزيقا، لصالح الثقة بالذات والمنفعة والمصلحة العمليّة. فالعلم له أُبَّهته اليوم؛ لأنّه يحقِّق مصالح الفرد، تلك المصالح التي تجعله يحيا سعيداً بالمفهوم الخاصّ للسعادة هذه المرّة، وهي السعادة المبنيّة على اللذّة، أو ما يُعْرَف بأخلاق اللذّة.
3ـ وقائع الحربين العالميّتين في القرن العشرين، وما أفرزتاه من شعور الإنسان بالفراغ المطلق، وانهيار كلّ الجدران التي كان يمكنه أن يحتمي بها أو يلجأ إليها. إنّ انشغال الإنسان بعد الحربين بنفسه؛ للخلاص من الجحيم الذي نزل به، عزَّز عنده أكثر فأكثر اقترابه من ذاته. لقد تداول اللاهوت اليهودي بعد الحرب العالميّة الثانية سؤال: أين هو الله الذي أخرجنا مع موسى عبر البحر؟ لو كان موجوداً بالفعل لفعل شيئاً لنا في هذا الزمان؟ كان وَقْعُ هذا السؤال على العقل الديني اليهودي والمسيحي معاً كبيراً جدّاً، لقد تحوَّل الله إلى صورةٍ جامدة غير متعاطفة مع الإنسان، وهو يراه مسفوك الدم متهاوياً في لعنةٍ أبديّة.
حتّى الله صار غير موثوق به؛ لأنّ خدماته مع البشر لم تمكِّنهم من تسكين آلامهم، بل غدا جافّاً في علاقاته معهم. ولهذا ازداد شعور الإنسان الفرد بأنّه ليس له في هذا العالم إلاّ ذاته الخاصّة، وأنّه لا يرجو أن يعينه أحدٌ في تسكين آلام هذه الذات إلاّ نفسه. فهذه الذات المتألّمة بات من حقِّها أن تنطلق وتتحرَّر من كلّ قيود المحيط، لتعبِّر عن نفسها بأيّ وسيلةٍ ممكنة. فكلّ تلك القيود والاعتبارات الدينية والاجتماعيّة والعرقية والقوميّة لم تجرّ على هذه الذات سوى الآلام، فعليها إزالة الألم بالانطلاق نحو تحقيق كلّ رغبةٍ، ليبدأ عصر الإحساس والعاطفة واللذّة والهوى والأنا الفرديّة المختارة في تشكيل ذاتها، وحتى هويّتها الجندريّة. وكأنّي بالإنسان شعر بأنّه يحتاج لفترة راحةٍ واستجمام تحرِّره من كلّ التزاماته.
لا أريد الآن أن أتكلَّم عن هل أنّ الدين ـ بوجوده التاريخي ـ كان سبباً في جرّ الإنسان نحو الفرار إلى داخل ذاته وملذّاته، أو أنّ ما أوصل الإنسان الحديث إلى ذلك هو بعض قِيَم عصر الأنوار والحداثة نفسها، وتنامي الداروينيّة الاجتماعيّة، التي يعتبر بعضهم أنّ لها دَوْراً عميقاً في الحرب العالميّة الثانية، ولو بمساعدة أفكار مثل: الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه(1900م)، بتركيزها على أخلاق السادة وأخلاق العبيد، وعلى الجنس الأفضل الذي يلزمه البقاء؛ لأنّه الأقوى وفقاً لقانون تنازع البقاء واختيار الأصلح.
خيارات الدين في مواجهة الواقع/المشكلة
إنّ البحث عمّا هو السبب في وصول الإنسان إلى هذه المرحلة هو بحثٌ تاريخي نفسي اجتماعي معمّق. وهو ـ رغم ضرورته ـ يخوض في الأسباب، فيبتعد عن العلاجات شيئاً ما. لكنْ ما أريد أن أسلِّط الضوء عليه هنا هو: كيف يمكن للدين اليوم أن يساهم في حلّ هذه المشكلة القائمة، ويرفع سوء التفاهم؟ ومن الطبيعي أنّني أفترضها مشكلةً، رغم أنّني لم أقُمْ بالبرهنة على ذلك، لكنّني سأعتبر هذا الأمر حالياً أصلاً موضوعاً مفروضاً؛ لأبني على الشيء مقتضاه.
في هذا الزمان، وضمن هذا السياق، يجب أن نعرف أنّ كل دينٍ يقدّم على شكل قوانين أو معايير خارجيّة صارمة تفرض ذاتها على الإنسان؛ ليشكّل هويّته من خلالها.. وكلّ دين يقدّم على أنّه سلطة مخارجة للذات الفرديّة، فهو على خصامٍ ـ شئنا أم أبينا، ومهما كان السبب، وعلى مَنْ تقع المسؤوليّة ـ مع الإنسان المعاصر في نزعته الفرديّة الرغبويّة. هذه في تقديري حقيقةٌ موضوعيّة قائمة، سواء أحببناها أم لا. ومن ثَمَّ لكي يلعب الدين دَوْراً اليوم يُفتَرَض تغييرُ قواعد اللعبة.
كثيرون اليوم يتكلَّمون عن استحالة الدين في العصر الحديث. فالله قد اختفى وذهبت شمسه خلف السحاب، على حدّ تعبير الفيلسوف الديني مارتين بوبر(1965م). ونحن نعيش اليوم في مدار الإنسان بعد قرون من العيش في مدار الله. فهل يمكن تخطّي الدين في هذا العصر لسؤال الإمكان في ظلّ هذا الوضع؟
لستُ أريد هنا أن أفكِّر ذرائعياً وبراغماتياً؛ فلست أريد أن أطوِّع الدين بالطريقة التي أتمكَّن من خلالها من الحفاظ عليه؛ فهناك صراعٌ طويل بين ثنائية القوّة والبقاء من جهةٍ والخلوص والصفاء من جهةٍ أخرى. فكثيراً ما نذهب نحو الحفاظ على قوّة الدين وبقائه على حساب خلوصه وصفائه؛ وفي المقابل كثيراً ما نضحّي ببقاء الدين وقوّته في الحياة؛ حمايةً لصفائه وعدم تغييره بفعل ضغط الواقع. هذا الصراع بين البقاء والصفاء ليس سهلاً على أيّ باحثٍ اليوم، وخاصّة في الغرب. لكنّني سأحاول أن أفكِّر بعيداً عن ضغط هذه الثنائيّة، آملاً أن أوفَّق لذلك بعونٍ منه سبحانه.
كيف يتمّ تحريف رسالة الدين؟
سأقتصر هنا على نقطةٍ من نقاط الحلّ في ظنّي المتواضع؛ نظراً لما يسمح به المجال. وسأشرع من مقولةٍ يذهب إليها الكثير من الباحثين في مجال تاريخ الأديان. فالأديان تتعرّض للتحريف ليس عبر حذف بعض مفاهيمها منها، أو إقحام مفاهيم غريبة عنها فيها بالضرورة، بل أحياناً أنت لا تقوم بإقحام أيّ مفهومٍ جديد، ولا تُحْدِث أيّ نقصٍ، بل التحريف ـ وهو الأخطر في تقديري ـ يقع عبر تغيير موقع الأحجار الصغيرة التي يتشكَّل منها الدين. فلو كان عندي لوحةٌ فنيّة فسيفسائيّة رائعة، صُنِعَت من أحجارها الصغيرة، فإنّ تحريف صورة اللوحة لا يكون بالضرورة عبر إخراج بعض أحجارها الصغيرة، والإتيان بأحجار أخرى، بل يكون عبر تغيير موضع بعض الأحجار نفسها… إنّ الصورة سوف تتعرَّض للتهشيم نتيجة ذلك.
عندما تتعرَّض الأديان لمثل ذلك فهذا ما نسمِّيه: إعادة مَوْضَعَة القضايا الدينيّة، ومن ثمّ إعادة رسم الأولويّات، وتغيير شكل الهرم. فالمسألة البسيطة في الدين، والتي تمثِّل فرعاً لغصنٍ فيه تتحوَّل إلى جَذْرٍ من جذوره، وأصلٍ من أصوله، وبالعكس تماماً، تتحوَّل أكبر وأهمّ جذوره إلى قضايا فرعية مهمَّشة، أو تُساوى بغيرها. إنّ هذه العمليّة تصنع ديناً جديداً بمعنى من المعاني، أو تكون بنفسها سبباً في ولادة مذاهب متعدِّدة داخل الدين الواحد.
مداخل لمعالجات أوّلية
بناءً على ذلك، أعتقد ـ وأنا أتكلَّم حالياً عن الإسلام بصفةٍ خاصّة ـ أنّ بعض الخطوات يمكن أن تساعدنا في إدارة الوضع القائم. ولستُ ممَّنْ يدَّعي أنّ هناك حلولاً نهائيّة لمشكلاتٍ عميقة من هذا النوع، بل هي محاولاتٌ لإدارة المشكلة على الأقلّ.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 شتّان بين المؤمن والكافر
شتّان بين المؤمن والكافر
الشيخ جعفر السبحاني
-
 معنى (عول) في القرآن الكريم
معنى (عول) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
الشيخ شفيق جرادي
-
 المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
إيمان شمس الدين
-
 (التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
عدنان الحاجي
-
 الموعظة بالتاريخ
الموعظة بالتاريخ
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
 كلام عن إصابة العين (1)
كلام عن إصابة العين (1)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
محمود حيدر
-
 مجلس أخلاق
مجلس أخلاق
الشيخ حسين مظاهري
الشعراء
-
 السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
حسين حسن آل جامع
-
 الصّاعدون كثيرًا
الصّاعدون كثيرًا
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

لـمّا استراح النّدى
-
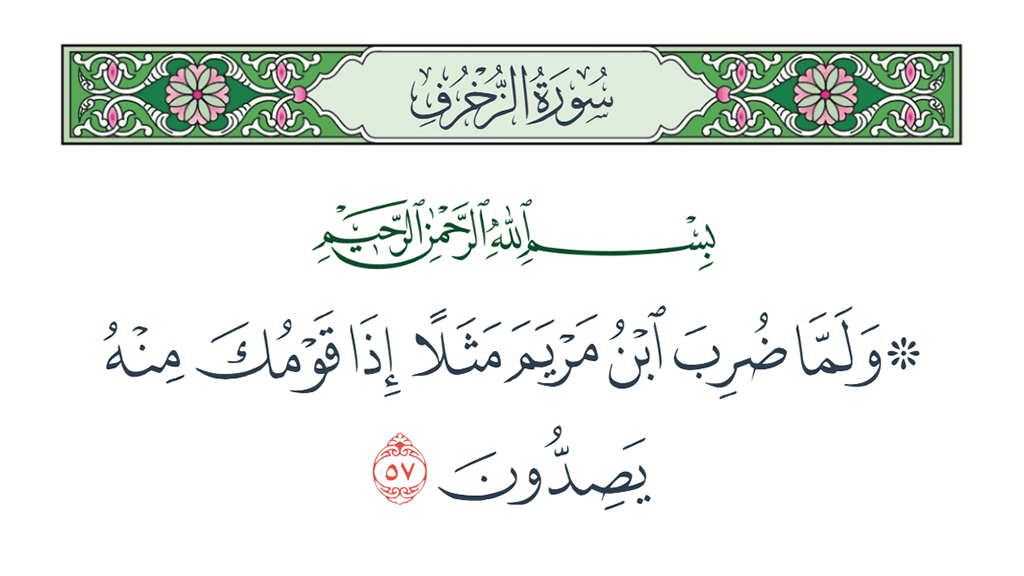
شتّان بين المؤمن والكافر
-
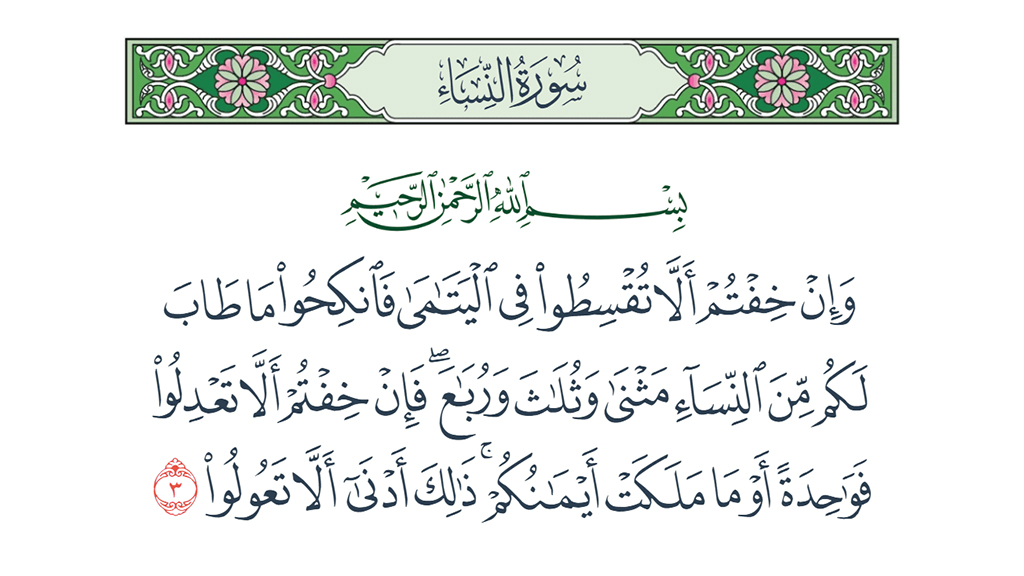
معنى (عول) في القرآن الكريم
-
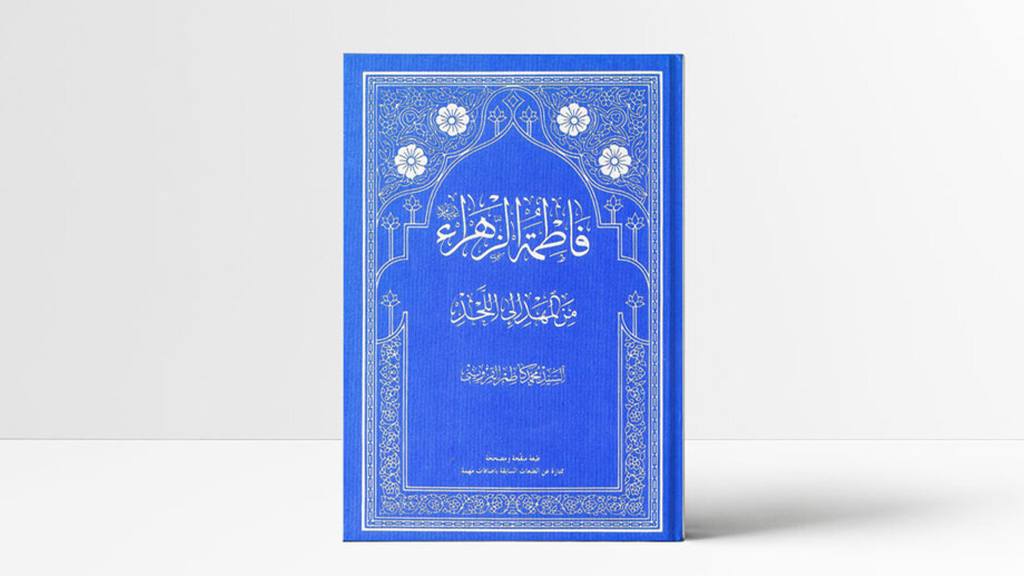
فاطمة الزهراء عليها السلام من المهد إلى اللّحد
-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
-

فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
-

من كنوز الغيب
-

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
-

معنى (ملأ) في القرآن الكريم










