علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".الفضاء الإعلامي كمصنوع إيديولوجي

لم يعد من ريبٍ في أن الإعلام بتقنياته الهائلة، بات أحد أبرز روافد التحولات الكبرى في السياسة والاقتصاد والفكر والفن والثقافة. بل قد يكون في أحايين شتى، محورها ومحركها ومحرضها. وعلى هذه الدلالة سيكون في تشكيل المعرفة وتكوين الأفهام، أو على العكس في تدمير أنظمة قيم كانت مادة صراع وتنازع، بين المحاور والأحلاف الدولية.
«العالم المابعد حداثي» كما تدعوه الفلسفة المعاصرة، هو الصورة المكثفة للتحولات التي عكستها مرآة الإعلام. لقد بدا هذا العالم ملتبساً، ومحكوماً إلى فوضى لا حدود لها. وهو بقدر ما جاءنا بحقائق لا يجوز التنكر لها، بقدر ما أنبَت أوهاماً ينبغي التعامل معها بجدية استثنائية. وغالب الظن أن يظل هذا العالم رهين الالتباس والمخالطة بين حقائقه وأوهامه، ردحاً إضافياً من الزمن.
لقد جُعل العالم بــ «الميديا الفضائية» حقلاً كونياً مكتظاً بشبكة هائلة من المعلومات، وهذا يعني أن حشداً من المفاهيم التي انتظمت العلاقة بين المجتمعات البشرية، بات الآن ضمن دوائر الشك. لم يعد مفهوم السيادة القومية، مثلاً، هو نفسه اليوم، بعدما تحولت الدولة القومية المغلقة إلى دولة عالمية مفتوحة، بفعل الأسواق المشتركة، وثورة الاتصالات. كذلك الأمر بالنسبة لمفاهيم أخرى، كالعقلانية، والتنوير، والأخلاق، وحقوق الإنسان، والديمقراطية وحق الاختلاف.. فهذه مفاهيم وآليات معرفة، لم تعد على صفائها الاصطلاحي، وإنما غدت أقرب إلى محمولات ذهنية تتصف بالنسبية وقابلية التأويل.
كل شيء في العالم صار مفتوحاً على الأثير اللاَّمتناهي. ولسنا نجد ما يعصم المواطن العالمي المعاصر من الامتثال لجاذبية اللغة، والصوت، والصورة، سوى انتمائه وتحصنه بأحزمة أمان حضارية وثقافية وحتى دينية. غير أن هذا كله يتوقف على آليات احتدام شديدة التعقيد، وسيكون على الأقوياء والضعفاء خوض حرب لا هوادة فيها، تارة من أجل الهيمنة والاستحواذ بالنسبة للأقوياء، وطوراً من أجل الحفاظ على الهوية وحق امتلاك الحرية بالنسبة إلى الضعفاء.
لو أخذنا المعيار الغربي لمقاربة الإشكالية، لتافر لنا مثال بيّن، حيث يظهر أن إعلام ما بعد الحداثة لم يعد مجرد عامل من عوامل التغيير، بل غدا العامل الرئيس الذي تتجلى فيه وبواسطته، العوامل الأخرى الأمنية والاقتصادية والسياسية والقيمية وسواها. ولقد تحول من وجهٍ آخر إلى وعاء فسيح، تُختزل فيه أدوات الصراع والمنافسة والتحدي في صورة مدهشة.
وما دمنا نتحدث في جدلية الصلة بين الإعلام والأخلاق، يصير الكلام مشروعاً على ما يمكن تسميته «إيديولوجيا المشاهدة». هذه الإيديولوجيا التي شُكّلت عناصرها عبر التلفزة، ثم تحولت إلى أداة سيطرة هائلة تستحوذ على العقول والأفئدة. ثم تتجه، بما تتمتع به من جاذبية، لتقبض على ناصية الأخلاق وتديرها كما يُدار الإعلان السلعي.
لقد أصبحت شبكات التلفزة الفضائية مصدراً شبه وحيد لضخ المعارف وأنماط القيم، فصارت بذلك تتحول إلى قوة هيمنة معنوية، من خلال جعل مشاهديها أسرى جاذبية الصوت والصورة التي تبثها بسرعة هائلة، فلا تترك لأحدٍ أن يرجئ شغفه بمعرفة ما يحدث في أي نقطة من العالم.
والملاحظة التي يوردها عدد من الخبراء والمحللين، في هذا الحقل، هي أن المعلق الصحافي والمراسل صارا بالنسبة للمشاهد كمن يأتيه باليقين المفقود، بل ومصدر طمأنينة حتى بالنسبة للمشاهد الذي تدور الأحداث في بلاده هو بالذات، إلى درجة أصبح الجالسون أمام الشاشات الصغيرة، أشبه برعايا يتطلعون بخشوع وترهب لواعظٍ أخلاقي يرسم لهم طريق التعرّف إلى ما هو الخير وما هو الشر.
والى هذا، فقد أمست التلفزة معادلاً تكنولوجياً للإيديولوجيات الصارمة التي تُظهر جاذبيتها وسحرها في صورة محمومة. إنها أشبه بتقنية أسطورية تستند إلى جماهير عريضة، تتكاثر كلما تطور سلطانها المعنوي. ولو أشرنا إلى العقل الذي يديرها ويشرف على بثها، لوجدنا أننا إزاء ناظم إيديولوجي لـه استراتيجياته الثقافية، والفكرية، المتكاملة.
كتمثيل لعمل هذا الجهاز الإيديولوجي، لم يتورَّع أحد منتجي البرامج التلفزيونية في القناة الفرنسية الأولى عن البوح بطريقة إدارته للإنتاج، فقال: «كلما كان مستوانا متدنياً ومادياً، جلبنا عدداً أكبر من المشاهدين. هكذا هي الحال. فهل من اللازم أن نلعب دور الأذكياء ضد المشاهدين؟ هم على الأقل لا يفكرون، فلنتوقف نحن عن لعب دور الوعاظ». على هذا التمثيل لتقنيات الفاعل الإيديولوجي، تستهل أخلاقيات الاستحواذ رحلتها من دون نزاع. كل شيء لدى الفاعل إيَّاه يجب أن يهبط إلى دنيا التسليع، وقيم السوق. وهو يوظف نشوءاً لهذه الغاية كل ما يشجع على القبول، والإذعان، والطواعية، والامتثال. الأمر الذي أدى إلى ظواهر دراماتيكية، ذات آثار مدمرة في وقائعها ومعطياتها، ليس على بلدان الجنوب وشعوب ما يسمى العالم الثالث فحسب، وإنما أيضاً وأساساً، على المجتمعات الغربية نفسها.
وهذا ما لاحظه الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي في بداية التسعينات، لـمّا بيّن أن فلسفة الإعلام في الغرب تنطوي على تحريض دائم وحاسم من أجل تجنيد المشاهدين بالإغراء، ودعوة إلى الغوغائية وإلى الخمول الدائر تجاه رأي عام تتلاعب به الدعاية والإعلانات، وأدوات نقل الثقافة الجماهيرية. التلفزيون نفسه لا يقصّ حكاية التاريخ، ولكنه يصنعها بالتلاعب بها. بمعنى أنه يستسلم إلى انحرافات السوق، وإلى تهديم كل روح نقادة، وكل فكر يشعر بالمسؤولية. المرارة التي يفصح عنها مثقفون غربيون حيال واقع الإعلام في مجتمعاتهم، مردها إلى استشعارهم أن الحضارة الغربية تنحو بسرعة مذهلة نحو الاضمحلال الأخلاقي. حتى إن كثيرين منهم راحوا يصفون مستهل القرن الحادي والعشرين بأنه عودة متجددة لعصر فساد التاريخ وتدهوره، كما كان الأمر زمن انحطاط الرومان. وأن هذا التدهور الموسوم بهيمنة تقنية وعسكرية ساحقة، لا يحمل أي مشروع إنساني قادر على إعطاء معنى للتاريخ وللحياة.
نقد النخب الفرنسية لما يجوز وصفه بــ «الجيولوجيا الإعلامية» يبدو ضرورياً، وإن كان غير حاسم. ذلك أن صورته تتأتى من منطقة معرفية ذات حساسية بالغة التعقيد. فالنقد هنا ينطلق من مبدأ أخلاقي وإعادة الاعتبار للقيم، في وقت تستعر فيه حمى الاستهلاك ووحشية رأس المال، على نحو لا يدع مجالاً للسجال الهادئ في الثقافة، والفلسفة، والفكر، وقضايا البيئة ومصير الإنسان.
والأخطر في هذا الوجه، ما يجد ترجمته في دخول الإغراء الإيديولوجي للفضائيات عالم الحروب المدوية، ثم «ليشرعنها» إلى درجة لا يعود معها المشاهد يهتم بما تفعله الأسلحة المدمرة للإنسان، بل ينصب اهتمامه على البراعة الفنية التي تؤدي بها هذه الأسلحة مهماتها بنجاح.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
محمود حيدر
-
 السّبّ المذموم وعواقبه
السّبّ المذموم وعواقبه
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معنى (لات) في القرآن الكريم
معنى (لات) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أنواع الطوارئ
أنواع الطوارئ
الشيخ مرتضى الباشا
-
 حينما يتساقط ريش الباشق
حينما يتساقط ريش الباشق
عبدالعزيز آل زايد
-
 فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
فأَوقِد لي يا هامان على الطين!
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-
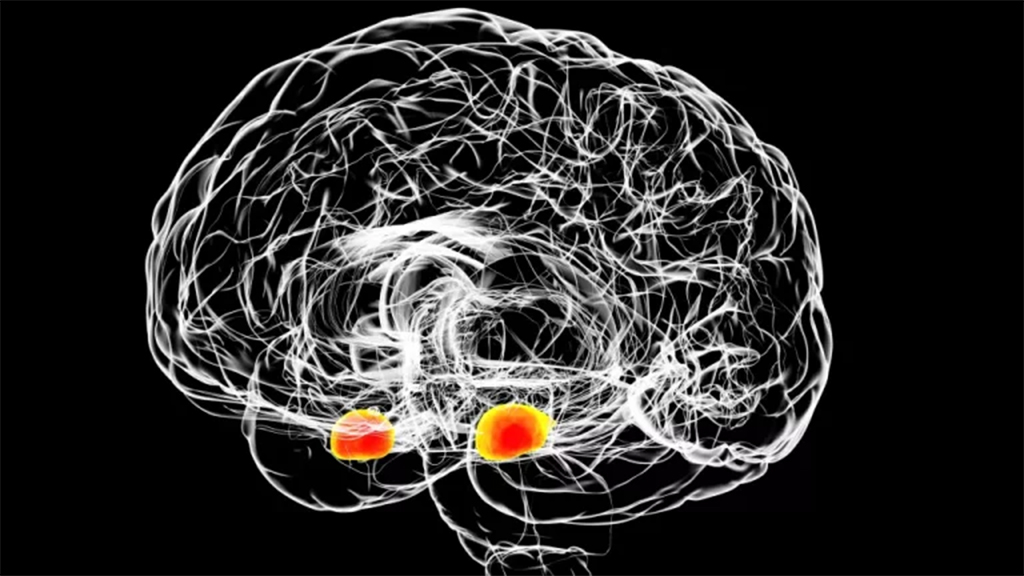
النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)
-

خطر الاعتياد على المعصية
-

السّبّ المذموم وعواقبه
-

معنى (لات) في القرآن الكريم
-
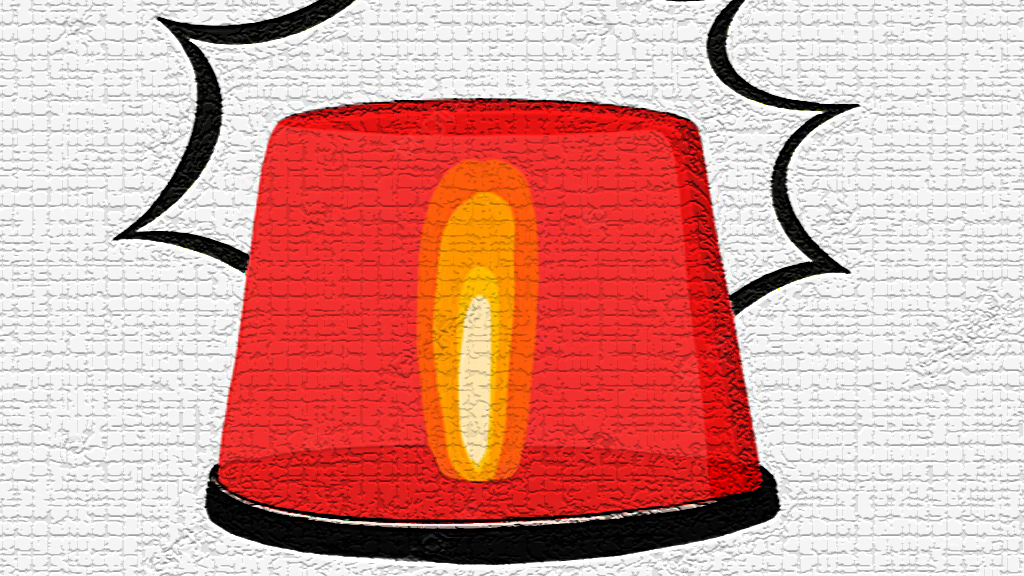
أنواع الطوارئ
-
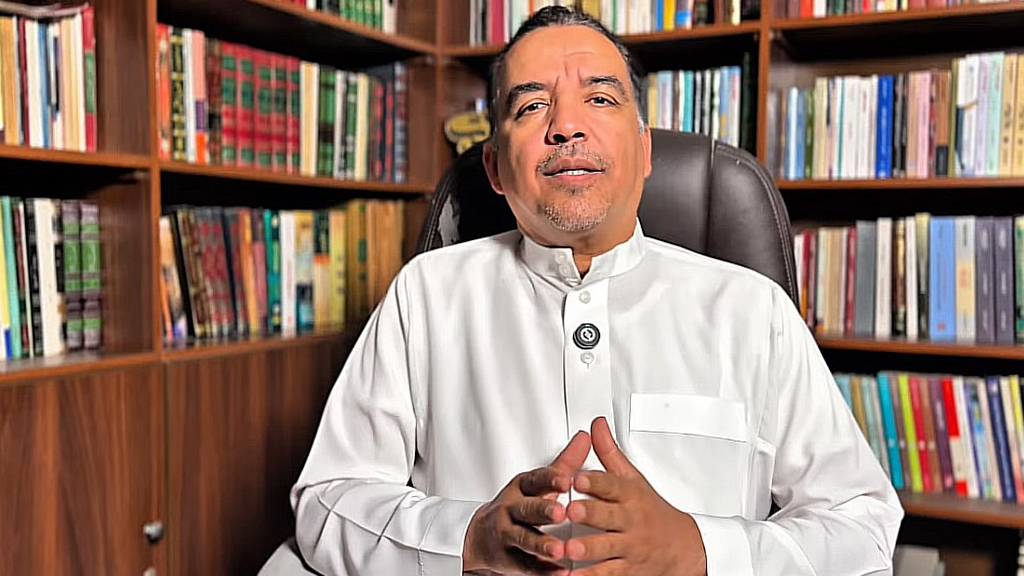
زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)
-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)
-

حينما يتساقط ريش الباشق
-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)









