مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :
مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمالمعرفة الدينية والمادة

يتّسم العالم الذي نعيش فيه بالتقدم المدهش؛ هذا التقدم الذي يسوق الإنسانية بوتيرة متصاعدة نحو مدارج التمدن. فالإنسان المعاصر سخّر التقدم العلمي في سدّ المئات والآلاف من احتياجات حياته اليومية مستفيدًا من الفكر العلمي الخلّاق.
ومن البديهي أن تسخير الطبيعة لما يحقق أهداف الإنسان ومقاصده استوجب استنفار الطاقة الإنسانية لما يتطلب رفع كفاءة الأعمال كميًّا وكيفيًّا. وفي ظل هذا التراكم في الفعاليات والأعمال، أخذ الإنسان يعيش مفهومًا للزمن يتغاير مع مفهوم العصور السابقة. فإذا كان الإنسان في الماضي يتعامل مع وقته من خلال مفهوم تقسيم يومه إلى ليل ونهار، فإنّ الاهتمام المتزايد بتذليل الطبيعة وتسخيرها فرض عليه أن يتعامل مع وقته الآن من خلال الثانية وشطر الثانية حتى أصبح حريصًا على أن لا يهدر لحظة من لحظات وقته.
بيد أنّ ما ينبغي الانتباه إليه أنّ آفاق الإنسان مهما امتدت واتسعت، إلّا انّ طاقته الوجودية ستبقى محدودة في نهاية المطاف، وكثمرة لذلك سيكون تركيز الإنسان على بعد مدعاة لإهمال بعد آخر. في ضوء هذه الحقيقة نجد أن طغيان الجانب المادي في حياة الإنسان المعاصر انتهى إلى حجب الجانب المعنوي والتأثير عليه عبر الحس المادي الغليظ الذي أخذ يسدل بستاره على حياته المعنوية والدينية.
هذه الحقيقة تتأكد أكثر بمقارنة بسيطة بين ما كانت عليه البشرية في العصور السابقة وما آلت إليه الآن على مستوى الدين. إذ نجد من خلال مطالعة تأريخ الأديان والمذاهب أنّ تفاعل الإنسان مع الدين والبعد الغيبي المعنوي عمومًا يتضاءل كلما انجرف الإنسان بعيدًا عن خط الاعتدال وطغى الجانب المادي على حياته.
على هذا الأساس نسجّل أن ما يصدر من شكوك وأسئلة حول الدين وما يساق من اعتراضات على البعد المعنوي، تنبع جميعها من هيمنة الروح المادية على الإنسان. فطغيان المادة هو الذي يبعث في الإنسان روح الشك في الدين وأحكامه وممارساته. وإلّا فان بمقدور المتتبع المنصف أن يكتشف سريعًا أنّ الشبهات التي تثار اليوم والأسئلة التي تتداولها الألسن عن موقع الدين ودوره ليست جديدة بتاتًا، وهي بالتالي ليست - كما يقال - نتاجًا لعصر العلم، وإنما هي في واقعها إعادة إنتاج لشبهات العصور الماضية. فعصر العلم لا يختص بمثل هذه الشكوك والأسئلة التي سبق وإن اجتاحت البشرية في العصور السابقة، بحيث كانت تهدأ وتتضاءل حين تجد أجوبتها الشافية.
إنّ الذي لا يهدأ ليس الشك الديني في الإنسان، وإنما الروح المادية التي تظهر إلى السطح بأبسط المؤثرات خصوصًا وهي تجد ما يعينها في مظاهر الطبيعة الفاتنة وإيحاءات غرائز الإنسان وعواطفه وميل الإنسان إليها متنكبًا ما يرشد إليه العقل السليم.
فحينما يمتلئ شعور الإنسان وإدراكه بهذه المظاهر والنوازع يبدأ بالانسياق نحو المادة مبتعدًا عن العقل، فتجري على لسانه حينئذ كلمات ذم المعنويات التي ينظر إليها كعقبة في طريقه (المادي).
وهكذا تولد الشبهات من نظير قولهم: إنّ الدين والارتباط بالغيب إذا كان لائقًا بالإنسان البدائي المتوحش فما حاجة الإنسان المعاصر لمثل هذا الارتباط بعد أن قطع شوطه في مسار المدنية؟
ويقال: هل يعدو الدين أن يكون دعوة لنبذ قانون السببية وإهمال الشعور الإنساني وقتل إرادة الإنسان الطبيعية في مقابل ربطه بعامل غيبي لا مصداقية له؟
ويقال أيضًا: إذا كان خبز الإنسان وشبعه يرتبطان بمدى التزامه وتقيده بالتعاليم الدينية، فلكان يفترض بالمجتمعات الإنسانية المتمدنة في عالم اليوم، أن تموت جوعًا وهي تتنكب طريق الالتزام الديني وتتنصل للدين كاملًا، لتتوسّل بالعلم الذي بلغ بها أوج مراحل الرقي والتقدم بحيث أصبح بمقدورها أن تسخّر السماء والكواكب بعد أن سخّرت ما على الأرض؟
إن أول ما يجب التذكير به مجددًا أنّ هذه الاعتراضات ليست وليدة العصر الراهن (الذي يطلق عليه عصر العلم) بل هي من مواريث العصور السابقة. وغاية ما هناك أنها شهدت إعادة انتاج.
أما الجواب إجمالًا فيستند إلى هذه المقدمة: إن تقدم الإنسان في حقل من حقول المعرفة لا يستلزم تقدمًا مماثلًا في الحقول الأخرى التي تبقى بالنسبة إليه تنطوي على المجهول.
فلا ريب أنّ العلوم الطبيعية أضاءت أمام الإنسان آفاق المعرفة وأزاحت الظلام والمجهول جانبًا، بيد أنّ ضياءها لم يعم كل مساحات العتمة والجهل.
ومعنى ذلك ببساطة أننا لا ننتظر من علم النفس أن يحل - حتى مع تقدمه – لنا المسائل الفلكية؛ كما لا ننتظر من الطبيب أن يضطلع بحل المشكلات الفنية للمهندس.
وحين نطبّق القاعدة على العلوم الطبيعية نجد أنها تضطلع بالطبيعة والمادة كحقل أساس لعملها، لذلك لا معنى أن ننتظر منها حل مسائل ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقية) ومعالجة البعدين المعنوي والروحي في وجود الإنسان وغير ذلك مما تكتنزه فطرة الإنسان ويستودعه وجوده التكويني الذي جبل عليه.
وما نريد أن ننتهي إليه، أننا لا ينبغي أن ننتظر أن نجد جوابًا على مسألة تقع في مجال ما وراء الطبيعة، عبر انتهاج مسار الفنون والعلوم الطبيعية. فهذه العلوم لا تكشف من المجاهيل إلّا ما يقع في دائرة عملها، أما خارج اختصاصها فهي تتسم بالحياد ولا رأي لها إثباتًا أو نفيًا.
فطالما كانت المادة هي الموضوع الأساس لعلوم الطبيعة من غير الميسور لها أن تجيب بالنفي والإثبات على مسائل ترتبط بما وراء الطبيعة وبالجوانب الروحية والمعنوية.
إذًا فللمعرفة الدينية منطقها أيا كانت النظرة إلى الدين. هذه المعرفة التي تخضع إلى منهج خاص ينتهي إلى التعمق بالمعارف الدينية عبر البحث والتحليل بعيدًا عن حجب الطبيعة والمادة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 النظام الاقتصادي في الإسلام (3)
النظام الاقتصادي في الإسلام (3)
الشهيد مرتضى مطهري
-
 مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا
مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)
حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)
الشيخ محمد صنقور
-
 معنى (نعق) في القرآن الكريم
معنى (نعق) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 بحثًا عن أنصار المهدي (عج)
بحثًا عن أنصار المهدي (عج)
السيد عباس نور الدين
-
 شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)
شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
الفيض الكاشاني
-
 في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)
في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)
محمود حيدر
-
 صبغة الخلود
صبغة الخلود
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ
تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ
عدنان الحاجي
الشعراء
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد
علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد
حسين حسن آل جامع
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
آخر المواضيع
-

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)
-

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا
-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)
-

يا جمعه تظهر سيدي
-
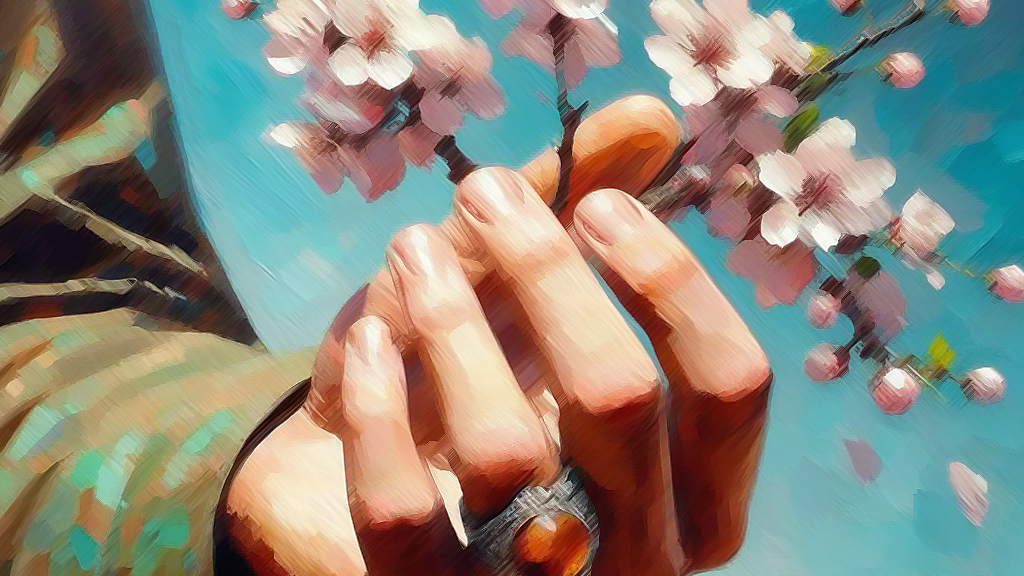
شربة من كوز اليقين
-

جمعيّة سيهات في ضيافة البيت السّعيد
-

(الأنماط الشّخصيّة وأثرها على بيئة العمل) محاضرة لآل عبّاس في جمعيّة أمّ الحمام الخيريّة
-

(شذرات من أدب الرّحلات) محاضرة لنادي قوافي الأدبيّ قدّمها الشّاعر زكي السّالم
-

الإيمان بالمهدي (عج) في زمن التّشكيك
-

معنى (نعق) في القرآن الكريم










