مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
حيدر حب اللهعن الكاتب :
ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...أزمة الحبّ والإيمان (1)
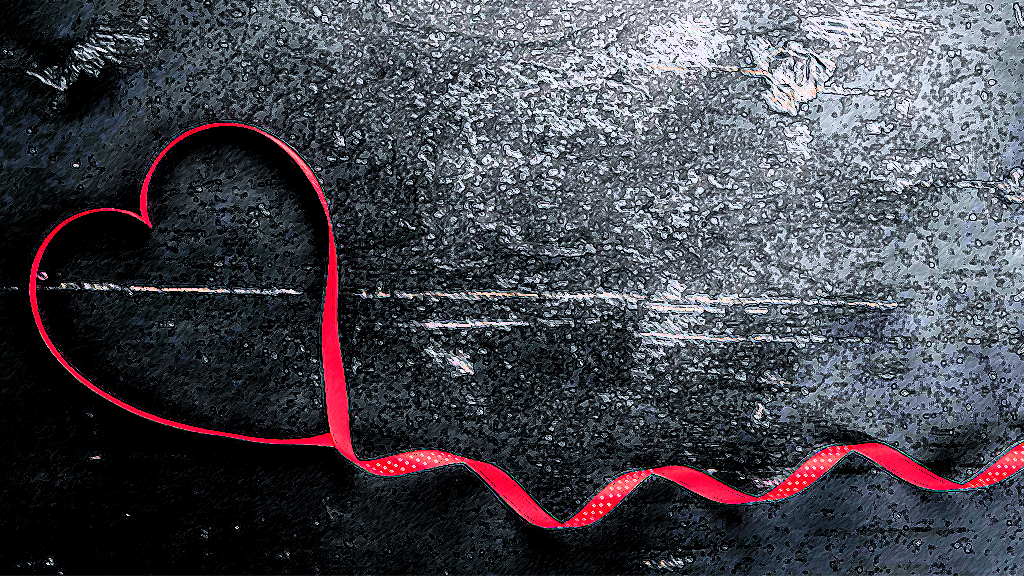
واحدة من المسائل المدروسة والجديرة بالدراسة أكثر، هي نوع العلاقة بين الدين ومفاهيمه وقوانينه وأحكامه وأخلاقيّاته و… من جهة، وبين الواقع والطبيعة والتكوين والفطرة و… من جهةٍ أخرى، فقد قرأ بعض الباحثين الدينيّين في القرن الأخير هذا الموضوع بصورةٍ يمكن التعبير عنها بأنها إثباتية؛ أي أنّهم عالجوا موضوع الرابطة بين الدين والعلم أو بين الفهم الديني والمعطيات العلمية.
فمثلاً أخذوا يفكّرون في إمكانية أن يقدّم العلم معطى معينًا فيما يرفض النص الديني هذا المعطى العلمي، فهل هذا الأمر ممكن؟ وإذا ما واجهنا أنموذجاً من هذا القبيل فما هي الطريقة التي ينبغي علينا اتباعها حتى لا يبدو هذا التناقض أو هذا الاختلاف بين العلم والدين؟ هل نقوم بتأويل النصّ الديني وما معنى التأويل؟ أم أنّنا نرفض المعطيات العلميّة التي نجد أنّ النصوص الدينية من الكتاب والسنّة تعارضها وتنافيها؟
لقد حاز هذا الموضوع على اهتمام العلماء منذ القرون الإسلامية الأولى ولو ضمن أشكال مختلفة، ففي البداية كان السؤال يطرح على أساس العلاقة بين العقل والنقل، وهو ما بلور فيما بعد قصةً طويلةً من الخلاف الذي أحاط موضوع علم الفلسفة، حيث اختلف العلماء في الموقف من هذا العلم، سيما وأنّ بعض نتائجه كانوا يرونها معارضةً لنصوص القرآن الكريم.
ولكن للموضوع بعدٌ آخر أعمق وأسبق مرحلةً من هذه المرحلة، ألا وهو البعد الثبوتي والواقعي، فنحن نسأل: هل أنّ واقع الدين يعارض أو يعاكس واقع العالم والتكوين بما في ذلك التكوين البشري بقطع النظر عما استطاع العلم أو البحث الديني التوصّل إليه؟
لقد طرح العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي فكرةً في غاية الأهمية في مواضع عديدة من كتاباته، وتتلخّص هذه الفكرة في أن الشريعة الإسلامية وكذلك الأخلاق وغيرها ليست سوى استجابة للتكوين الذي أودعه الله في الإنسان والطبيعة، فعندما نقول بأن على الإنسان أن يتّسم بصفات معينة فإننا نعني بذلك أن الوضع الطبيعي الوجودي له يستدعي ذلك، تماماً كما نقول بأن على الإنسان أن يمارس الحركة في حياته اليومية، لأن ممارسة الحركة وعدم الخمول يعنيان ضرورةً واستدعاءً تكوينيّاً، فلو لم يمارس الإنسان الحركة، فهذا يعني أنه يخالف مقتضى الطبيعة التي خُلق جسده عليها.
وهذا معناه ـ بشكل أكثر دقةً ـ أنّ التعاليم الدينية ليست أمراً إضافيّاً على المسار الوجودي والطبيعي للكون والعالم، بل هي كشفٌ عن هذا المسار حتّى لا يتصرّف الإنسان تصرّفاً يعارض فيه مقتضى الطبيعة والخلقة، ونتيجة هذا الكلام أنّ التشريعات الإسلامية لا تعارض التكوين البشري ببعديه المادي والمعنوي، ولا تتناغم وتنسجم معه فحسب، بل إنّها تكمل هذا التكوين وتتداخل معه، فعندما نقول بأنّ شرب الخمرة حرام، فهذا معناه أنّ الجسد والروح الإنسانيّين يتطلّبان في نمط وجودهما عدم تناول هذا النوع من المشروب، لا أن الطبيعة الإنسانية لا مانع لديها من هذا المشروب، فيما الإسلام ـ وزيادةً على الحالة الطبيعيّة ـ أراد أن ينظّم حياة الإنسان، إنّ الأمر ليس كذلك بنظر العلامة الطباطبائي، وهذا معناه أن الإسلام يتوافق والفطرة كما يتوافق والطبيعة والخلقة ويحترم هذا الواقع كلّه، ومن هنا يمكن عدّ ما ذكره العلامة الطباطبائي بمثابة فلسفة لما يتعارف في الوسط الديني من فطريّة الدين والتديّن، وكذلك تعميقاً لـه وتوسيعاً لدائرته.
ومن موقع تأثير العلامة الطباطبائي، جاءت الفكرة التي أثارها الشهيد مرتضى مطهّري (1979م) في دراسته لموضوعة المرأة في الاسلام، والتي أصّل على أساسها ـ كما وفسّر ـ العديد من المفاهيم الدينية المرتبطة بالمرأة، وهي فكرة التناسب بين القانون والقيمة من جهة والطبيعة والتكوين من جهةٍ أخرى، أي أنّ القانون الناجح والقابل للإجراء والتنفيذ هو ذاك القانون الذي يمكنه مماهاة الواقع التكويني وإقامة جسورٍ من التناغم والاتّساق والانسجام والمحاكاة معه، وإلا فإنّ ما سينجم عن هذا القانون ـ على أقلّ تقدير ـ هو فشله وإخفاقه في حركة الممارسة اليوميّة.
الحبّ وسيكولوجيا المراهَقة
ليس البحث السيكولوجي من اختصاص الكاتب، لكن ـ ومن باب الإشارة إلى كلام المختصّين في هذا المجال، كما والإشارة إلى واقعٍ يوميٍّ إنسانيٍّ ـ يمكننا القول بأن الفطرة الإنسانية أو دعونا نعبّر: التركيبة النفسية الإنسانية تنـزع دائماً نحو الحبّ والعشق، أي أنّ الحب بالنسبة للذات الإنسانية يعبّر عن ظاهرةٍ استدعائيّةٍ للنفس البشريّة، فعندما نقول: «نفس بشرية» فإنّ هذا المفهوم يرشدنا ـ في وعينا وإدراكنا له ــ إلى ظاهرةٍ نسمّيها نحن الحب، وليست هذه الظاهرة خصيصة إنسانيّة، بمعنى أنها لا تختصّ بالإنسان فقط، بل هي ضاربةٌ بجذورها في البعد الحيواني أيضاً، فهي تلاحظ في الحيوانات أيضاً في علاقة الأم بأطفالها وهكذا…
أي نحن فعلاً ـ وبلغةٍ مبسّطةٍ ـ نعترف بأن واقعيّة الحب بالنسبة للإنسان بوصفه كائناً حيّاً هي واقعيةٌ لصيقة، وبالتالي ـ وفق شهادات التجربة اليومية والإحساسات الذاتية والدراسات النفسية والقراءات التاريخية ـ لا يمكننا فصل هذه الظاهرة عن الإنسان نفسه.
هذا الكلام هو من الوضوح بمكانٍ فيما يُظن؛ فالتجربة الدينية نفسها في العلاقة مع الله وأئمة الدين، والنـزعات العرفانيّة في شرق الأرض وغربها، وكذلك الثورات العاشقة للأوطان والقيم.. كلّها تحكي عن ذلك وتؤيّده.
بيد أن المشكلة في عملية ترشيد الظاهرة، فالكثير من القيم غير مطلق، ولذا فهو قابلٌ للترشيد والإنضاج السليمين، ولعلّ النقطة التي تعني الدين بشكلٍ أساسيّ في جدليّة الحبّ والإيمان في عصرنا الراهن تكمن في تثوير المراهَقة لهذه الظاهرة في أعماق النفس البشريّة، أي أنّ الإنسان المراهق ـ شابّاً كان أو فتاةً ـ ينـزع بفعل ثورة المراهقة للتعبير عن الحبّ في إطارٍ ثنائيٍّ إنسانيٍّ؛ أي في إطار رابطةٍ بين شاب وفتاة عادةً، فهو ـ أي المراهق ـ يعيش باستمرارٍ حالةً من الحراك العاطفي الثائر، أمّا العشق الإلهي أو العشق المعرفي أو عشق القيم فهي أمورٌ قد تتأخّر قليلاً، أو قد لا تكون بنفس العمق أو بنفس الحضور على السطح، دون أن نتجاهل الظروف البيئيّة المحيطة التي قد تضاعف أو تقلّص من هذا أو ذاك.
وليس هذا الحراك العاطفي بين الشاب والفتاة ظاهرةً اصطنعتها الحضارة الغربيّة الجديدة، فالنصوص الأدبية (وغير الأدبية) القديمة لمختلف الديانات والحضارات والثقافات كلّها تحكي عن نزوعٍ عميقٍ جدّاً لطرفي المكوّن البشري هذا، وبالتالي ليس من الصحيح ربط هذا النوع من العلاقات ـ وبصورةٍ متسرّعةٍ ـ بالظاهرة الغربية المحدثة، بل أساس هذه الروابط إنساني وبشري، بمعنى أنه ليس محصوراً بواقعٍ معيّن أو في ظلّ مؤثّرات خاصّة، حتى لو ابتعدنا به عن التفسير الفرويدي للأمور كما سنلاحظ.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 (التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
عدنان الحاجي
-
 معنى (ملأ) في القرآن الكريم
معنى (ملأ) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 سيّدة الكساء
سيّدة الكساء
الشيخ شفيق جرادي
-
 المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (1)
المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (1)
إيمان شمس الدين
-
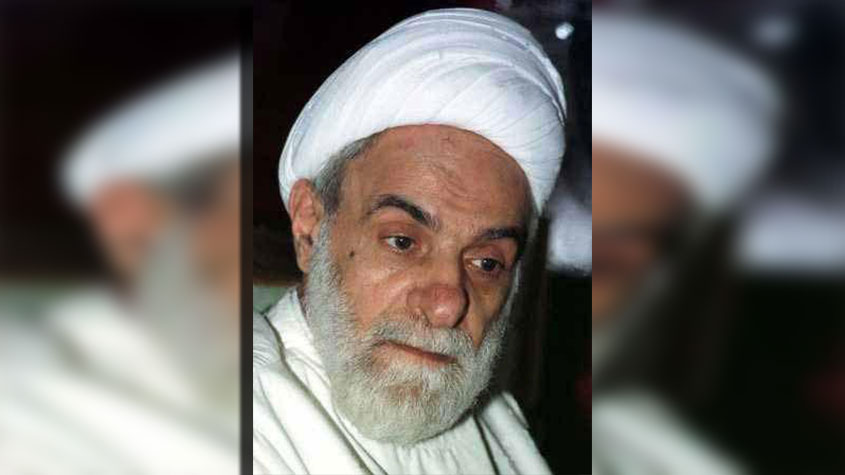 الموعظة بالتاريخ
الموعظة بالتاريخ
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
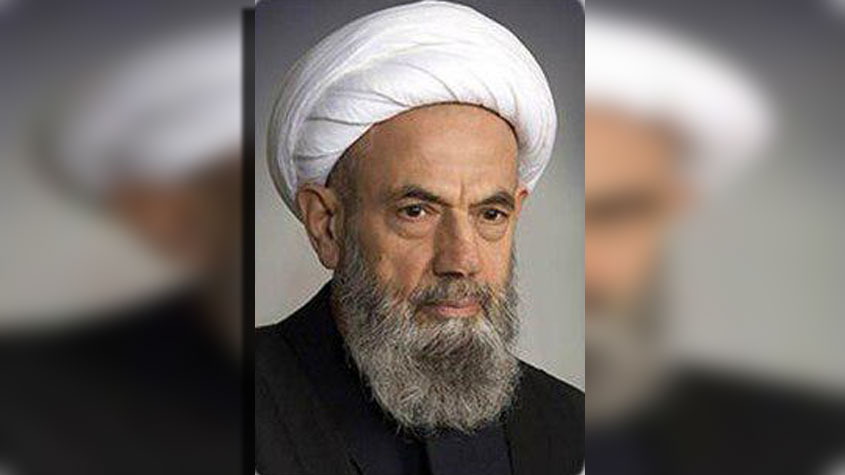 كلام عن إصابة العين (1)
كلام عن إصابة العين (1)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
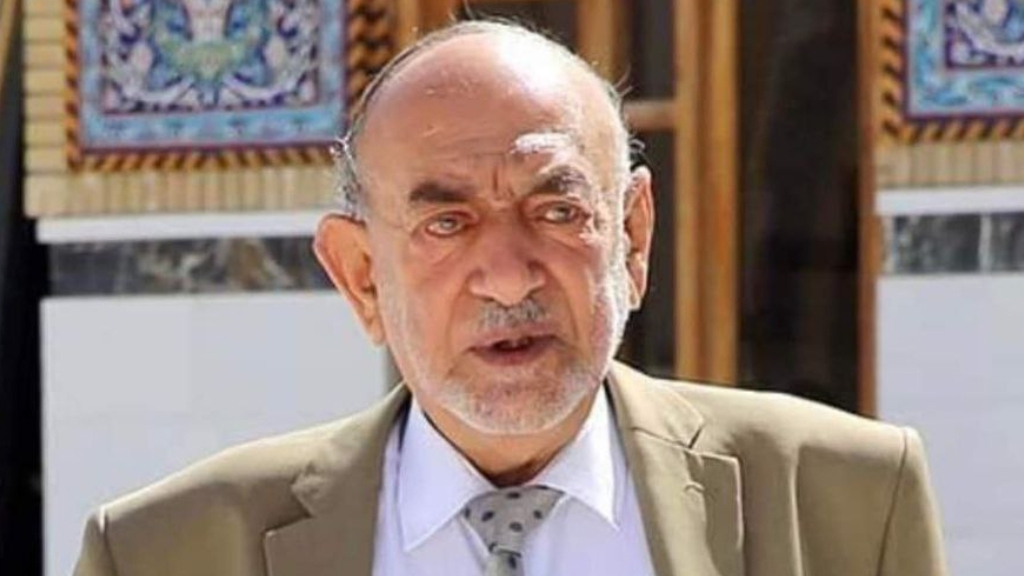 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
محمود حيدر
-
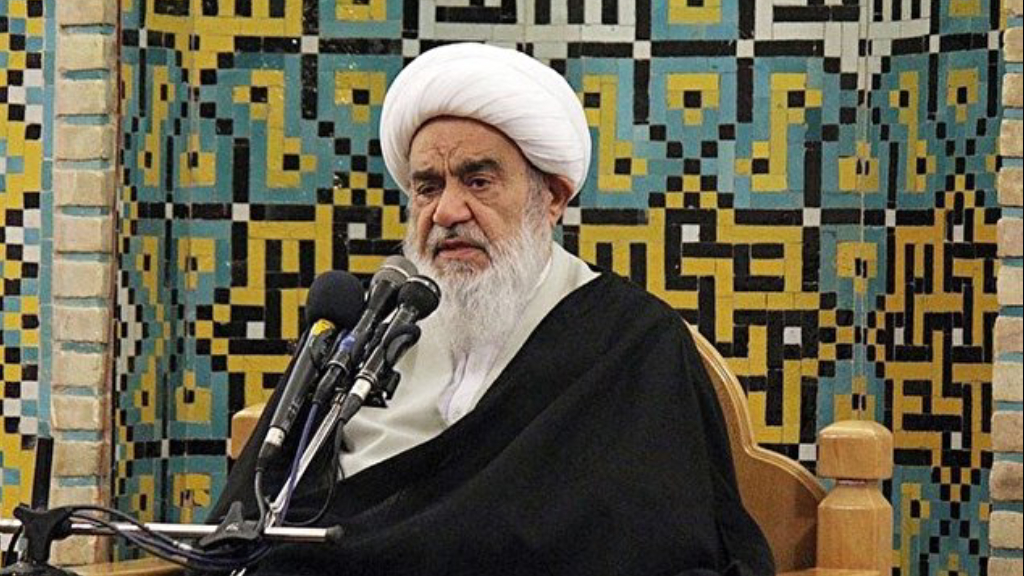 مجلس أخلاق
مجلس أخلاق
الشيخ حسين مظاهري
-
 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 الزهراء: مناجاة على بساط الشّوق
الزهراء: مناجاة على بساط الشّوق
حسين حسن آل جامع
-
 الصّاعدون كثيرًا
الصّاعدون كثيرًا
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
-
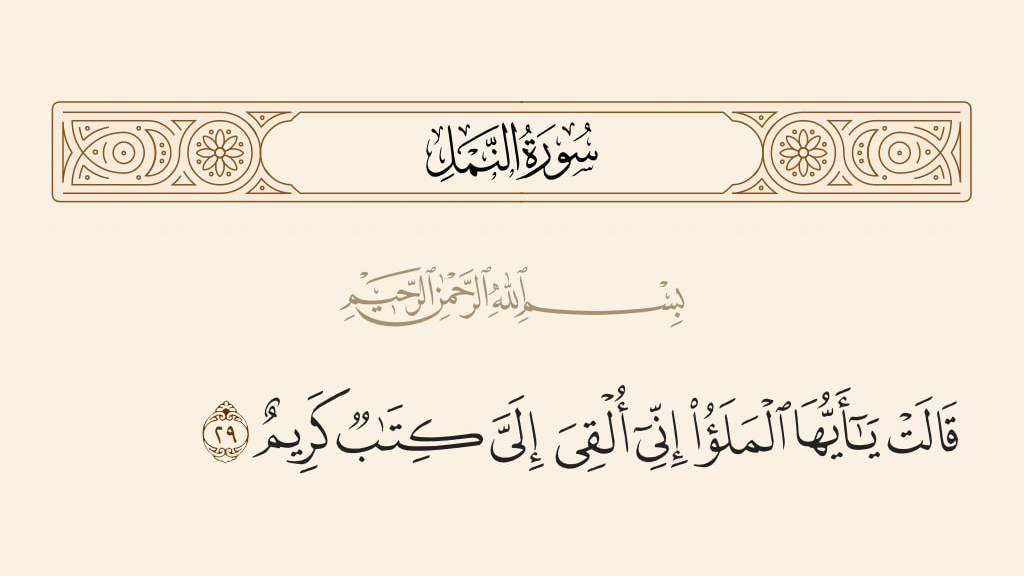
معنى (ملأ) في القرآن الكريم
-

برونزيّة للحبارة في مهرجان (فري كارتونز ويب) في الصّين
-
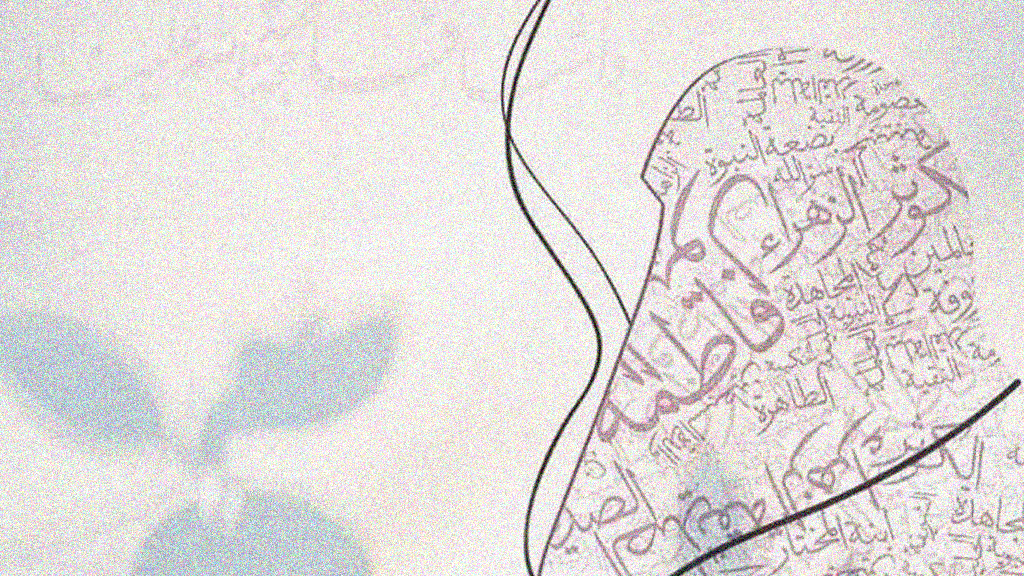
الزهراء: مناجاة على بساط الشّوق
-

سيّدة الكساء
-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (1)
-

شعراء خيمة المتنبّي في الأحساء في ضيافة صالون قبس في القاهرة
-
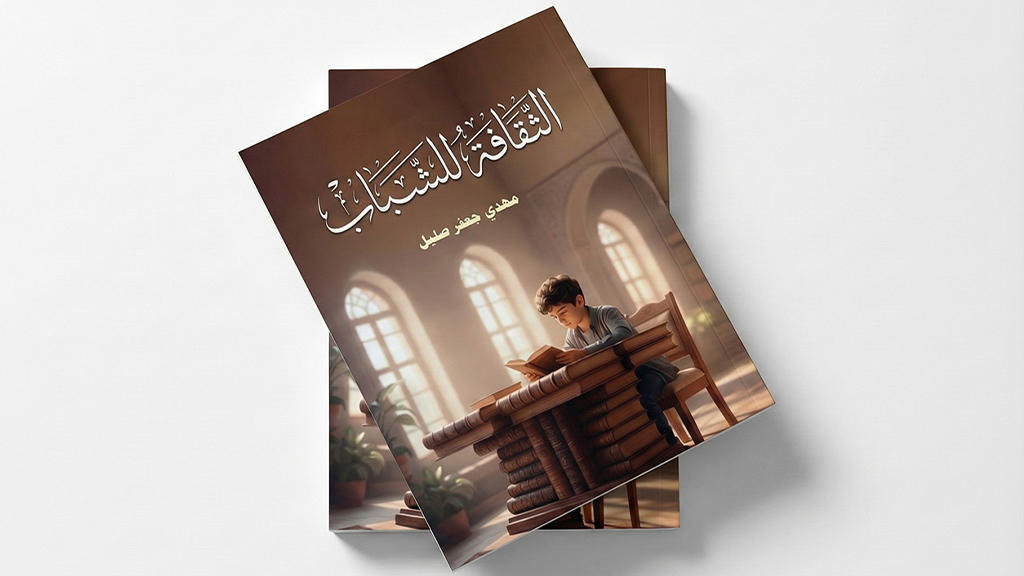
(الثّقافة للشّباب) جديد الكاتب مهدي جعفر صليل
-
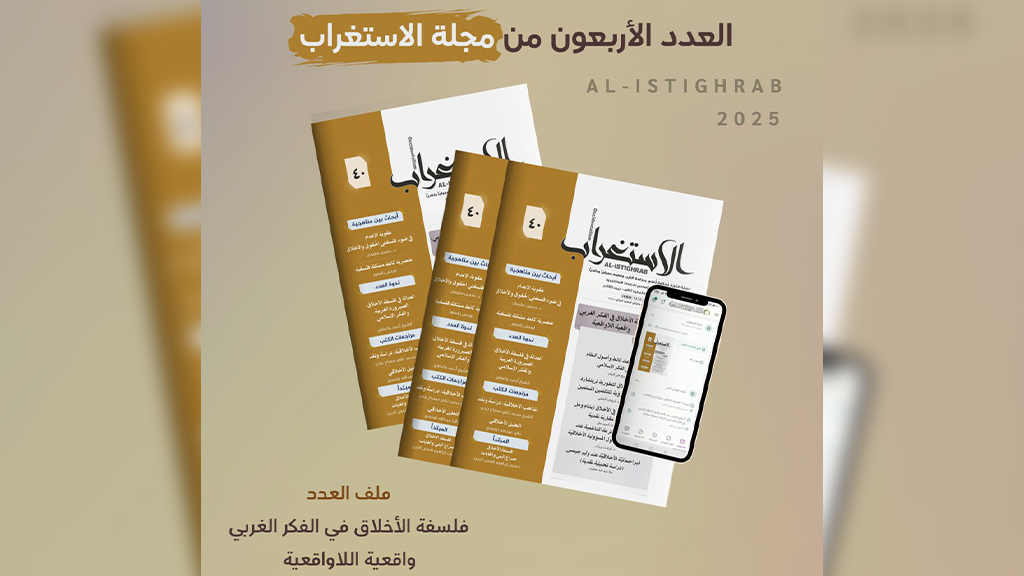
العدد الأربعون من مجلّة الاستغراب
-
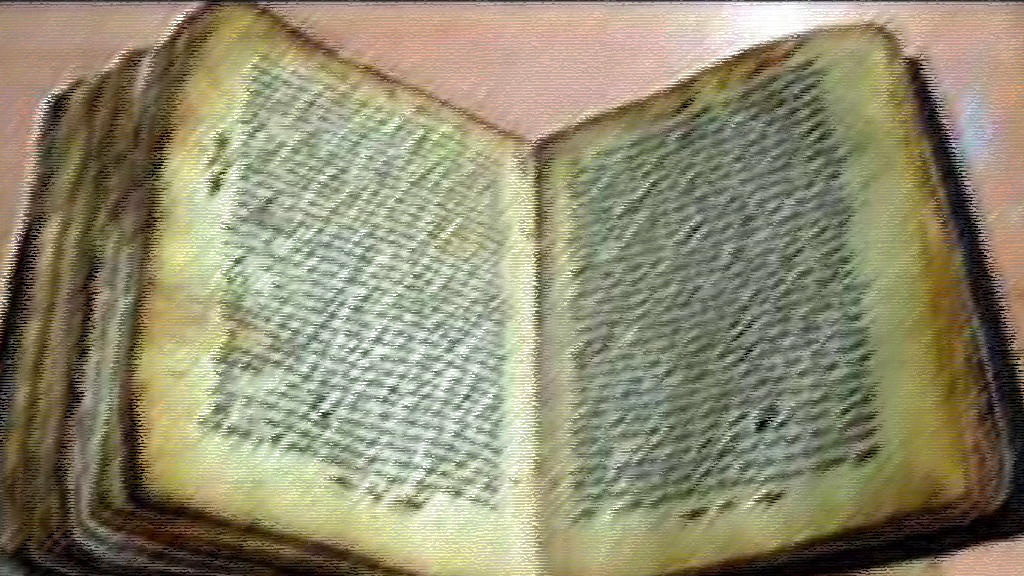
الموعظة بالتاريخ










