علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :
خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.الدين والعلمنة (في نظام المعرفة والقيم) (3)

وهنا تبرز أمامنا ثلاثة أسئلة…
السؤال الأول: هل يكفي مثل هذا (الضرورة حتى يثبت العكس) القيد لحل المشكلة؟ أو أنه سيضع العلمانية التأويلية أمام مشكلة أكبر؟
السؤال الثاني: هل الضرورة المنطقية وحدها، هي التي تشكل حقل الارتباط بين الأنواع والقضايا؟
السؤال الثالث: هل تخلو المعرفة الدينية من قيد “حتى يثبت العكس؟”، أو بمعنى آخر هل الثابت في القضايا الدينية هو من باب الضرورات المنطقية الحادة؟
بصدد السؤال الأول فإن وضع القيد قد يعفي التأويلية العلمانية من محذورين:
المحذور الأول: محذور التناقض المنطقي في حال تحدثنا عن علاقة بين المعرفة العملية التجريدية، والمعرفة العلمية،، علمًا بأن أصحاب هذه التأويلية ألجأهم الهروب من أصل الارتباط للحديث عن كون المعرفة العلمية مكوّنًا من مكونات المعرفة العملية.. وهذا بحسب التدقيق المنطقي مجرد فذلكةٍ لغوية لا طائل منها؛ إذ لم يقدموا لنا كيف يمكن أن يحلوا إشكالاتهم المنطقية عند اقتران ما هو مجرد مع ما هو معطى في بناء حقل معرفي واحد أو متناسب؟ علمًا أنه لم يكن هناك من داع لمثل ذاك الهروب لأن القيد أخرج القضايا العلمية والأخلاقية من دائرة الضرورة المنطقية، وجعلها ضمن دائرة اللازم وهذا ما سيسمح لهم ولكل من يتحدث عن اللزوم الضروري في القضية أن يجد سر التوالد والتناسب بين المعارف والعلوم حتى لو كان المتحدث دينيًّا.
المحذور الثاني: الحفاظ على ثوابت من مثل: مركزية الإنسان/ أهمية الأخلاق/ رفض التناقض/ وغيرها… من حيثيات تشكل برأي التأويلية العلمانية مسوغات حاسمة في تشكيل سمات العلمنة.. وهذا وإن كان فيه رفع لمحذور الوقوع في أسر مستلزمات الأخلاق الطبيعانية العدمية.. إلا أنه ارتكاس نحو الميتافيزيقا ولو بلونها المنطقي والأخلاقي مما يعني الهروب المفتعل من وادي التناسب المنطقي أورث العلمانية وقوعًا في أسر المعرفة الميتافيزيقية، وبذلك صارت الكلمة والمصطلح الميتافيزيقي هو المرجعية الأنسب لتوليد المعنى.
أما بصدد السؤال الثاني: فلقد قدمت الضوابط المعرفية جملة من حقول الارتباط بين القضايا والمعارف والعلوم تتجاوز حدود عدم التناقض المنطقي القياسي بين القضايا، ضيق أفق ما يظهر لنا للوهلة الأولى من عدم تناسب بين نوع من القضايا، ونوع آخر… وقد أثارت المنهجيات المعرفية بهذا الصدد جملة من مستويات الارتباط:
أولها: الارتباط التوليدي المنطقي وهو الذي تحدثت عنه التأويلية العلمانية.
ثانيها: الارتباط المنهجي وهو ارتباط في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت.. وبالتالي فإن مثل هذا الترابط سيفتح الباب واسعًا أمام التأثيرات المتبادلة بين العلوم، ولو بحدود الممكن. وهو على الرغم من كونه ارتباطًا غير قياسي/ منطقي.. ولا هو ارتباط بين محتوى القضايا.. إلا أنه وبسبب منهجيته المعرفية فإنه يشكل نحوًا من الارتباط المنطقي اللازم.
ثالثها: الارتباط على مستوى الرؤية المعرفية الواحدة.
رابعها: الارتباط على أساس الغاية في رفع التناقض المحتمل.
خامسها: الارتباط الحواري؛ إذ حتى بين الأمور التي لا ارتباط بينها هناك علاقة حوارية قادرة على توليد السؤال والإجابات المنشئة لمسائل وقضايا جديدة في حاضنة العلم والمعرفة[1].
وبذلك، فإننا مضطرون للقول: إن التأويلية العلمانية كانت قاصرة معرفيًّا عن بسط أنواع ومستويات الارتباط المعرفي لتقديم نموذج معرفي مؤهل ليشكل قاعدة انطلاق حيوي لحركة الفكر والفلسفة وناظم القيم والممارسة.
وهذا القصور الناشئ من حبس الذات في بنية المنطق التوليدي للقضايا هو الذي وضعها التباسية أحادية النظرة تارة، وأحادية التفسير أخرى، وأحادية الموقف في أكثر الأحيان، بل إن مثل هذا القصور المعرفي، أو إن شئت فقل الاقتصار المعرفي على ما يفيد ويضمن تسويغ العلمانية وحدها دون الدين هو ما سبب إخراجها عند الكثيرين عن كونها ممارسة معرفية، إلى اعتبارها نهجًا أيديولوجيًّا، أو إن شئت فقل: إنها الملمح الأيديولوجي للغرب.
أخيرًا بصدد السؤال الثالث:
علينا أن نفرق بين النص الديني كأصل وقاعدة للتفكير الديني، وبين التفكير الديني بنظمه وعلومه ومعارفه كحصلية للعلاقة البشرية بذاك الأصل والقاعدة. فطبيعة فهمنا مثلًا للقضايا الألوهية، وطريقة تعبيرنا عنها شيء يدخل ضمن إطار مفاهيمنا ولا يمس أصل الذات الإلهية وملاكات الفعل الإلهي أو الأمر الإلهي…
وبالتالي، فإن الحكم على القضية الدينية بأنها ثابتة ثبوتًا ضروريًّا (بمعنى الضرورة المنطقية) هو حكمٌ على نحو من الفهم الذي يعتمد القياس المنطقي كحد ونظام تعبير، وهو وجهٌ من وجوه التعبير والمعرفة ليس إلا. لذا، فقد وجدنا أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر قد اعتبر أن قضايا مثل هذا القياس محكومة ببدايات ضرورية وإلا وقعنا أسرى لمتراجعات وإحالات لا نهائية… وطبيعة هذه البدايات أنها أولية غير مستدلة، والكلام إلى هنا هو طبيعي جدًّا إلا الذي أضافه السيد الشهيد هو قوله: “إذا كان لا بدّ للمعرفة من بداية، وكانت هذه البداية تمثل معرفة أولية غير مستدلة فليس من الضروري دائمًا أن تكون هذه المعرفة يقينية، بل قد تكون احتمالية”[2].
ويصور المعرفة الأولية الاحتمالية بمجالين:
مجال الخبرة الحسية وهي قد تقوى وتضعف المعرفة فيه بحسب ما يتبدى لحواسنا من أمور.
“مجال القضايا العقلية الأولية التي يكون ثبوت المحمول للموضوع فيها ثبوتًا مباشرًا بدون تدخل الحد الأوسط، فإن هذه القضايا هي أساس كل الاستدلالات القياسية، لأن كل استدلال قياسي يثبت الحد الأكبر للأصغر بتدخل الأوسط، وتنتهي الاستدلالات القياسية جميعًا إلى حد يثبت الآخر بدون توسط حد ثالث وهذه القضايا لا يمكن إثباتها باستنباط واستدلال عقلي وإنما تدرك إدراكًا عقليًّا مباشرًا، وهذا الإدراك العقلي المباشر لها –كما يمكن أن يكون متمثلًا في أعلى درجة من درجات التصديق التي تمثل اليقين، كذلك قد يتمثل في درجات أقل من ذلك.
وما دامت بعض المعارف الأولية بالإمكان أن تحصل بقيم احتمالية في البداية، فمن الممكن تنمية هذه القيم الاحتمالية وفقًا لنظرية الاحتمال، فكلما وجدت احتمالات تتضمن تلك المعرفة الأولية المحتملة، ازدادت قيمتها الاحتمالية”.
وهكذا فقد نقل السيد الشهيد حالة الانفصام بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية بسبب ما يطلق عليه اسم التناسب والتناسق المنطقي إلى حالة من الانسجام بحسب مبدأ الانطلاق المعرفي لكليهما، وبإضافة صيغة الاحتمال فإنه يكون قد حل إشكالية إرث المنطقي في توليد القضايا الأخلاقية والقضايا المتعلقة بالإلهيات – بالمعنى الأخص – إذ في الحالتين الاحتمال هو الذي أوصلنا إلى اللازم الضروري الذي يقبل فكرة الضرورة حتى يثبت العكس. وبذلك فقد حسم معرفيًّا دعوى التأويلية العلمانية من أن الدين يعجز عن أن يوحّد منطقيًّا العلاقة التوليدية للأخلاق والسلوك عن العقائديات الإلهية المثبتة والشارحة لوجود الله وصفاته وأفعاله ومقاصده.. ليذهب (رضوان الله عليه) أبعد من ذلك بكثير حينما يعتبر أن القيمة الاحتمالية ومفادات الظن واليقين في المعرفة العلمية والمعرفة الدينية واحدة..
وإن نفي قاعدة المعرفة الدينية بأولياتها المحتملة سيساوي نسفًا لكل قاعدة معرفية علمية..
وذلك لأن الحقيقة تشير “أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة، هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر للعالم، عن طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة والتدبير، فإن هذا الاستدلال كأي استدلال علمي آخر-استقرائي بطبيعته-.. فالإنسان أمام أمرين: فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل، وإما أن يقبل الاستدلال العلمي، ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس القيمة لأن العلم والإيمان مرتبطان في أساسهما المنطقي الاستقرائي.. وقد يكون هذا هو السبب الذي أدّى بالقرآن الكريم إلى التركيز على هذا الاستدلال من بين ألوان الاستدلال المتنوعة على إثبات الصانع، تأكيدًا للطابع التجريبي والاستقرائي للدليل على إثبات الصنع” [3].
وهكذا ندرك أن التمدد في حركة التفكر والمعرفة الدينية لمعالجة الأمور بطريقة تخرج من دائرة الإسقاطات الحادة هي الجديرة سواء في الساحة العلمانية أو الكلامية واللاهوتية بإخراجنا من مآزق التشنج والتناقض، وبالتالي علينا أن ندرك أن المعرفة كما المصلحة تقضيان بأن الاقتصار على أيديولوجيا التأويلية العلمانية للدين، كما أفكار الجمود الديني السكوني ستبقى تشكل عائقًا يحول دون التوسع في التعرف على مساحات تجلي الحقيقة والمعطيات الواقعية.
واليوم بات المطلوب أن نتمعن في المدركات المعرفية المتعاونة مع كل فكرة دون الاقتصار عليها لنحاكي النص والقاعدة الدينية في مناخاتها الداخلية، وفي معطياتها الأولية لتشكل منبع الإلهام في السؤال ومنبع الثراء في الإجابة..
وهذا ما لا يمكن أن نتوفر عليه إلا إذا أعدنا قراءتنا لطبيعة الرؤية التي نحملها -من أي طرف أو انتماء كنا- بعقل نقدي استكشافي منهجي يتنظر الأمور ليولد السؤال فينتج المعرفة….
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر مقدمة كتاب “القبض والبسط في الشريعة”، عبد الكريم سروش، ترجمة دلال عباس، بيروت، دار الجديد،2002.
[2] محمد باقر الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، بيروت، دار التعارف، الصفحة 466.
[3] محمد باقر الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، مصدر سابق، الصفحة 469.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 مفتاح العبادة والسعادة
مفتاح العبادة والسعادة
السيد عادل العلوي
-
 اهتمام العاصين بأنفسهم ونسيانهم لها
اهتمام العاصين بأنفسهم ونسيانهم لها
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 معنى (حوب) في القرآن الكريم
معنى (حوب) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 الدين والعلمنة (في نظام المعرفة والقيم) (3)
الدين والعلمنة (في نظام المعرفة والقيم) (3)
الشيخ شفيق جرادي
-
 وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (6)
وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (6)
محمود حيدر
-
 لماذا نتذكر بعض اللحظات التي مرت في حياتنا وننسى غيرها؟
لماذا نتذكر بعض اللحظات التي مرت في حياتنا وننسى غيرها؟
عدنان الحاجي
-
 سرّ غضب الله
سرّ غضب الله
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 سرّ السعادة الزوجية
سرّ السعادة الزوجية
السيد عباس نور الدين
-
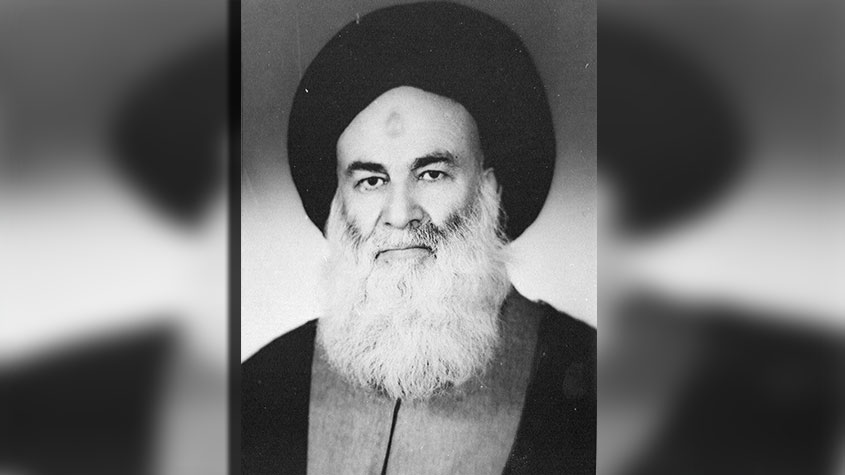 (قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ)
(قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ)
السيد محمد حسين الطهراني
-
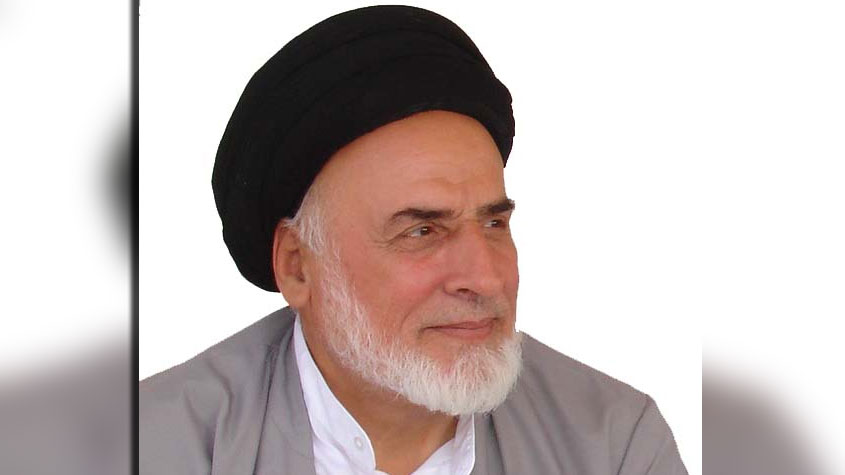 إستراتيجية الكوفة في خلافة علي(ع) (2)
إستراتيجية الكوفة في خلافة علي(ع) (2)
السيد جعفر مرتضى
الشعراء
-
 السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال
السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال
حسين حسن آل جامع
-
 على غالق
على غالق
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

مفتاح العبادة والسعادة
-
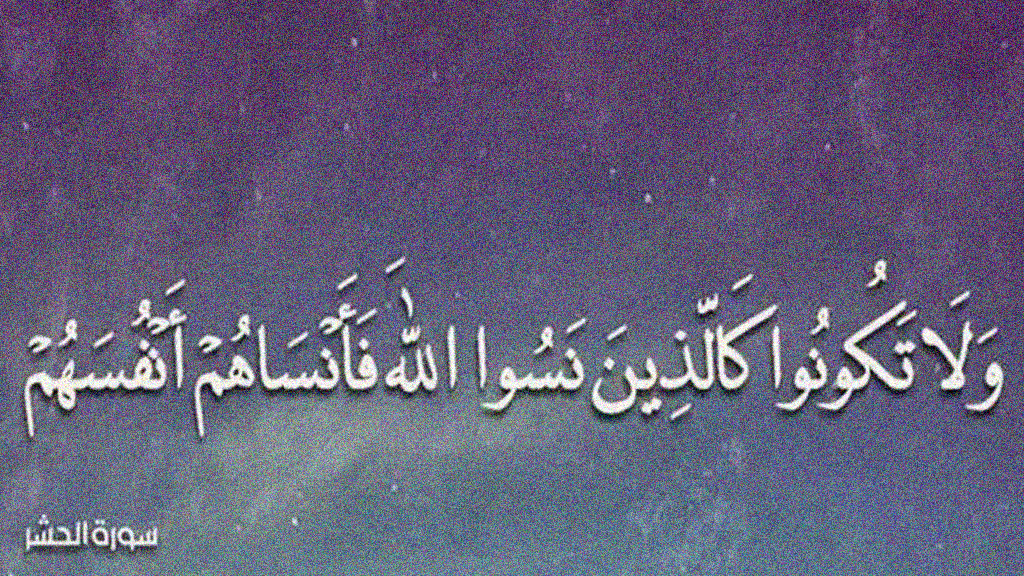
اهتمام العاصين بأنفسهم ونسيانهم لها
-
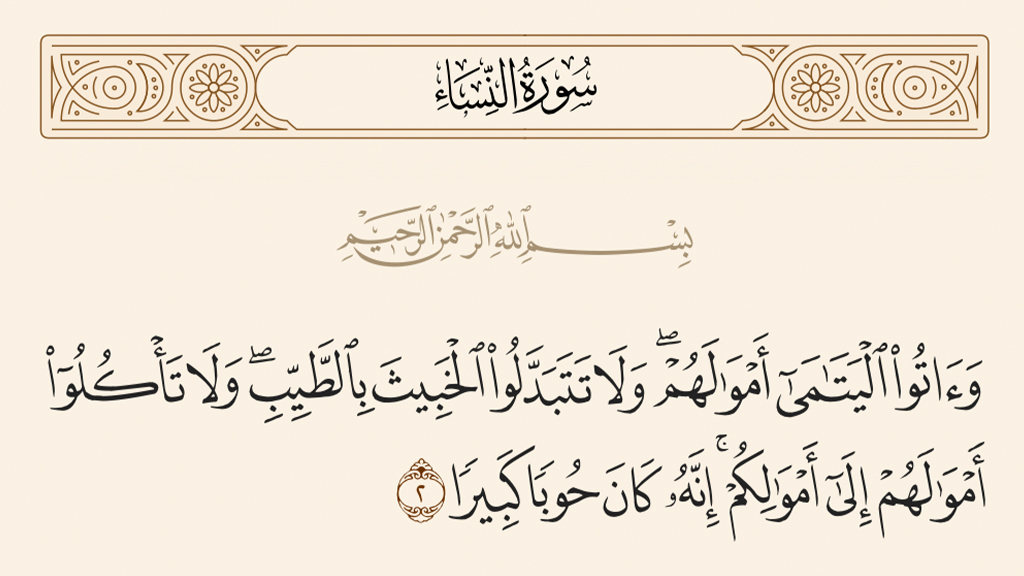
معنى (حوب) في القرآن الكريم
-

الدين والعلمنة (في نظام المعرفة والقيم) (3)
-

وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (6)
-

لماذا نتذكر بعض اللحظات التي مرت في حياتنا وننسى غيرها؟
-

المركز الثّاني للشّاعر محمّد الحمادي في جائزة راشد بن حميد للثّقافة والعلوم
-

(تجّار صغار) فعاليّة تجاريّة للأطفال في تاروت
-

سرّ غضب الله
-
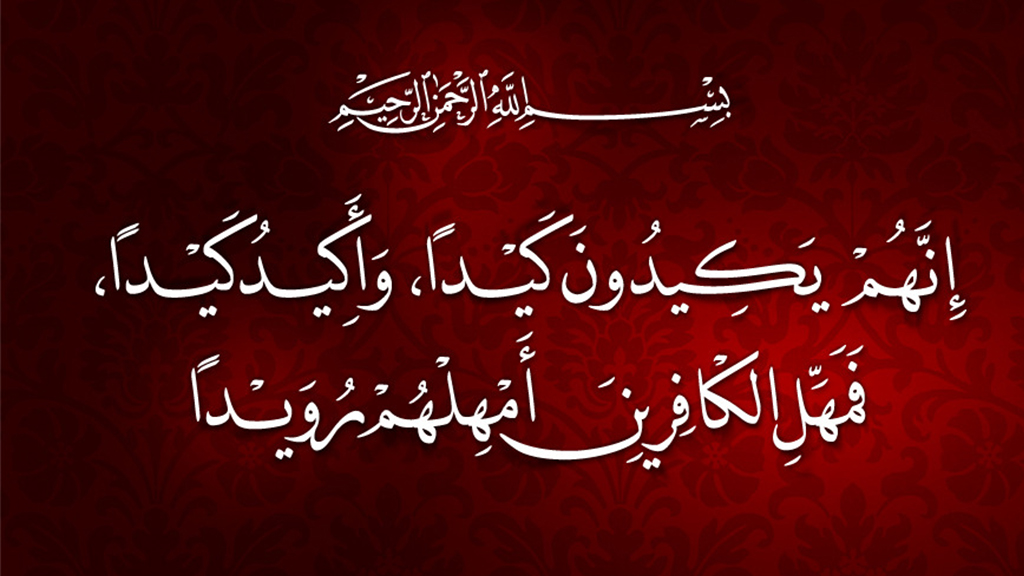
معنى (مهل) في القرآن الكريم









