مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.ما هي أولويات التمهيد؟

إنّ العنصر المحوريّ لنجاح حكومة الإمام المهديّ (عج) ومشروعه يكمن في تمتع الأنصار والأعوان الذين يعتمد عليهم في القيادة بمواصفات أخلاقية عالية، تثبّتهم على التقوى وتمنعهم من الخيانة والانقلاب على الإمام وأهدافه.
ولا يبدو أنّ تراثنا الذي تناول قضية الغيبة وأسبابها قد سلّط الضوء تسليطًا كافيًا على هذه النقطة، رغم مركزيتها وأولويتها؛ وذلك، كما يظهر، بسبب تركيزه على الأسباب والعوامل الخارجية التي أدّت إلى عدم نجاح أمير المؤمنين في تحقيق الأهداف الكبرى للإسلام. ربما وجد الكثيرون في النقد الداخلي حرجًا، بسبب إمكانية توصّل القراء إلى الظن بأنّ في هذا الإمام نقصًا ما وهو المعصوم الكامل. وبرأيي، إنّ هذا النقص والخلل يعود إلى ضعف تحليل الأوضاع النفسية والفكرية والثقافية لما يمكن أن نطلق عليه معسكر أمير المؤمنين في ذلك الزمان.
فإذا كان الناس قد انثالوا وانهالوا على الإمام مبايعين بصورةٍ لم يسبق لها مثيل (فكانت الحكومة الشعبية الوحيدة التي تشكلت منذ رسول الله صلى الله عليه وآله)، فهذا يعني توفّر الشرط الأساس الذي افتقد له الأئمة من بعده، وخصوصًا الإمام الحادي عشر الذي كان سجينًا ومحاصرًا وملاحقًا. وإذا توفر هذا الشرط الذي نطلق عليه وجود الناصر، وكان الإمام المعصوم على رأس الحكم، فما الذي يمنع من تحقق الأهداف الإلهية الإسلامية عندئذ؟ فإنّ أجزاء العلة التامة بحسب هذا التحليل قد اجتمعت؛ وعندها لن يبقى المانع سوى أن يكون وليد أسباب خارجية. وهكذا وجدنا تركيز البحوث والتحليلات على الحروب وما فيها من ضغوط هائلة والقلاقل والفتن والعداوات والمعارضات من جانب أعداء الإمام كأسباب أدت إلى تجميد حركة الإمام علي (عليه السلام) التقدمية! علمًا بأنّ كل محقق نبيه قد يعلم بأنّ الأزمات والمشاكل والتهديدات تتحول إلى فرص حين تقع بيد القائد الحكيم.
ولهذا، وجب أن نتعمّق أكثر في مدى تحقق شرط توفر الأنصار الأكفاء المناسبين لتحقيق المشروع الإلهي وإقامة الدين.
تعكس المشاهد الكثيرة التي نُقلت لنا، والمواقف العديدة التي ظهرت من الناس في هذه الأزمات والمشاكل التي واجهها أمير المؤمنين عليه السلام، نقصًا فادحًا في معرفة الناس بهذا الإمام وما يمثّله وما هي أهدافه وما هي موقعيته في الدين والتدين.
إنّ غياب السلطة الإلهية على الأرض ليس بالأمر البسيط الذي يمكن أن نمر عليه مرور الكرام، وكما قال الإمام: "السلطان وَزَعة الله في أرضه". وبواسطته يشعر الناس بحضور القوة الإلهية والهيبة التي يحتاجون إليها ليرعووا ويرتدعوا عن الأخطاء والتجاوزات، فيستقيم أمرهم. وبدون هذه السلطة الإلهية سيكونون كما أشار أحد أصحاب الإمام بعد شهادته، "كنا كأغنام فقدت راعيها تتخطفها الذئاب من كل مكان". وهناك سيتيه الناس في مسارب الضلالة والفتن العمياء، ولن يؤمن ويثبت فيها إلا الاستثناء، والباقون لن ينفعهم سوى أن يدخلوا تحت مظلة القهر الإلهي، مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم في ظل المواجهات العنيفة والصراعات الدموية مع الأعداء.
إنّ الظروف القاهرة والشديدة، وإن كانت رحمةً للمؤمنين لكي لا ينجرفوا وينساقوا إلى الدنيا والشهوات والأهواء، لكن لا ينبغي أن تصبح هي القاعدة السائدة. فالأصل لصلاح البشر هو وجود السلطان الإلهي في حياتهم الاجتماعية. هذا السلطان الذي يجعلهم يشعرون بحضور الله الرادع عن المعاصي والمحرض على الخيرات. فإن لم يتوافر السلطان الإلهي ولم تنفع الظروف الشديدة، لن يبقى سوى عذاب الاستيصال.
وقد كشفت تجربة أمير المؤمنين عليه السلام في الحكم، افتقاد المجتمع المسلم لأي نوع من المعرفة المرتبطة بالإمامة الربانية وماهية الإمام المعصوم ودوره وخصائصه، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الناس تجاهه وما يمكن أن ينجم عن التقصير بحقه. نقرأ في الزيارة الجامعة "والمقصّر بحقكم زاهق". وبسبب ذلك، افتقد هذا المجتمع، الذي عانى لأكثر من خمس وعشرين سنة من حملات تجهيل مركّزة إزاء قضية الإمامة والقيادة الإلهية، إلى محور الفضائل وركن التكامل المعنوي. وجاءت الخيانات العديدة والسلوكيات غير المسؤولة داخل فئة الكوادر والولاة، الذين كان يُفترض أن يكونوا أعوان الإمام وأنصاره لإقامة الدين، لتؤكد أنّ المشكلة الكبرى كانت تكمن في ضعف المعرفة والانتماء إلى الولاية والإمامة. ظهر ذلك في تلك الهشاشة الأخلاقية.
كان من المفترض ـ لو تم الكشف عن هذه الأزمة وتسليط الضوء عليها كما ينبغي ـ أن تتحرك أدبياتنا وتتمركز حول إطار المعضلة الأخلاقية أكثر من أي شيء آخر. لكن يبدو أنّ أولويات أخرى غلبت على حركة الممهدين أو المنتظرين، نشأ الكثير منها جراء مواجهات بعيدة عن متطلبات التمهيد الواعي والعميق.
وبالرغم من تألق الأخلاق وسط بيئة علماء أهل البيت وفي سيرتهم مقارنةً بغيرها من البيئات، لكن يمكن القول إنّ الإنتاج والعمل المرتبط بهذه الأولوية لم يكن متناسبًا مع قضية التمهيد؛ فعانت بيئة المتدينين الموالين، وعلى مدى التاريخ وفي العصر الحاضر، ممّا يشبه النزيف الأخلاقي، وتفاقمت هذه المشكلة كلما وصل هؤلاء المتدينون إلى الإمكانات والسلطة؛ حتى لتكاد تجد بيئة المسؤولين بعيدةً جدًّا عن أخلاقيات القيادة والإدارة، بل ليكاد لا يُسجل لهم أي نوع من التميز والتفوق المفترض في هذا المجال مقارنةً بغيرهم.
أين يكمن النقص؟
التراث الأخلاقي العلمي وحتى التربوي متوافر إلى حدٍّ جيد داخل البيئة الموالية لأهل البيت (عليهم السلام). فهناك مجموعة من الكتب الملهمة والشاملة والعميقة التي يمكن لأي إنسان الاستفادة منها ليصلح نفسه ويبني ذاته ويكملها ويهذبها ويخلّقها بالفضائل. ولبعض هذه الكتب تأثير كبير.
وهناك شخصيات أخلاقية تربوية يمكن أن تلهمنا وتعظنا وتساعدنا على سلوك طريق الفضيلة. وهذه الشخصيات متوفرة إلى حدٍّ ما، وخصوصًا إذا كنّا نعيش داخل الأجواء العلمية والجهادية. وفي أسوأ الحالات، لا يوجد ما يمنعنا من أن نشد العزم ونأتي إليها.
ومع أهمية الكتب العلمية والشخصيات التربوية في عالم الأخلاق والفضائل والسير إلى الله، يبقى للوجدان الأخلاقي والروحي دوره أيضًا. فتتم الحجة علينا حينئذٍ ظاهرًا وباطنًا. ولكن مع ذلك لنا أن نتساءل عن كيفية تأمين البيئة المناسبة لنموّ الفضائل وتكامل النفوس. فلا الكتب المتوافرة تصنع لوحدها هذه البيئة، ولا تواجد الشخصيات الأخلاقية كفيل بتحقيق ذلك، ولا الوجدان يبدو أنه ينتصر في معركة المغريات الكبرى للسلطة والقدرة.
والتعويل على هذه المقومات الثلاثة يبدو أنّه انتظار في غير محلّه. فكأنّ هناك شيئًا آخر ينبغي أن يتحقق لبعث هذه الحركة الأخلاقية التقدمية وثباتها.
فإذا كان النجاح الأخلاقي شرطًا أساسيًا لنجاح تجربة التمهيد وما بعدها ـ أي نجاح أنصار الإمام المهدي (عجل الله فرجه) في هذا الميدان وثباتهم على الفضيلة والزهد في الدنيا والأمانة التامة، فكيف يمكن لمن يتحرق قلبه ألمًا على فراق الإمام وغيبته أن يسعى لإيجاد هذه البيئة؟
القوة والقدرة، مهما كانت ضرورية لنصرة الإمام، لكنّ الإمام قد يتكفل بتأمينها بفضل قيادته الحكيمة. والعقل مع عظمته ومحوريته في إنجاح مشروع الإمام المهدي وبرامجه، لكن الإمام بمسحةٍ واحدة على رؤوس أصحابه يكمّل عقولهم وحلومهم.
لكن هل يمكن للإمام أن يفرض على الأنصار والأصحاب أخلاق الفضيلة والزهد والتقوى؟
قد يكون وجود الإمام وحضوره وقيادته وإدارته ذا أثرٍ كبير على النفوس، فيلهب فيها روح التكامل بقوة الاندفاع الصاروخي. وقد شاهدنا شيئًا مهمًّا من هذا التأثير العجيب في شخصية الإمام الخميني وتجربته مع الشباب والأحباب؛ لكن حين يصل الأمر إلى المسؤولين الكبار والمواقع الحساسة، يصبح معقدًا نوعًا ما، وكأنّه يتطلب ما هو أكثر من هذا العشق والحب لهذا الإمام!
نتساءل عن البيئة والعوامل التي يمكن أن تؤمن هذا المستوى من الفضيلة والكمال المعنوي، ولا نتساءل عن ضرورة وأهمية ولزوم هذا المستوى، لأنّه أمرٌ مفروغ منه. فكلما ارتقى الموالي بمسؤولياته ازدادت التحديات الأخلاقية التي سيواجهها واشتدّت.
فهل دخلنا في حلقة مفرغة، لا نجد منها مخرجًا؟ أم أنّ الحل موجودٌ، وما علينا سوى أن نكتشفه ونعمل على تأمينه؟ وهل يمكن توفير بيئة تنمية النفوس وتكميلها على طريق الفضيلة بما يضمن إعداد أنصار لا يزلّون ولا يسقطون حين تأتي الاستحقاقات الكبرى بعد ظهور الإمام؟
والحل نستنبطه من تجربة أمير المؤمنين نفسها؛ الحل يظهر بتحديد أسباب المشكلة الأخلاقية التي سقط فيها الأنصار والأعوان. وعلى رأس هذه الأسباب جهل هؤلاء بقيمة الإمام ودوره ونتائج التقصير بحقّه. فلو استطعنا أن نثبّت هذه المعاني، ولو أدرك الموالون أنّه لا يمكن أن ينفعهم أي شيء من صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد وتضحيات، إن كانوا مقصرين بحقّ الإمام ولم يعرفوه ولم يلتزموا بأولوياته لبدأ عصرٌ جديد لثقافة يمكن أن تؤسّس لتلك البيئة الأخلاقية السامية.
روى أبو عبد الله محمد بن سهل الجلودي، قال: حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد بن جعفر الطائي الكوفي في مسجد أبي إبراهيم موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن يحيى الحارثي، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي، قال:
خرجت في بعض السنين حاجًّا، إذ دخلت المدينة وأقمت بها أيامًا، أسأل وأستبحث عن صاحب الزمان (عليه السلام)، فما عرفت له خبرًا، ولا وقعت لي عليه عين، فاغتممت غمًّا شديدًا وخشيت أن يفوتني ما أملته من طلب صاحب الزمان (عليه السلام)، فخرجت حتى أتيت مكة، فقضيت حجتي واعتمرت بها أسبوعًا، كل ذلك أطلب.
فبينا أنا أفكر إذ انكشف لي باب الكعبة، فإذا أنا بإنسان كأنّه غصن بان، متّزر ببردة، متشح بأخرى، قد كشف عطف بردته على عاتقه، فارتاح قلبي وبادرت لقصده، فانثنى إليّ، وقال: من أين الرجل؟ قلت: من العراق. قال: من أي العراق؟ قلت: من الأهواز. فقال: أتعرف الخصيبي؟ قلت: نعم. قال: رحمه الله، فما كان أطول ليله، وأكثر نيله، وأغزر دمعته! قال: فابن المهزيار. قلت: أنا هو. قال: حياك الله بالسلام أبا الحسن.
ثمّ صافحني وعانقني، وقال: يا أبا الحسن، ما فعلت العلامة التي بينك وبين الماضي أبي محمد نضر الله وجهه؟ قلت: معي. وأدخلت يدي إلى جيبي وأخرجت خاتمًا عليه "محمد وعلي"، فلما قرأه استعبر حتى بل طمره الذي كان على يده، وقال: يرحمك الله أبا محمد، فإنّك زين الأمة، شرفك الله بالإمامة، وتوجك بتاج العلم والمعرفة، فإنّا إليكم صائرون. ثم صافحني وعانقني، ثم قال: ما الذي تريد يا أبا الحسن؟ قلت: الإمام المحجوب عن العالم. قال: ما هو محجوب عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم، قم إلى رحلك، وكن على أهبة من لقائه، إذا انحطت الجوزاء، وأزهرت نجوم السماء، فها أنا لك بين الركن والصفا. فطابت نفسي وتيقنت أنّ الله فضلني، فما زلت أرقب الوقت حتى حان، وخرجت إلى مطيتي، واستويت على رحلي، واستويت على ظهرها، فإذا أنا بصاحبي ينادي إليّ: يا أبا الحسن.
فخرجت فلحقت به، فحياني بالسلام، وقال: سر بنا يا أخ. فما زال يهبط واديًا ويرقى ذروة جبل إلى أن علقنا على الطائف. فقال: يا أبا الحسن، انزل بنا نصلي باقي صلاة الليل. فنزلت فصلى بنا الفجر ركعتين، قلت: فالركعتين الأوليين؟ قال: هما من صلاة الليل، وأوتر فيها، والقنوت في كل صلاة جائز. وقال: سر بنا يا أخ. فلم يزل يهبط بي واديًا ويرقى بي ذروة جبل حتى أشرفنا على واد عظيم مثل الكافور، فأمد عيني فإذا ببيت من الشعر يتوقد نورًا، قال: المح، هل ترى شيئاً؟ قلت: أرى بيتًا من الشعر. فقال: الأمل. وانحط في الوادي واتبعت الأثر حتى إذا صرنا بوسط الوادي نزل عن راحلته وخلاها، ونزلت عن مطيتي، وقال لي: دعها. قلت: فإن تاهت؟ قال: هذا وادٍ لا يدخله إلا مؤمن ولا يخرج منه إلا مؤمن. ثم سبقني ودخل الخباء وخرج إليّ مسرعًا، وقال: أبشر، فقد أُذن لك بالدخول.
فدخلت فإذا البيت يسطع من جانبه النور، فسلمت عليه بالإمامة، فقال لي: يا أبا الحسن، قد كنا نتوقعك ليلًا ونهارًا، فما الذي أبطأ بك علينا؟ قلت: يا سيدي، لم أجد من يدلني إلى الآن. قال لي: لم تجد أحدًا يدلك؟ ثم نكث بإصبعه في الأرض، ثمّ قال: لا ولكنكم كثرتم الأموال، وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين، وقطعتم الرحم الذي بينكم، فأي عذر لكم الآن؟
فقلت: التوبة التوبة، الإقالة الإقالة. ثم قال: يا ابن المهزيار، لولا استغفار بعضكم لبعض لهلك من عليها إلا خواص الشيعة الذين تشبه أقوالهم أفعالهم. ثم قال: يا ابن المهزيار ـ ومد يده ـ ألا أنبئك الخبر أنّه إذا قعد الصبي، وتحرك المغربي، وسار العماني، وبويع السفياني يأذن لولي الله، فأخرج بين الصفا والمروة في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا سواء، فأجيء إلى الكوفة وأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه الأول، وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة، وأحج بالناس حجة الإسلام، وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة، وأخرج من بها وهما طريان، فآمر بهما تجاه البقيع، وآمر بخشبتين يصلبان عليهما، فتورق من تحتهما، فيفتتن الناس بهما أشد من الفتنة الأولى، فينادي منادٍ من السماء:
"يا سماء أبيدي، ويا أرض خذي" فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قلبه للإيمان. قلت: يا سيدي، ما يكون بعد ذلك. قال: الكرة الكرة، الرجعة الرجعة، ثم تلا هذه الآية: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً﴾ (الإسراء: 6)
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
الشيخ مرتضى الباشا
-
 كيف نحمي قلوبنا؟
كيف نحمي قلوبنا؟
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 معنى (فلك) في القرآن الكريم
معنى (فلك) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
السيد عباس نور الدين
-
 إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾
الشيخ محمد صنقور
-
 علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 الفرج سيأتي وإن طال
الفرج سيأتي وإن طال
عبدالعزيز آل زايد
-
 بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
النظام الاقتصادي في الإسلام (4)
الشهيد مرتضى مطهري
الشعراء
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات
حسين حسن آل جامع
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 أزليّة في موسم العشق
أزليّة في موسم العشق
فريد عبد الله النمر
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟
-

كيف نحمي قلوبنا؟
-
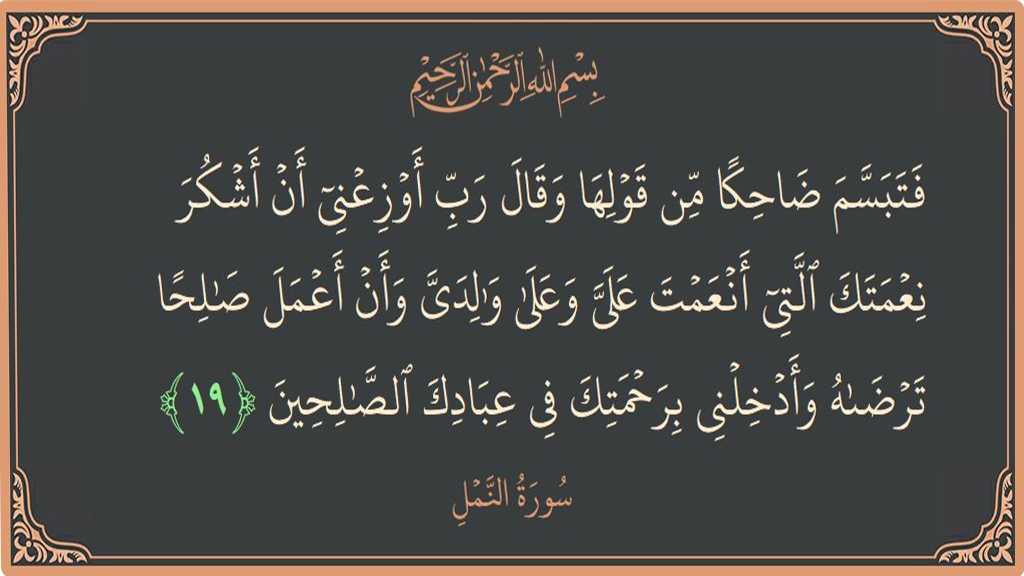
(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)
-

معنى (فلك) في القرآن الكريم
-
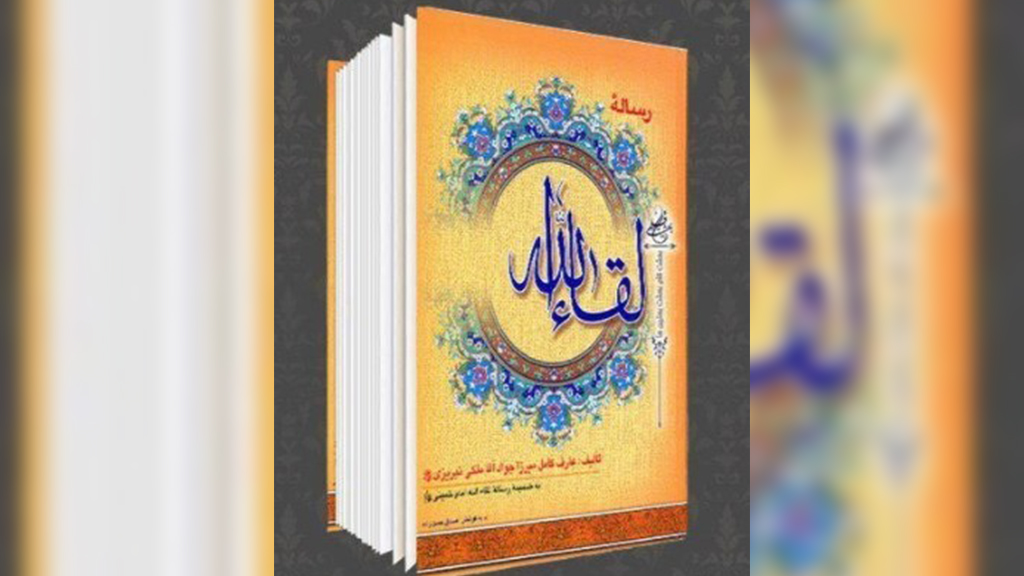
قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي
-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب
-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا
-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش
-

هذا مهم، وليس كل شيء
-
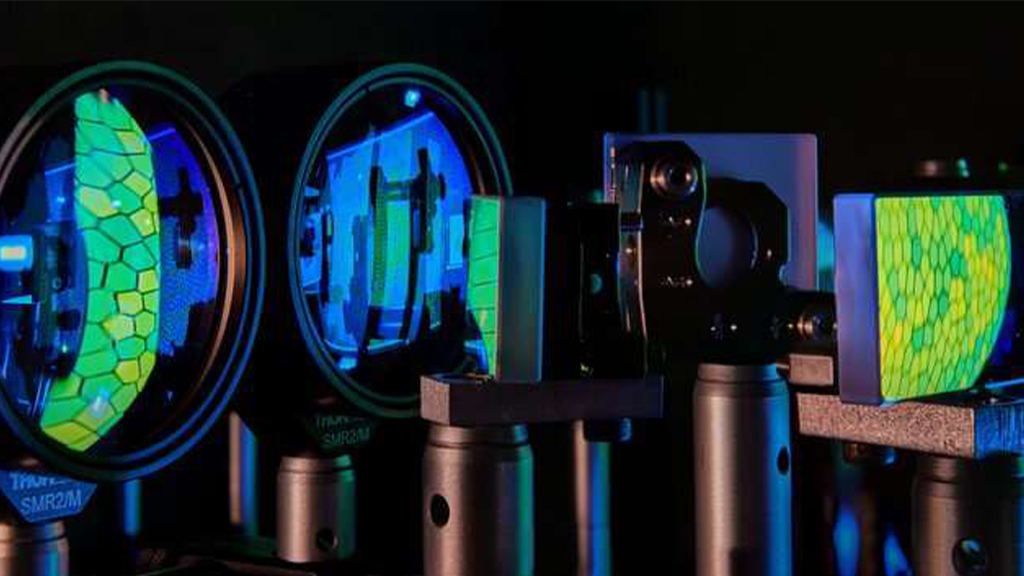
كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟









