مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.في البحث عن قيادة سيد الشهداء(ع)

إنّ الهدف الأعلى لوجودنا على هذه الأرض يتمثّل في وصولنا إلى مقام شهود الحق المتعالي وراء حجاب الدنيا والطبيعة، ومعها وفيها أيضًا.
إذا ظفر الإنسان بهذه الفرصة التي لن تتكرّر ــ لأنّه من كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلا[1] ــ يكون قد بلغ الكمال الأعلى، شرط أن يصبح هذا الشهود عنده اختياريًّا ودائميًّا. ولأنّ هذه الطبيعة وما فيها هي آيات شهود هذه الحقيقة، فلا يُفترض أن يغفل الإنسان عن ربّه طرفة عين.
وأقوى من آيات الطبيعة آيات الأنفس، حيث أُعطي كل إنسان نفخة الروح الإلهيّة، وبذرة العلم الحضوري في ذاته وعمق نفسه. أمّا الساحة الاجتماعية فهي ميدان الرجوع إلى النفس، حيث التفاعل والتقابل والتضاد بين الأنفس، والذي يظهر أحيانًا بصورة العداوات، قال تعالى: {قالَ اهْبِطا مِنْها جَميعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ}.[2]
إنّ غفلة الإنسان عن نفسه تقتضي أحيانًا أن يواجه تحدّيات، من نوع ما يصنعه الأنبياء والمرسلون في الحياة الاجتماعية، حيث تتم زلزلة النّفوس واستخراج ضغائنها وخباياها، بالتعرُّض لعقائدها وتوجُّهاتها وتحدي ما اعتادت عليه من أفكارٍ ورؤى.
{قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ * قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ * قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ * فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ}.[3]
إنّ الفن الأعلى لأيّ قائدٍ إلهيّ يكمُن في قدرته على التأثير في الأوضاع الاجتماعية لإحداث مثل هذا الزلزال الذي يؤدّي إلى بعث ذلك الشعور والإدراك والشهود. وحتى لو كان الحدث طارئًا ويحصل مرّة واحدة، يمكن البناء عليه وتبديله من حالٍ إلى مقام، ومن لحظةٍ عابرة إلى معرفةٍ دائمة. لهذا كانت المعاجز، التي هي آيات قدرة الله وحضوره. وبعض أفعال الأولياء في الحياة الاجتماعية يكون تأثيرها كالمعجزة، وإن لم تكن مصحوبة بدعوى النبوّة.
القائد الإلهي هو الذي يتمكّن من تحطيم جدار الغفلة المبنيّ من المنظومة الاجتماعية والأنظمة السياسية، وذلك عبر تحدّي هذه الأنظمة ومهاجمتها في عقر دارها. فيكشف عن هشاشتها وضعفها ويُحطّم استكبارها واستعلاءها، بل ويسخر من طواغيتها ويجعل منهم هزوًا للناس، فيُظهر بذلك عظمة القدرة الإلهية.
لا شيء يريده أمثال هؤلاء القادة في هذه الحياة الدنيا أعلى من هذا الهدف، سواء تحقّق بحكومة أو لا. ولكي يُفلح القائد الربّاني في هذه المهمة يحتاج إلى أمرٍ واحد في هجومه على النظام الطاغوتيّ، وهو أن يصبح في قيادته مظهرًا تامًّا لإرادة الله وقدرته، الأمر الذي لا يحصل سوى بذوبانه وفنائه في هذه الإرادة والقدرة.
وقد نتصوّر لأول وهلة أنّ هذا قد يتعارض مع ظهور عظمة هذا القائد، التي هي رصيده الأول في جذب الأتباع والموالين. ونتصوّر نوعين من القادة؛ قائدٌ مسلم مطيع منقاد بالكامل لإرادة الله ومشيئته، وقائدٌ ذكيّ عبقري يعرف عدوّه جيدًا ويضع الخُطط الاستراتيجية (التي هي حكر على أعلى مستوى في القيادة). وهكذا، نظن أنّه كلما ظهر ذكاء هذا القائد وعبقريته اختفت عظمة الله وقدرته. ومثل هذا الظن قد يُصيب حين لا يصل القائد إلى مرحلة الفناء والتسليم المطلق؛ فما يبقى من نفس القائد وإرادته سيكون حجابًا بدل أن يكون آية.
لكنّ القائد الذي يُفني إرادته في إرادة الحق سيكون الحق سمعه وبصره ويده ولسانه، فتظهر عليه جميع صفات العظمة والكمال الإلهي. ولا يحتاج البشر من أجل بلوغ ذلك الهدف إلى قائدٍ ذكي مُحنّك خبير، بقدر ما يحتاجون إلى من يقودهم نحو برّ الأمان ويأخذ بأيديهم باتجاه منازل العزّة والكرامة. فإذا ما شاهدوا هذه النتائج والآثار آمنوا به واتّبعوه.. أجل، إنّ تحقيق النتائج الاجتماعية العظيمة يحتاج إلى اقتناع بعقل القائد وحكمته وعلمه وذكائه، وهذا ما يقع على عاتق التدبير الإلهي نفسه.
إنّ قصة موسى الكليم تحكي وتبين لنا كل ما نحتاجه لفهم طبيعة عمل القادة الربّانيين، حيث نجد أنّ الله تعالى بدأ عملية ترسيخ قيادة هذا النبيّ العظيم بموقفٍ يحكي عن قدرةٍ تحدّت جبروت فرعون مدّعي الألوهية. صحيح أنّ بني إسرائيل احتاجوا ـ أو هم طلبوا ـ مزيدَ آياتٍ لكي يؤمنوا بموسى، وما آمن له إلا ذريّة من قومه على خوفٍ من فرعون أن يفتنهم؛ لكن إذا أراد الله لشعب أو أُمّةٍ هدايةً تُخرجهم من بؤس العبودية لحكّام الجور وأنظمة الاستكبار، وفّقهم لقائدٍ مصحوب بآيةٍ منه تدلّ على سلطته وملكه (والملك هو التعبير القرآني للقيادة) حتى لو كانت الآية تابوتًا تحمله الملائكة فيه تسكين للقلوب المضطربة.
إنّ التعارض الذي يتصوّره السُذَّج بين تدبير الله وتدبير القائد، مما يضطرنا لإثبات ذكاء هذا القائد وعبقريّته، هو تعارض موجود في عالم الذهن فقط، ولا يرد في عالم الواقع أو عالم الإمكان. وفي غمرة حرص القائد الإلهي على إظهار عبوديته وفنائه في الله، تصبح حقيقة كونه عالـمًا خبيرًا أكثر جلاءً وظهورًا. لأنّ ما سيظهر على يد هذا القائد من إنجازات، سيراها العقلاء المميّزون أعلى مراتب التدبير والحكمة، دون أن يشكّل ذلك حجابًا أمام أبصارهم يمنعهم من شهود حضور الله فيها. وهذا ما حصل للسحرة حين رأوا خوف موسى، وعلموا بذلك أنّه ليس بساحرٍ، ثمّ شاهدوا عظيم فعله، فاجتمع عندهم عظيم القدرة ومنتهى العبودية، وخرّوا سجّدًا في موقفٍ زلزل عرش فرعون على طريق مواقف القضاء عليه.
وحين نقول إنّ عاشوراء قد كانت تدبيرًا إلهيًّا خالصًا ـ تشهد عليه عشرات النصوص المعتبرة ـ فذلك لا يعني أنّ الإمام الحسين (ع) قد خسر فرصة الظهور بمظهر القائد الـمُحنّك، بل القائد الاستراتيجي الذي ينظر في حركته إلى القرون الآتية. إنّ هذه الازدواجيّة التي حسمها الكثير من القرّاء باتّجاه التركيز على مظلومية الإمام الحسين وكونه منفعلًا تجاه الآخر، إنّما حصلت نتيجة ذلك التعارض الذي شكّل عمق النزاع والخلاف العقائدي ليس في أمة الإسلام فحسب، بل في أمّة النصارى أيضًا.
ربما حسم الكثير من المسلمين الأمر باتّجاهٍ ما يشبه الجبر، وربما حسم العالم المسيحي الأمر باتّجاه التفويض ـ لكنّ الخاسر الأكبر هو البشرية التي لم تقدر على الجمع بين الأمرين، أمر الجبر وأمر التفويض، كما لم تقدر على اكتشاف أمر الظهور والتعرّف على حقيقة التجلي. فالفن الأعلى للإمام الحسين سيكون في إظهار منتهى الخضوع والتسليم لله (والذي قرأه كثيرون على أنه خفاء الحكمة الكامنة في عاشوراء، كما يفعلون في تحليلهم لأسباب طول غيبة الإمام الثاني عشر). ولأنّ أمر عاشوراء أمرٌ سماويّ أكثر منه أرضيّ، ولأنّ أمر السماء هو أمر الغيب، ولأنّ عالم الغيب سوف يُصبح شهادةً يومًا ما على الأرض، فإنّ هذا الإمام قد ترك تفسير عبقرية عاشوراء واكتشاف حكمتها للأجيال البعيدة، التي نسأل الله تعالى أن يجعلنا منها.
كان على الإمام الحسين(ع) أن يركز في مواقفه العاشورائية على كون نهضته إرادة الله ومشيئته؛ وهذا ما ظهر بوضوح في ردّه على الناصحين، خصوصًا الذين عرضوا جانبًا من المنطق والحكمة العملية، وكأنّه يقول لهم: إنّكم لن تعيشوا لتروا الحكمة البالغة في عاشوراء، ولن ينفعكم شرحي وبياني إن كنتم تعقلون.
كلُّ هدفٍ استراتيجيّ بعيد المدى يُصبح كالغيب المجهول بالنسبة لأهل الحاضر. ولا يُنقذهم من ضلالة الحيرة وعدم المعرفة بهذه الأهداف سوى نسبة الفعل (الذي يتّجه نحو ذلك الهدف البعيد) واعتباره أمرًا إلهيًّا محضًا. فإذا كانوا مؤمنين بعصمة صاحب الفعل نجوا وعُصِموا، وإلا كانوا من الهالكين في بحر الفتنة العميق.
أجل، كانت عاشوراء فتنةً كبرى، ليس للمجرمين الذين سقطوا في الفتنة قبل وقوعها فحسب، بل للمؤمنين الذين كانوا يشاهدون أمرًا لا يمكن لعقولهم تفسيره واستيعابه. فتساءلوا كيف يسمح الله تعالى بوقوع مثل هذا على أحب الخلق إلى نبيّه؟! ولولا تلك الحرارة التي جعلها الله في صدورهم والتي ستتنفس بكاءً ولوعة، لاحتقن الحزن وفجّر كياناتهم ولما أبقى منها شيئًا!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]. راجع الآية 72 من سورة الإسراء.
[2]. سورة طه، الآية 123.
[3]. سورة الأنبياء، الآيات 51-58.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
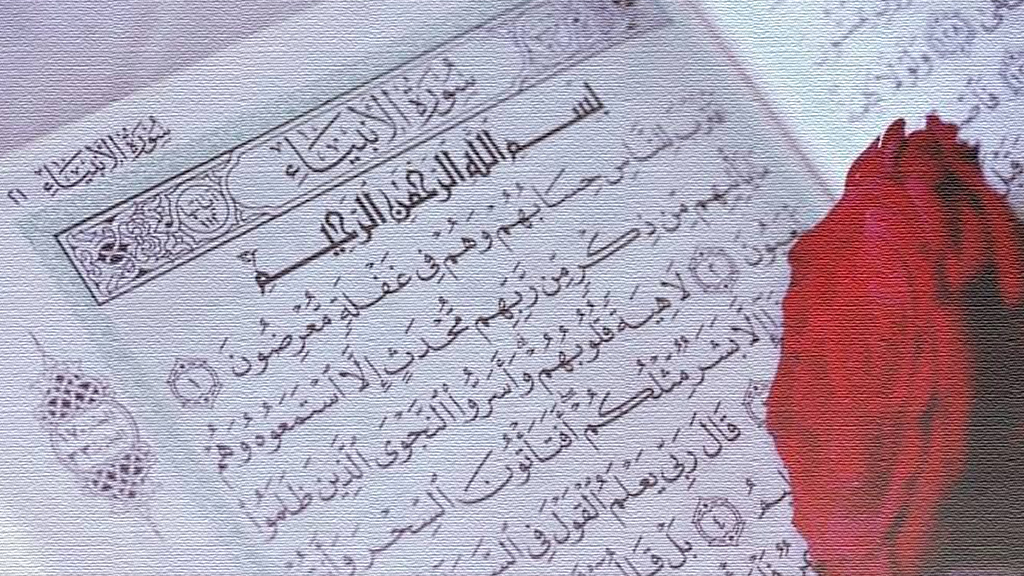
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










