مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.الحسين (ع) يصنع ملحمة خالدة

حين قام الإمام الحسين (ع) بملحمة عاشوراء، كانت الخطة تقضي بأن تبقى عاشوراء شعلةً تُضيء دروب المسلمين الباحثين عن حقيقة الإسلام أينما كانوا. إنّ بقاء رسالة عاشوراء حيّة هو أحد الأهداف الكُبرى للإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام.
جانبٌ مهم من استمرار فعالية هذه الرسالة يكمن في بقاء أتباع المعسكرين. سيكون في كل زمان حسينيون، وسيكون في كل زمان أُمويون. أما تأسيس النهج الأُمويّ واستمراره فقد تطلّب القيام بعملية تفسير جديدة للإسلام ومذهبة هذا التفسير لتسهيل الانتماء والانتساب إليه، وجعله تراثًا ينتقل من جيلٍ إلى جيل. لكن هذا التمذهُب ما كان ليبقى ويُحفظ دون حكومات وسلطات سياسية تُشاد بدورها على نظامٍ سياسي وفكرٍ اجتماعي مُحدَّد. هكذا أُعيد تشكيل الإسلام من أجل إنتاج دينٍ أُمويّ، فكان إسلامًا يتم تناقله على مدى العصور، وإن زالت السلالات الحاكمة. لقد تمظهر هذا الدين في كل حقبة عبر أنظمة سياسية وحكومات تقوم على الغلبة والقهر. ولن نحتاج إلى فلسفة عميقة لتوصيف هذا الواقع السياسي أينما استتب وحكم في أي بقعة من العالم الإسلامي. فانعدام مشاركة الجماهير في تقرير مصيرها كان دائمًا دليلًا عليه.
رغم الجهود الكبيرة التي بذلها عددٌ كبير من العلماء والقرّاء والأمراء لإضفاء الشرعية على الدين الأُمويّ وتقديمه كنسخة أصيلة عن الإسلام، فإنّ أداءه السياسيّ المشؤوم كان هو الذي يكشف زيفه ويزيح القناع عن وجهه الحقيقي. كانت الوقائع والـمُواجهات الداخلية والخارجية واستحقاقات البناء كفيلة بفضح هذا المعسكر. ولكن ماذا عن معسكر الحسين الشهيد! هل استطاع أن يتشكّل أينما دعت الحاجة، وكما أراد الحسين عليه السلام عند بروز ذاك الـمُعسكر الأموي؟
إنّ وقائع التاريخ تُظهر لنا مدى صعوبة هذا الأمر أو عدم تحققه كما ينبغي، رغم أنّ الإمام الحسين (ع) قد أتقن عمله إلى أبعد الحدود من أجل إظهار خصائص معسكره وخصاله يوم العاشر من محرّم؛ وقد قام بكل ما يُمكن أن يقوم به قائد عظيم من أجل تصفية هذا المعسكر وتنقيته من كل شائبة ووهم. لكن عبث الجاهلين على مدى العصور، يبدو أنه استطاع أن يُفرغ هذا القيام الحسيني من أهم مضامينه وأوضح بيناته. الجدال الذي ساد داخل محبّي هذا المعسكر حول البكاء والتباكي على هذه المصيبة، وانقسامهم ما بين من جعل البكاء كلّ شيء فيها، وبين من اعتبره فعل الضعفاء والخانعين، هذا الجدال الدائم المتجدّد، لهو مؤشّرٌ قويّ على الأزمة التي عاشها هذا الفكر في بعض مراحل التاريخ، والتي حالت دون انبعاثه وتشكُّله في أحلك اللحظات المصيرية.
انتفاضات عديدة انطلقت من وحي عاشوراء، لكنّها لم تُحدث ذلك التغيير الذي يتناسب مع قوتها ويليق بحجم إنجازاتها. مجالس العزاء والإحياءات هي من أبرز مظاهر هذه الانتفاضات التي يُعلَن فيها بكل وضوح عن رفض النّهج الأموي والبراءة منه؛ ومع ذلك، كانت النتائج والآثار محدودة جدًّا قياسًا بالأهداف التي رسمها هذا الإمام الشهيد لقيامه وعاشورائه. فهل عجز هذا المعسكر عن أن يتشكّل في أغلب هذه المواطن والمحطات، نتيجة عدم فهم حقيقة عاشوراء؟
إنّ الإجابة عن هذا السؤال تستدعي قراءة مُعمَّقة لهذا القيام، تنطلق من معرفة صحيحة ودقيقة للإمام الحسين (ع)؛ وذلك قبل أي شيء، لأنّ هذا القيام وهذه الملحمة كانا صنع يديه بامتياز، وإن كانت مقدمتهما قد تشكلت وأُعدت بيد الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله. وحين تُصبح الثقافة المسيطرة على الانتفاضات العسكرية والسلميّة (المدنية) ثقافة التفجُّع والمظلومية، وتختفي معها تلك الحقيقة الكبرى، فمن الطبيعي أن لا نشعر بالحاجة إلى التعمُّق في معرفة هذا القائد! يكفي أن نستحضر قرابته وقربه من رسول الله (ص) حتى يحصل الأثر المطلوب من شحنٍ وتفجيع؛ بل إنّ قضية النساء والأطفال وحدها ستكون كفيلة بإثارة الأحزان وذرف الدموع التي تغفر الذنوب جميعًا!
وحين تنطمس المعالم الكبرى لشخصية الإمام الحسين (ع)، لا شيء من كربلاء يمكن أن يعرّف على حقيقته، فتفقد عاشوراء بذلك قدرتها الواقعية على التشكُّل كقوّة اجتماعية تصنع الأحداث الكبرى. هذا ما جرى مع تلك القوة الكبيرة التي عُرفت بثورة التوّابين وانتفاضتهم العسكرية بعد مدة قصيرة من واقعة عاشوراء. ورغم الحماسة المنقطعة النظير التي ظهرت من أفراد هذا الجيش، ومقتلهم جميعًا في المعركة، والبسالة العجيبة والثبات في القتال، فقد ذهبت هذه الواقعة أدراج الرياح ولم تترك أثرًا يُذكر في التاريخ.
إنّ جيشًا قوامه أربعة آلاف مقاتل مندفع بقوةِ وعزمِ الموت في سبيل القضية لهو جيشٌ لا يهزم. ولكنّنا رأينا كيف أصبح التوّابون عبرة للانتفاضات العشوائيّة الحماسية الانفعالية التي تفتقد إلى الحكمة والتدبير والقيادة. إنّني ومنذ أكثر من ثلاثين سنة أُراقب وأتأمّل في آثار الانتفاضات السلمية التي تحدث في مجالس الإحياء، حيث تُرفع وترتفع كل شعارات العزّة والإباء ورفض الظلم، فأجد هذه الآثار منحصرة إلى حدٍّ كبير في الانفعالية، وتتجلّى فقط في المواقف الشجاعة التي يُحشر فيها الإنسان في زاوية المصير المشؤوم! بدل أن تُصبح عاشوراء مُنطلقًا لأعلى مستويات الفاعلية والتقدُّم. فما الذي جعل مثل هذه الملحمة الخالدة منحسرة إلى حدٍّ كبير في الآثار العاطفية العابرة.
والسبب ولا شك هو إنّ الذين يشاركون في هذه الانتفاضات ــ المجالس بحاجة إلى معرفة من الذي خرج في عاشوراء ومن الذي قُتل فيها، ليدركوا ما الذي خرج وما الذي قُتل، عسى أن تتوجّه عواطفهم ومشاعرهم نحو الأهداف التي أرادها الإمام الحسين (ع) من عاشوراء.
لو جئنا إلى شعوب العالم قاطبةً، فلن نرى تجمُّعًا مُفعمًا بهذا المستوى من العواطف والأحاسيس مثل هذا التجمُّع الذي يُقيمه المنتمون إلى عاشوراء؛ بل إنّنا لن نقدر على قياس الفارق الموجود بين هذا الاجتماع وغيره على مستوى الشحن العاطفي والشعوري.
وكل مُصلح أو مفكر أو صاحب مشروع تغييري، سيحلم بهذا المستوى من التجييش العاطفي لإلقاء أفكاره وإقناع الجماهير بأطروحته ومشروعه.
الجماهير التي تصل إلى هذا المستوى من التفاعُل الشعوريّ هي أقرب ما يكون إلى الفعل والإقدام على أي شيء، مهما كان مُكلفًا وتطلّب عظيم التضحيات.
وباختصار، إنّ الأفعال التي تنجُم عن هذه الانتفاضات لا تنسجم أبدًا مع حجم المشاعر التي تقف خلفها.. أجل، كان هناك فعلٌ بحجم ثورة اقتلعت عرش طاغوتٍ مستبد حين استطاع رائده الإمام روح الله الخميني أن يوجّه تلك المشاعر ويصنع من البكاء سيولًا جرفت نظام ظلم عتيد. ولا شك بأنّ نجاح الإمام في تشكيل معسكرٍ عاشورائي بكل ما للكلمة من معنى، إنّما يرجع إلى عاملٍ أساسيّ يرتبط بحقيقة الإمام الحسين(ع)، حيث ظهر هذا السيد الموسوي كممثّل لهذه الحقيقة، واستعاد إلى المشهد الاجتماعي مبدأ الإمامة الإلهية في أهم معانيها، وهو العلم.
لقد قال هذا السيد: "إن كل ما لدينا هو من عاشوراء"، مؤكدًا على أنّ الذي انتصر في هذه الثورة الاجتماعية السياسية هو دم الإمام الحسين(ع) على سيف يزيد عصره. ومن جانبٍ آخر قال خليفة هذا السيد: "إنّ ثورة الإمام الخميني كانت ثورة العلم". ولو لم يكن قائد هذه الثورة الحسينية المعاصرة عالـمًا ووصل إلى أعلى مراتب العلم الممكنة لغير المعصوم، لما استطاع أن يوجّه مشاعر الجماهير العاشقة للحسين (ع) والملتهبة بفاجعته توجيهًا كان كامنًا في عمق دعوة سيد شباب أهل الجنة.
ما كان اجتراء المسلمين على ارتكاب هذه الجريمة العُظمى بحق سبط نبيهم إلا بعد أن جهلوا مقام هذا الإمام ولم يعرفوا كمالاته. لكن المؤسف حقًّا هو أن يستمر هذا الجهل ويُصبح علامة فارقة في المجتمعات التي تحمل الكثير من المودة والحب لهذا الإمام.. ألم تسنح لنا الفرص تلو الفرص لإظهار هذه الحقيقة؟ فهل الحديث عن المقام العلمي لسيد الشهداء سيُخفف من غلواء العاطفة التي نريدها في هذه الانتفاضات؟ وهل بيان أسرار علم هذا الإمام يُجفف الدموع من المآقي؟
لا بدّ أن نعترف بأنّ إحياء عاشوراء في المجتمعات المحبّة لأهل البيت حقًا قد خضع للثقافة التي سادت في مجالسها على مدى العصور وفي مختلف الأماكن. ومن الطبيعي أن يكون التأثير الحاصل من هذا الإحياء بحجم الفكر المصبوب فيه، لا من المشاعر الناتجة عنه. ففي النهاية، الفكر هو الموجّه للطاقات التي تنبع من العواطف والأحاسيس، وذلك مهما كانت هذه الأحاسيس جياشة. وإذا كانت النتيجة تتبع أخس المقدّمتين، وكان الفكر هو المقدّمة الأولى، والإحساس هو المقدّمة الثانية، فإنّ النتيجة ستأتي بحسب الأضعف منهما.
إنّ إحياء عاشوراء بهذا النوع من المجالس والمناسبات، وباستخدام كل فنون التعبير والتي تتّسع وتتعمّق يومًا بعد يوم، هو الذي يبقي هذه الثورة مشتعلة والحركة الإصلاحية متّقدة، لكنّه في الوقت نفسه يتحكم بها ويحدد نتاجها. وما لم نكتشف عمق الفاجعة ونكشف عنها في هذا الإحياء الذي هو تعبير عن الانتفاضة السلميّة، فإنّنا لن نقدر على تحقيق ما أراده الإمام الحسين (ع) وأراده رسول الله (ص)، بل ما أراده الله تعالى لإحياء دينه وإقامته.
فإنّ الله تعالى قضى وقدّر أن يكون محمد (ص) رسول الله وخاتم النبيّين. ولأجل هذا الختم وبقاء الدين، كان لابد من فعل وتضحية وجهاد وأثمان، وكانت تضحية رسول الله (ص) بحفيده الحسين (ع) ونسائه وأهل بيته (ع) بتلك الطريقة المفجعة، من أكبر الأثمان التي قبِل هذا النبي أن يدفعها طائعًا مختارًا، لأجل حفظ الإسلام ودوامه.
لكن هذا الحفيد الـمُضحَّى به كان ينبغي أن يكون إنسانًا كاملًا يتّصف بجميع الفضائل بأعلى درجاتها؛ وكان على رأس هذه الفضائل فضيلة العلم. ولم تكن التضحية بالحفيد أو الولد هي المقصودة بالذات. فرسول الله(ص) علم أنّ نجاح هذه الخطة مرهون بأن لا يكون له نسل إلا من علي بن أبي طالب (ع)، وهذا ما اقتضى أن يرى أولاده القاسم وإبراهيم يرتحلان عن هذا العالم تاركين لوعةً وحزنًا يفتّت الصخور.
فهذه التضحية كان ينبغي أن تكون بحفيدٍ خاص مُحدَّد المعالم والصفات، وليد ظروفٍ وأوضاع، ممثّل نهجٍ ومسار؛ فهو ابن فاطمة (ع) الابنة التي من آذاها فقد آذى الله، وهو ابن عليّ (ع) فاتح عهد الإمامة الإلهية، وهو سليل العصمة ووريث علم النبيّين، مَجمع المجد والكرم، ومَبلغ العلم والحلم، وعُصارة كمال الأولياء وأوج الفضيلة والإنسانيّة.
هذا هو الذي كان على النبيّ الأكرم (ص) أن يقدّمه في كربلاء لقاء حفظ دينه. وأيّ شخصٍ آخر ما كان ليحقق شروط هذا القربان الذي أعلنت عنه زينب بنت علي (ع) نيابةً عن أهل بيت النبوّة في العاشر من محرم.
لم تكن تضحية بحفيد فحسب، ولم تكن تضحية بشريف النسب فحسب، ولم تكن تضحية بقائدٍ مصلح فحسب، بل كانت تضحية بأفضل وأعظم نتاج للنبوات والرسالات. تضحية بالإنسان الكامل الذي بلغ أعلى مراتب العلم. وهل يُعرف الكمال إلا بالعلم؟ أو قل: هل يتحقّق أي كمال دون العلم؟!
فإذا أردنا أن نندب حسينًا إحياءً منّا لنهجه العاشورائي، ينبغي أن نبكي على العلم الذي ضاع في كربلاء، وضاعت من بعده الأمة وفقدت قوتها الأولى.
إنّ عجز معسكر الحسين(ع) عن التشكُّل حيث تستدعي الحاجة يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم معرفة حقيقة الجريمة التي ارتُكبت في كربلاء ومَن المقتول وما المقتول فيها. ولا شك بأنّ معرفة ما ضاع من علم وما فُقد، يتطلب معرفةً جيدة بهذا الدين في أهدافه ودعوته. صحيح أنّ المواجهة في كربلاء كانت قيامًا ضد النظام الحاكم وسعيًا لإقامة نظامٍ بديل، ولو بعد مئات السنين، وصحيح أنّ هذا النظام السياسي الذي قام من أجله هذا الإمام الشهيد هو الوسيلة الوحيدة لإقامة الدين؛ لكن لا يُقيم الدين إلا من يعرف هذا الدين والقرآن حقًّا، ويعلم طبيعة هذا المشروع الإلهي الذي يُفترض أن يؤدي إلى تغيير العالم وفتح أبواب السموات.
فكلما اقتربنا من معرفة الدين اقتربنا من معرفة طبيعة العلم الذي سُفك دمًا في كربلاء.
إن الذين تغلغلت معرفة الدين ومشروعه في أعماقهم وأدركوا بعض حقائقه هم الأكثر تفجُّعًا على مُصاب الحسين(ع). هؤلاء هم الوحيدون القادرون على الربط بين فاجعة كربلاء وكل الفجائع التي نزلت بالمسلمين منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا.
فاجعه كربلاء هي بداية كل الفجائع، بل هي علّة جميع الفجائع، لأنّ قتل العلم كان يعني قتل كل خير يُمكن أن يصل إلى البشرية.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
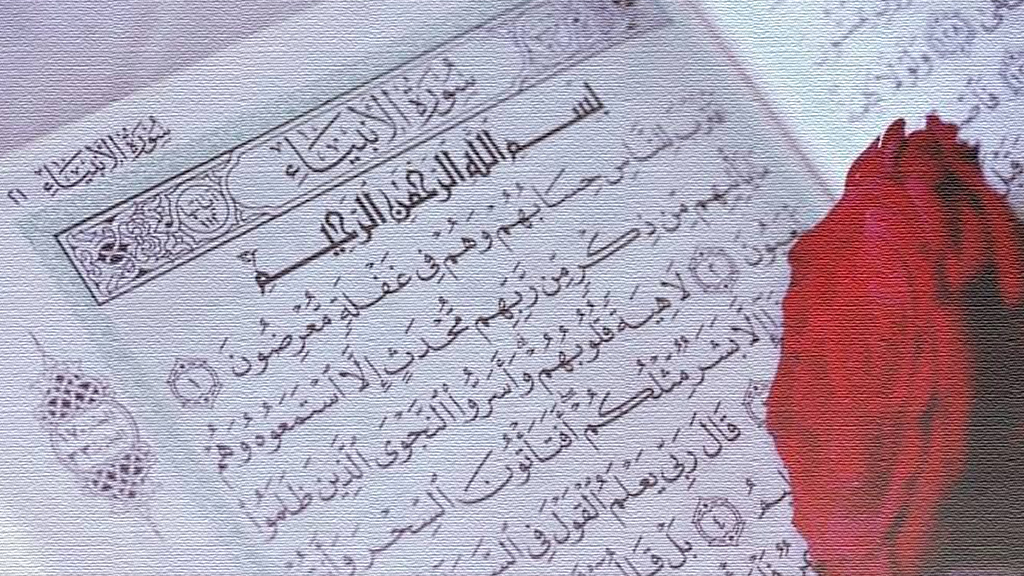
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










