مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.انتظار المخلّص بين الحقيقة والخرافة

انتظار المخلّص بين الحقيقة والخرافة، كيف تنحرف المذاهب لعدم فهم هذه القضية؟
إنّ قضية حضور الله في حياة البشر وتدبيره لهذا العالم كانت وستبقى النقطة المركزية في مسألة الإيمان. وقد واجه مدّعو الإيمان من أتباع الأديان والمذاهب المختلفة هذا التحدّي والاختبار على مدى العصور والأزمان، كلٌّ على طريقته. وكان على الجميع أن يقدّموا إجابات واضحة للأتباع والمؤمنين حول كيفية هذا الحضور بما يتلاءم مع الإيمان ويقوّيه.
حين نتأمّل في جميع مظاهر إيمان البشر بوجود الله وحضوره وتدبيره وتعامله مع خلقه، تطلّ قضية إدارة الحياة الاجتماعية، وحوادثها الكبرى والشديدة التأثير، برأسها لتقف في صدارة قضاياهم كلّها. وما لم تتمكّن أي جماعة أو مذهب من تقديم تفسيرٍ شافٍ ووافٍ لهذه القضية على ضوء ذلك الإيمان، فمن الصعب أن يتمكّن إيمان الأتباع من الثبات والصمود بوجه أعاصير اختباراتها وابتلاءاتها.
مرّ اليهود بهذه المحنة على مدى تاريخهم، بدءًا من هلاك يوسف النبيّ (عليه السلام) حيث قالوا لن يبعث الله رسولًا، ومرورًا بالتيه الذي طال أربعين سنة في الصحراء، وصولًا إلى ما بعد سليمان والانتظار الطويل لظهور المسيح المخلّص، الذي يُفترض أن يعيد لهم ذلك المجد التليد.
لقد تعامل اليهود، بحسب ما قرأنا من تاريخهم، مع قضية المخلّص وحصروها في إطارٍ قومي ضيّق. فكان المخلّص في عقائدهم عبارة عن ذلك الشخص الذي يُفترض أن يأتي لينقذهم، لأنّهم شعب الله المختار الذي يجب أن يسود العالم ويستعبد الآخرين. ولهذا، لم يتمكّنوا من تحمّل المسيح المخلّص حين جاءهم بعد كل تلك القرون، لأنّه ساوى بينهم وبين غيرهم؛ فنبذوه وطردوه وحاربوه إلّا قليلًا منهم. وها هم إلى يومنا هذا يتفاخرون بأنّهم قتلوه وصلبوه.
وحين نشأت المسيحية وتحوّلت إلى دينٍ رسميّ للإمبراطورية الرومانية، كان عليها أن تفسّر غياب هذه الرحمة الواسعة، التي تجلّت بنزول الفادي الذي ضحّى بنفسه من أجل الخطّائين قبل أكثر من مئتي سنة. فالخطّاؤون قد كثروا، وليس هناك من يضحّي بنفسه لأجلهم ويقلّل من خطاياهم؛ فصار الصَّلبُ صَلبَ العقيدة المنجية. وإذا كثر المؤمنون بتلك الحادثة التاريخية، يمكن للمسيح أن يعود ليملأ الأرض بركة ويبني ملكوت الله على الأرض. ولأنّ مثل هذه الفكرة كعقيدة قد تبدو بعيدة جدًّا عن واقع الحياة بالنسبة للكثيرين، فإنّ الخطّائين كثروا وارتكبوا أفظع الجرائم بحقّ غيرهم وبحقّ بعضهم؛ فما العمل لتفادي محنة الإيمان وشعور المؤمنين ببعد الله عنهم؟ وكيف يمكن تفسير فظائع حربين عالميتين أبادتا عشرات ملايين المسيحيين وغيرهم على أيدي مسيحيين مؤمنين بالصليب؟
لم تنجح فكرة المخلّص الذي يعيش يراقب من السماء في تقليل خطايا العصاة المؤمنين، رغم كل الحديث عن عودة الفادي ونزوله مجدّدًا من السماء في يوم آت قريب أو بعيد.. وكان على اللاهوت المسيحي أن يعمل جاهدًا من أجل معالجة مثل هذه الظاهرة التي تفتك بالمجتمعات المسيحية وتزيد من آلامها بصورة غير مسبوقة.
فإذا كانت الخطيئة هي أكبر مشاكل الإنسان وفق الرؤية المسيحية، فإنّ عدم النجاح في التخفيف منها على ضوء ذلك الإيمان، سيشكّل تحدّيًا حقيقيًّا للإيمان نفسه. وإذا كان لفكرة نزول الرب وتجسّده في إنسانٍ، مواساة للإنسان المستغرق بذنوبه وأدناسه وعونًا له لكي يقلع عن معاصيه، فمن الطبيعي أن يكثر السؤال عن تأخّر نزوله مرّة أخرى لإنقاذنا نحن الخطّاؤون.
لا شك بأنّ التراث الكبير والواسع للّاهوت المسيحي يحفل بالكثير من الكلام حول هذه القضية الحسّاسة. ولا ينبغي أن نتسرّع في تقييم مدى نجاحه على مستوى أتباعه والمؤمنين به. ويجب في مثل هذا الشأن تثبيت أصول علمية بحثية دقيقة.. وغاية ما نودّ الإشارة إليه هنا هو أنّ العالم المسيحيّ كان ولا يزال يعيش معاناةً كبرى ترتبط بموضوع تثبيت حضور الله في حياة المؤمنين وتفسير كيفية تدخّله في حياتهم.
أمّا أتباع الإسلام، الذي جاء به محمّد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله)، فقد انقسموا إلى عدّة مذاهب بخصوص هذه القضية بالذات. ولا نقصد هنا المذاهب الفقهية الشهيرة كالجعفرية والمالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، لأنّ نشوء الفوارق الفقهية وحدوث الاختلاف في فتاوى الأحكام الفرعية لم يكن وليد التفاعل حول القضية وكيفية تفسيرها. وإنّما تولّت الإجابة عن هذا السؤال، والتحقيق بشأن الإيمان، مذاهب عقائدية تأثّرت بالمناهج الكلامية والفلسفية وغيرها.
وبلحاظ العدد والنسبة، يبدو أنّ فئة واسعة من المسلمين اليوم تميل إلى اعتبار كل حاكم جاء بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مظهرًا لرحمة الله وعنايته بعباده، بغضّ النظر عن صفاته وأفعاله، حتى لو كانت إجرامية وسيئة ومخالفة لأبده ضرورات الدين. وهذا ما كان يتجلّى إلى اليوم عبر تعظيم حكّام المسلمين وتقديسهم، بالنظر إلى أدوارهم المرتبطة بالدفاع عن الدين ونشره في بلاد العالم.
إنّ التفكيك بين صفات الحاكم وخصائصه الشخصية، وبين دوره وإنجازاته، هو أمرٌ قديم وشائع وسط هذه الفئة، التي ما فتئت تبرّر كل ما قام به الحكّام على مدى التاريخ، وتعمل جاهدةً على صبغه بلون القداسة والتأييد الإلهي؛ وأغلب الظن أنّ هذا ما كان ليحصل لولا حراجة القضية التي أشرنا إليها على صعيد الإيمان. فإنّ تولّي منصب رسول الله (ص) من قبل من لا خلاق له ولا قيمة عند الله وعند الرسول، سيطرح سؤالًا كبيرًا حول مدى عناية الله ورحمته بالأمّة التي يُفترض أنّها خير الأمم؛ فما الذي سيبقى من الإسلام في نظر هؤلاء، إن كان من يتحكّم به فاقدًا لكل مظاهر الشرعية والرضا الإلهيين!
ويبدو بحسب مطالعة التاريخ والحاضر أنّ هذه الشريحة الواسعة من المسلمين ما زالت على نظرتها وعقيدتها بشأن قضية حضور الله تعالى في صلب القضية الاجتماعية الأولى (الحكم والسياسة والأحداث الكبرى). ولهذا، رأيناها تجعل ديانتها تابعة للحكّام وتبني أصولها على ضوء عقائدهم. وسرعان ما يتحوّل هؤلاء الحكّام أنفسهم إلى سلطة عليا يحقّ لها إخضاع المفتين والفقهاء وتوجيه فتاواهم. أمّا هؤلاء الفقهاء وأصحاب الفتاوى السلطانية، فعليهم أن يبحثوا عن المبرّرات الفقهية اللازمة لسد الذرائع في كل موقف يصدره السلطان نفسه.
إنّ هذه العقيدة ليست سوى تطويع للإسلام ليتلاءم مع المصالح السياسية الخاصّة؛ وبتبع ذلك سيكون هذا إخضاعًا للقضية الكبرى المرتبطة بحضور الله؛ فتصبح عندها مشيئة الله هي مشيئة السلطان نفسه، وتختفي الحدود الفاصلة بين الحسن والقبح، ولا يعرف الناس بعدها من الحُسن إلا ما يتماشى مع إرادة السلطان، ولا من القُبح إلا ما يختلف معه. وهذا ما يفسّر لنا التأييد العجيب بين عامّة أتباع هذه الطائفة لسلاطين وحكّام ورؤساء ارتكبوا أفظع الجرائم بحقّ المسلمين.
إنّ تطويع الدين لإرادة السلطان لم يكن بالأمر البسيط والسهل؛ فقد جرى على مدى عصور وسنين من مراكمة القضايا العقائدية والمسائل الفقهية. ولم يكن القول بالحسن والقبح الشرعيين مقابل الحسن والقبح العقليين إلا نموذجًا من هذه العقائد والآراء؛ وهذا ما حصل أيضًا على مستوى قضية خطيرة كالعدل الإلهي والاختيار الإنساني. وقد سمعنا جميعًا كيف أنّ معاوية بن أبي سفيان كان يروّج لشرعية حكمه بأنّه أمرٌ شاءه الله تعالى، ولو لم يكن شرعيًّا لما شاءه تعالى؛ فلا خيار للمسلمين سوى أن يقبلوا به ويذعنوا له.
لقد كانت قضيّة حضور الله وتفسيراتها الإيمانية عند هذه الشريحة الواسعة عملية صعبة ومكلفة، لأنّها دفعت ثمنها من إنسانيتها وفطرتها وأصالتها؛ فخسرت بسبب هذا التشويه والتحريف أهم ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة ليكون إنسانًا مستقيمًا سعيدًا مهتديًا. وبدل أن ترى الحسن الإلهيّ في قلب هذا التحدّي، وتعلم بأنّ ما جرى ليس سوى مظهر غضب الله تعالى على قومٍ تركوا وصيّة نبيّهم الأكرم (صلى الله عليه وآله)، فإنّها لجأت إلى آلاف الحيل والتفسيرات الواهية لتطويع غضب الرب المتعال وإخفاء معالمه وتقديمه على أنّه لطف ورضوان وعناية وإحسان.
شريحة أخرى بحثت عن لطف الله هنا، فلم تجده إلا في الغد الآتي ولو بعد آلاف السنين؛ أعانها على ذلك تراثٌ كبير من الأحاديث المروية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، تذكر أنّه سيظهر في آخر الزمان رجلٌ من ذرية هذا النبيّ العظيم، يملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعدما مُلئت ظلمًا وجورًا. لكنّ التفسير الناقص والفاقد للأصول والمنهجية العلمية المناسبة لهذه الأحاديث من جهة، والتطبيق الاعتباطيّ للروايات على وقائع الزمان المختلفة والحسّاسة من جهة ثانية، أدّى إلى ضمور هذه العقيدة وانحسارها في أوساطها إلى الدرجة التي سمحت لعددٍ من رجال دينها بإنكارها رأسًا، رُغم وجود هذا الكم الهائل من الروايات المرتبطة بها والمنسوبة إلى النبيّ الأكرم في كتبها المعتمدة والمشهورة. فكيف إذا أضفنا رغبة سلطان العصر بإخفاء معالم القضية من الأساس، لتصبح عنوانًا يحرج الطائفة المسلمة الأخرى من أعدائه!؟
هذه الطائفة التي كان لها دورٌ مصيريّ في الصحوة الإسلامية الحالية وانبعاث الإسلام السياسيّ من جديد، هي التي استطاعت أن تتعامل مع قضية حضور الله تعالى في الحياة السياسية من زاوية العقل والاستدلال والبحث العلميّ الدقيق وتأسيس الكلام على أصول محكمة، فتجنّبت الكثير من هفوات التطبيق والتأويل وأخطاء التفسير وعشوائيته، ولم تسقط في حالة التسامح والتساهل بشأن أدلتها. أضف إلى ذلك عاملًا مهمًّا، وهو أمن هذه الطائفة من تأثير سلاطين الجور إلى حدٍّ كبير.
كنت أطالع في تاريخ العراق مؤخّرًا، ورأيت كيف عجز النظام البعثيّ عن استصدار فتوى واحدة من المراجع المقيمين في النجف الأشرف، تؤيّد قتاله للأكراد في السبعينات من القرن العشرين، وقمعهم وإخراجهم من ديارهم وبلادهم (علمًا أنّ الأكثريّة الساحقة من الأكراد لم تكن من المعتقدين والمقلّدين لهؤلاء المراجع). هذا، في الوقت الذي استطاع ذاك النظام أن يحصل على فتاوى مؤيّدة ومحلّلة لحربه تلك من مفتين وفقهاء يُفترض أنّ الأكراد ينتمون إليهم. وقد مارس هذا النظام البائد كل أشكال الضغط والتنكيل والمحاصرة والقمع والأذية بحقّ المراجع المحترمين القاطنين في النجف، رغم وجود اختلافات واضحة فيما بينهم على صعيد الرؤية المرتبطة بالعمل السياسيّ والنشاط الاجتماعيّ.. لم يكن هذا التوفيق سوى حصيلة قرون من صيانة الذات من التبعية لسلاطين الظلم؛ الأمر الذي عُدّ سمة بارزة لمسيرة علماء هذه الطائفة.
ثلاثة عوامل أساسية حفظت الكثير من التراث المرتبط بتفسير كيفية حضور الله في الشأن الاجتماعيّ السياسيّ للبشر؛ وهذه العوامل هي:
التعامل الاستدلاليّ العقليّ المتين معها.
تثبيت مجموعة من الأصول العلمية الدقيقة في التعامل مع الأحاديث والروايات.
نقاء تجربة قراءة الدين وتفسيره من التبعية لإرادة السلاطين.
وهكذا برز تراث مهم مناسب لتفسير معنى حضور الله في هذه القضية، وهو أنّه لا بدّ من وجود شخص معصوم طاهر أفضل، يمثّل حجّة الله على العباد وهدايته، حتى لو كان غائبًا عن الأنظار ومستورًا. وقد أفضت الدراسات المتراكمة، التي فسّرت حكمة غيابه عن الأنظار وصعوبة الاتّصال المباشر به، إلى تقديم أجوبة رائعة لا تزيد المؤمنين إلا إيمانًا. وهكذا أصبح هذا المبدأ الأصيل عاملًا منتجًا لإيمانٍ لم تعرف له البشرية مثيلًا؛ فقد اكتمل عندها عقل من يقدر على ملاحظة حضور الله تعالى في غيبة خليفته الكامل الصفات والأخلاق الذي يمثّل رحمته الواسعة بعباده ويكون مظهر لطفه وإحسانه. وبدل أن تتحوّل هذه المصيبة الكبرى إلى عامل لضعف الإيمان وانحلاله وسببًا لتوهين المذهب وتحقيره، صارت سببًا لارتقاء الفهم والرؤية المرتبطة بالحياة البشرية والتاريخ عند أتباعه من أهل البصيرة والوعي..
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
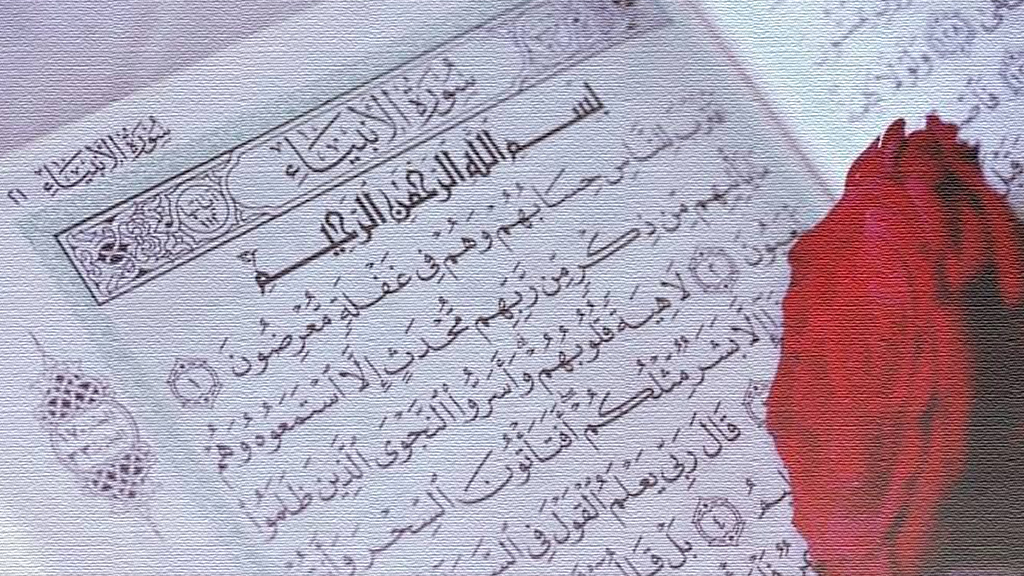
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










